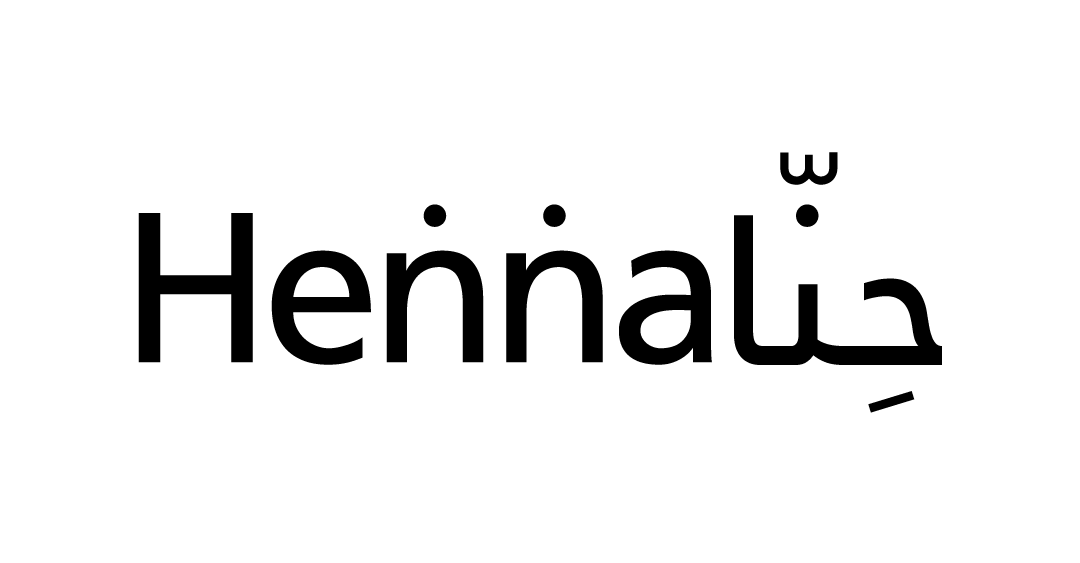كيف سنتخلص من البعبع؟
حسين الشهابي
حسين الشهابي ناشط في مجالي الصحة النفسية و التعليم ونقاط التقاطع بينهما. فلسطيني سوري مقيم في تورونتو درس علم الأعصاب في جامعة غويلف وحالياً يكمل الماجستير في علم النفس التنموي وتعليم الطفل في جامعة تورنتو
كانت ليلةً صيفيةً دافئةً ساد فيها شيء من الصفاء، ذهبت فيها لحضور عرض موسيقي في كنسينغتون مع مجموعة من الأصدقاء. حين خرجنا لتدخين سيجارة في على الرصيف المقابل للبار، عبر أحدهما عن مدى سروره لرؤية عدد كبير من الأصدقاء، قائلاً إن الجميع يبدون مرحين وسعداء. في مرحلة ما من المحادثة، كنا نقارن الفرح اللحظي في تلك الليلة بصراعات الحياة اليومية. أضاف الصديق نفسه أن جزءاً كبيراً من هذه النضالات، وخاصة في دوائرنا الاجتماعية، هو تعلم العيش في تحديات الصحة النفسية والصدمات. رد صديقي الآخر مستفهماً “عن أي صدمة تتحدثون؟”، ثم سارع إلى تحذيرنا من المغالاة الضارة في استخدام هذه المفاهيم والحديث عن الصدمة النفسية. ادّعى الصديق أن صحته النفسية سليمة تماماً، كدليل على صحة نظريته، وأنهى بذلك الحديث الذي بدأ لتوّه.
أثار هذا المشهد العديد من الأسئلة لديّ. فلماذا كل هذا النفور الواضح من قبل صديقي؟ لا بدّ أن الوصمة المتعلقة بالصحة النفسية هي السبب الرئيسي الذي دفعه لذلك الرد الحاد. يبدو هذا الرد نموذجياً في مجتمعاتنا الناطقة بالعربية، وأرى أنه من الضروري التوقف لحظةً لمحاولة فهم الآلية التي تعمل بها وصمة الصحة النفسية على المستويين الفردي والجمعي.
قبل أن نتسرع في إدانة الوصمة الاجتماعية للصحة النفسية في المجتمعات الناطقة العربية، من الأفضل أن نحاول وضعها في سياقها التاريخي في محاولة للتعمق في جذور المشكلة. يمتلك السياق التاريخي الثقافي وزناً مشابهاً للسياق التاريخي العلمي فيما يتعلق بوصمة الصحة النفسية. يمكننا أيضاً مناقشة هذين السياقين من نافذة اللغة المُستخدمة في تطور الصحة النفسية. من المعروف أن عبارة “الصحة النفسية” في اللغة العربية هي ترجمة من اللغة الإنجليزية، أي اللغة الأصلية التي تطورت بها. لا بد أن نأخذ في عين الاعتبار تاريخ الصحة النفسية في الغرب، وتطوره في القرن العشرين. وسنحاول تسليط الضوء على دور كندا الفاعل في العملية.
قبل أن يسود استخدام عبارة “الصحة النفسية”، كان شائعاً استخدام عبارة “النظافة أو الطهارة العقلية” وكان لها دلالات سلبية تعكس الوعي العام بالصحة النفسية قبل الحرب العالمية الثانية. ذهب مفهوم “النظافة العقلية” بعيداً بالعزل المؤسساتي المنظم لذوي الأمراض النفسية. وقد عملت الكثير من المؤسسات المختصة، والتي كانت تشبه السجون في غالبها، بعلاج تجريبي مدفوع بالعدمية حول كل ما يتعلق بمشاكل الصحة النفسية والعصبية. في كندا، تقاطعت هذه العزلة المؤسسية أيضاً مع حركة تحسين النسل التي بدأت في الظهور في أوائل القرن العشرين، إذ بدأت عملية “تعقيم” الأشخاص المصابين بمرض عقلي في جميع أنحاء البلاد. فيما بعد، أدت تداعيات الحرب العالمية الثانية إلى تغيير جوهري في الوعي العام الغربي تجاه الصحة النفسية. ارتبط التغيير الجذري تحديداً في مقاربة قضايا الصحة النفسية بصدمات المحاربين القدامى. أثارت صدمات المحاربين القدامى تحديات عامة على صعيد الوعي الجمعي الثقافي والعلمي لمفاهيم الصحة النفسية. تزامنت عودتهم مع تطور الطب النفسي وأدت إلى تغيير في علاج أعراض الصدمة: من وصف الراحة فقط، إلى العلاج الطبي الذي يشمل وصف الأدوية وإعداد الخطط العلاجية.
شكل ذلك بداية نقلة نوعية في الوعي العام في الغرب تجاه الصحة النفسية، حيث بدأت النظرة الثنائية (القائمة منذ زمن طويل، والتي تفترض أن الإنسان إما “عاقل” او “مجنون”) بالتغير. شكلت عودة الجنود من الحرب تحدياً للنموذج الطبي القائم تجاه الصحة النفسية، والذي رسم خطاً قاسماً للمجتمع بين من تم تصنيفهم كـ”مجانين” من جهة، والـ”عقلاء” من جهة أخرى. كان من الصعب عزل هؤلاء الجنود أو تجاهل معاناتهم النفسية بسبب قيمتهم في المجتمع.
تابعت المفردات واللغة المستخدمة في مجال الصحة النفسية بالتطور بعد ذلك، تزامناً مع تطور المجال النفسي بشكل عام، وما زالت حتى يومنا هذا في عملية تطور مستمر. مثال على ذلك ما نشرته المنظمة الكندية للصحة النفسية حول أهمية اللغة بأمثلة واضحة تثبت التغيير في الفكر العام الذي تحدده المفردات. واليوم، أصبح الحديث عن مجال الصحة النفسية في المشهد الكندي أكثر دقة بمراحل منه في القرن العشرين في المجالين العام والخاص. على الرغم من ذلك، ما تزال وصمة العار موجودة، والدليل على ذلك هو وجود برامج حكومية وخاصة شأنها إزالة الوصمة الاجتماعية المتعلقة بالصحة النفسية في المجتمع كبرنامج شركة بيل “ليتس توك“، وبرنامج “رايد دون هايد” لمنظمة الصحة الكندية.
تواجه تطورات الصحة النفسية عائقاً لغوياً جديداً، وهو عدم سداد المقارنة بين مفهومي الصحة النفسية والاضطراب النفسي، لأنهما ليسا مفهومين مُنفصلين. إذ يُعد مفهوم الصحة النفسية طيفاً متعدد الأوجه والأبعاد، ويشمل حالات “السلامة” و”المرض” في الوقت ذاته. وعلى ذلك فإن صحة الفرد النفسية قد تتأرجح على ذلك الطيف خلال يومه/ا، أسبوعه/ا، أو حياته/ا كلها. يمكن فهم مفهوم الصحة النفسية بطريقة أدق إذا ما قورن مع مفهوم الصحة الجسدية الفيزيائية. في تشبيه بين مرض السكري واضطراب القلق، يمكن لأي شخص أن يتعرض للإصابة بكلا المرضين في أي مرحلة عمرية من حياته/ا. ويمكن تحديد شدة وشكل المرض وفقاً للعوامل البيئية المحيطة والعوامل الجينية الوراثية. من الممكن جداً أن يتم تشخيص المرء بمرض السكري أو الاستعداد له، تماماً كما يتم تشخيص اضطراب القلق أو الاستعداد لتطويره. وكما يعالج السكري إما بوصف الدواء، أو تغيير طريقة الحياة، أو كلاهما، فإن القلق يعالج بالطريقة ذاتها.
هل يعقل أن صديقي كان سيبدي ردة فعل مختلفة لو اختلفت اللغة المستخدمة في الحديث؟ ربما لو كان هناك لغة أصلية أفضل تناسب خلفيتنا الثقافية لاستمر الحوار في هذا الموضوع لوقت أطول.
تكمن أهمية الخلفية الثقافية في هـذا السياق في أن الحديث عن شؤون الصحة النفسية لم يبدأ إلا مؤخراً في العالم العربي. المشكلة أن هذه البداية تُعتبر استيرداً من المنظومة العلمية الغربية، أو من التأثير الغربي في العالم العربي. لذلك، تبدو مفاهيم الصحة النفسية باللغة العربية انعكاساً للمفاهيم الغربية. فاللغة التي نستخدمها إذن هي أفضل محاولاتنا لترجمة المفردات المطورة في الغرب. تشهد المجتمعات الناطقة بالعربية إذن مشكلتين حول اللغة المستخدمة في الصحة النفسية، أولاهما أننا نستعمل لغة تطورت خلال مئة عام في سياق ثقافي وعملي آخر، والثانية هي أن هذه اللغة ما زالت تستخدم ثنائية “السليم” و”المريض” التي تعزز الوصمة.
يشبه استخدامنا اللغوي المترجم لمصطلحات الغرب محاولة لوضع مجسم مكعب في حفرة مدورة، وبالطبع فإن هذا المكعب لا يلائم الحفرة التي نحاول وضعه فيها عنوة. للسبب نفسه ربما كان رد صديقي الحاد على تلك المحادثة عن الصدمة محقاً. فاللغة المستخدمة في الحديث كانت خارج منظومته الثقافية تماماً، مما أودى به مباشرة إلى التفكير بالثنائية المذكورة أعلاه: السلامة والمرض.
في البحث عن أجوبة فيما يخص اللغة المستخدمة. من الجيد أن نتوجه إلى مرحلة ما قبل الاستعمار الغربي، وأن نطرح السؤال : “ألم يكن هناك لغة متعلقة بالصحة النفسية في العوالم الناطقة بالعربية؟”. لا بدّ من وجود حديث حول ذلك بشكل أو بآخر، فماذا كانت تسمى الصحة النفسية يا ترى؟ هل يمكن البدء من هناك لإيجاد مصطلحات لغوية وثقافية تناسب التطور الحاصل في مفاهيم الصحة النفسية في يومنا هذا؟
من الضروري التأكيد هنا أن هذه ليست دعوة للانعزال عن باقي اللغات أو المفاهيم اللغوية القادمة من الغرب. تعدّ الاشتباكات الثقافية أمراً طبيعياً جداً، ولا أتصور أن إيجاد لغة تدمج المعارف الموجودة في العالم العربي ستكون أمراً مستحيلاً، إنما يتطلب جهداً ويأخذ كثيراً من الوقت. هناك الكثير من الأمثلة في كندا، فالشعوب الأصلية عملت على إيجاد لغة ثقافية تدمج بين علومها الأصلية والعلوم الغربية. تدل كلمة “Etuaptmumk” في لغة شعوب ميكماو الأصلية، على “الرؤية بعينين اثنتين” ويعني ذلك القوة الناتجة عن رؤية العالم من منظور الشعوب الأصلية والمنظور الغربي في الوقت ذاته.
أتاح هوس التصنيف في العلوم الغربية، واللغة الإنجليزية تحديداً، كثيراً من الفهم في موضوع الصحة النفسية للعالم. نأمل إذن أن نبدأ كناطقين بالعربية في مجتمعنا برحلة التعرف على نقاط قوتنا وضعفنا في هذا المجال، لنصل إلى استخلاص المناسب من المعرفة في الغرب، ودمجه مع ثقافتنا ولغتنا. حينها فقط، قد يذهب الحديث مع صديقي ومع غيره إلى مكان أعمق في ليلة صيفية أخرى.