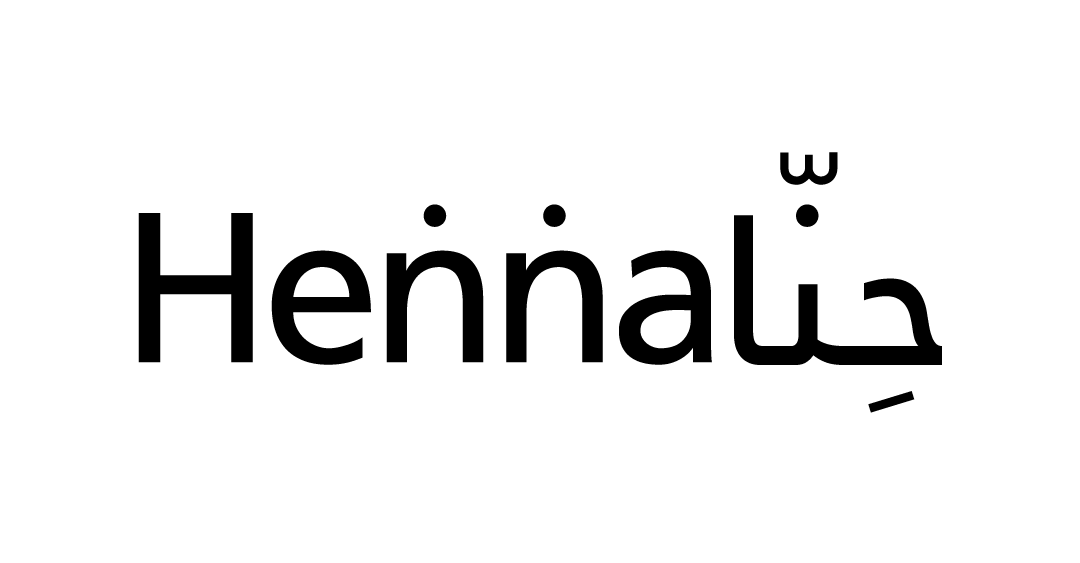عن توأمة النجاة والهزيمة
كيف يمكن مقاربة النجاة حين تترافق مع الهزيمة؟
هذا النص هو جزء من سلسلة مقالات ضمن مشروع مفازة الذي يحاكي موضوعة النجاة عبر الشعر والموسيقى. تم إنجاز مرحلة البحث والإنتاج لهذا المشروع بدعم من مجلس كندا للفنون. تقرأون في هذه السلسلة أيضاً: النجاة بالنغم لعبد الوهاب الكيالي، والالتفات إلى مواضع التصدع لمصعب النميري.
وائل سعد الدين
شاعر سوري مقيم في كندا، صدر له ديوان “المخامر الأخير” عام 2010.
“قَلَّمَا ينجُو امرءٌ منْ فتْنَة/ عَجَباً مِمَّن نجَا كَيفَ نَجَا”، أبو العتاهية
للنجاة مستويات متعددة تدور حول مفهوم الخلاص. ترد إحدى معانيها في العربية على أنها ما ارتفع من الأرض فلم يعْلُه السّيل، والسيل هنا هو الخطر الداهم. في المفهوم الديني تعني الخلاص مع طلب الالتزام في الإسلام، وحفظ الإنسان من الخطيئة وعواقبها في المسيحية. هي الهروب في الفلسفة، رغم أن إحدى مهماتها هي “تغيير العالم” على ما قاله ماركس. تحيل أيضاً إلى عقدة الناجي ومحاولة التأقلم في تشخيص الملاحظات والدراسات النفسية.
أسألُ هنا: هل يمكن للنجاة والهزيمة أن تكونا مترافقتين؟ النجاة نجاح في آخر الأمر، والهزيمة فشل مركّب. وإذا كان الناجي قد هزم في معركته أصلاً؛ فهل يكون قد هُزم مع تحقيق انتصار بسيط بسبب بقائه على قيد الحياة، مع ما يمنحه ذلك من فرصة جديدة في الاستمرار؟ وكيف إذا كان الناجي مهزوماً في حلمه وأمله ووطنه وشعبه؟ هل يمكن تعريف النجاة مع الأخذ بعين الاعتبار حالة تراجيدية من الحروب والمجازر والصراعات الداخلية والخارجية كالحالة السورية؟ هل يمكن التعامل مع الإحباط واليأس والضعف النفسي؟ هل ثمة إمكانية للتأقلم مع الحياة الجديدة، والحفاظ على الهوية المُفترضة والقيم والمبادئ؟
“الحرية سفر دائم نحو المجهول”، عبد الرحمن منيف
بدأت الثورة السوريّة مفتونةً بالربيع العربيّ، وحلّ ما حلّ بها وبه. تسارعت عدّادات الأيام والضحايا والأشهر والأحداث والسنوات والتنظيمات والمذابح والخسارات، وانتهت إلى ذكريات حزينة، وأمل ضائع، وأزمة إنسانية طالت ملايين البشر ووضعت 90% ممن بقي منهم داخل الأسوار العالية تحت خط الفقر. هربتُ من المقتلة إلى تركيا في منتصف عام سقوط حلب بيد النظام، أيام الانقلاب الصيفي في رحلة استمرت سبعة عشر يوماً من دمشق إلى غازي عنتاب. كنت أشعر حينها أنني مثقل بفكرة الهروب، وأنا الذي قرّعت كثيراً من أصدقائي وصديقاتي على تركهم وتركهنّ لحظة الاستثناء تلك التي كنا نعيشها حتى عام 2013، الذي اعتقلت في ربيعه. لقد كان الأمل بإسقاط النظام كبيراً في بداية ذلك العام رغم الأثمان الفادحة التي دُفعت، ورغم أخطاء الثورة وخطاياها، مع إمكانية البناء على ما تهشّم، وترميم ما أمكن، ولكن كان ما كان.
خرجت من السجن في ربيع عام 2016. كانت أولى خطواتي الثابتة نحو الهزيمة هي الهروب من المكان. لم يعد بعيداً عن فهمي -مثل كثير من الناس- أن هذا الوحش جعل المكان غريباً. لم يكن من الحكمة تحدّيه على الإطلاق، ولا بدّ من الانصياع لقواعد اللعبة المؤلمة، والالتزام بأخلاقيات النجاة، وتطويع النفس والذات على فكرة الهروب استعداداً لخوض غمار الخطوة التالية.
الوصول إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام كان فرحاً منقوصاً. تخلّصت من قبضة الطاغية أخيراً، ووصلت إلى جزء من سوريا لا يحكمه بشار الأسد. هذا شيء كبير لا يمكن وصفه في عُجالة. خسرتُ كما غيري كثيراً من الأقارب والأصدقاء -وكدت أن أكون واحداً منهم- في سبيل تحقيق هذا الحلم. غير أني لم أشاهد العلم الذي صرنا نكفّن فيه شهداءنا بعد أشهر قليلة من آذار الـ2011 سوى مرتين خلال ستة عشر يوماً. فمن قلعة المضيق في ريف حماه، مروراً بعشرات القرى والبلدات، حتى الوصول إلى الأسوار التي تفصل بلدة حارم في ريف إدلب عن أرض الله الواسعة، نصف الرايات المرفوعة على الحواجز العسكرية والأبنية كانت بيضاء، ونصفها الآخر سوداء، تتقاسمها حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة. عدا عن أنّ تنظيم الدولة كان يسيطر على أكثر من 40% من مساحة سوريا في تلك الأيام، من صحرائها إلى شرقها وجزيرتها. إحدى هاتين المرتين اللتين شاهدت فيهما علم النجمات الثلاث كانت في بيت صديق لي في بلدة الأتارب في ريف مدينة حلب بقصد التقاط صورة للذكرى. أردت الخروج من هذا المأزق بأية طريقة ممكنة، فلا قدرة لي على مواجهة الأخوة ولا حتى الأعداء. لم يعد ثمة قانون ينظّم العلاقة المضطربة بين الحلم والواقع، بين الأمل والتجربة، بين الحريّة وانفلات الأمن، وبين لعنة الأرض ولعنة السماء، فالقصف لا يتوقف أيضاً. قفزت عن السور مرّتين وفشلت. عبرت في الثالثة بعد مساعدة من أحد أصدقاء السجن الذين سبقوني إلى الحريّة، ونجحت. قلت في نفسي بعد أن ابتعدت أمتاراً عن الحدود واستقلّيتُ السيارة التي ستأخذني إلى وجهتي الجديدة: وداعاً أيتها البلاد، وداعاً يا حبيبة القلب، يا ظالمة.
“ولَيْسَ غريباً مَن تَناءتْ ديارُهُ، ولكنَّ مَنْ وارى التُّراب غَريبُ”، امرؤ القيس
للمدن التركية الجنوبية ألفة من نوع خاص، تحمل من التاريخ ما تحمل، يعرِفها السوريون الذين مرّوا بها جيداً. إلا أنّها أصبحت ثقيلة على العالقين فيها نتيجة تزايد موجات العنصرية بحق اللاجئين في عموم تركيا إلى الحد الذي أصبح فيه موضوع ترحيلهم برنامجاً انتخابياً.
ليست الغربة مكتملة النصاب في غازي عنتاب، حتى الخوف من الشرطة والحواجز العسكرية التركية كان ملازماً. أهاتف أبي وأمّي في الشام، وأقول في نفسي إنّ المسافة بيننا في الأحوال العادية خمس ساعات بالسيارة فقط. محاطاً بالسوريين من كل جانب، أسمع قصصهم عن الثورة في جزئها الشمالي “حلب” وجامعتها وريفها وثوّارها بشغف وحزن بالغين. هناك، تعرفت إلى الحلبيين. لم أصادفهم في دمشق قبل الثورة، فهم لا يحتاجون إليها، لديهم مدينتهم الكبيرة وقلعتها واقتصادها، وأغانيها الفادحة أيضاً. عملتُ مع مجموعة منهم في منظمة غير ربحية تعنى بتعليم الطلاب المتسربين من المرحلة الابتدائية في حلب الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام. سقطت حلب. نعم بكل بساطة وذهول سقطت حلب، وتركت العمل في المنظمة إثر خلاف إداري على حجم العمل المُنجَز خلال ساعات العمل. توجّب أن أعمل أكثر، غير أنّي لم أعد أطيق العمل. أشاهدهم يتفانون ويحرقون أعصابهم في سبيل تأمين أي مأوى من أي نوع للمهجرين من المدينة، وأنا تأكلني الحسرة، وتسحقني اللاجدوى. لم أسِرّ لأحدهم بما أشعر. أغلقت الحاسب المحمول. سلمته لأحدهم خارج مكتب المنظمة، ومضيت. عرفت حقيقة أنّ كلامي صار أقلّ، ولكنني صرت أكثر إدراكاً للهزيمة.
“وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ”، آية قرآنية
وصلتُ إلى كندا في شهر تشرين الثاني من العام 2017. نمتُ في أوّل يوم كما لم أنم من قبلُ في حياتي. أسفتُ على كل من لم يجرب طعم النوم هذا. وفّر لي فارق التوقيت بين كندا وسوريا أقل قدر من التواصل مع الناس. عائلتي الصغيرة، وقليل من الأصدقاء يمكن عدّهم على أصابع اليد الواحدة. عملٌ عادي، في مدينة صغيرة. ممارسةٌ لعقدة الناجي بنجاح منقطع النظير. سجنٌ يلازم عزلتي، أقارنه بكل شيء، يعيش معي كحصوة تحت اللسان، يزيد من عجزه عن الكلام وهو الذي “أوردني الموارد” ،على ما قال الخليفة الراشدي أبو بكر الصدّيق. أمتنُّ لفكرة أنّ القانون هنا فوق الجميع. لا أخاف من الشرطة لأنني لستُ مذنباً. لا أجفل لرؤية سيارة عسكريّة رأيتها لمرة واحدة فقط خلال خمس سنوات ونصف عشتها هنا، غير أنني لستُ بخير. علم الثورة يعود تدريجياً إلى إدلب عبر مقاومة منقطعة النظير من بعض الطيبين العالقين خلف الأسوار، ولكن دون أي نتيجة تُذكر. عاد العلم أيضاً إلى مناطق في شمال محافظة حلب إنما بانتماء مختلف وتبعيّة ذليلة وعقيدة قتالية لا تقاتل جيش بشار الأسد. أقول لنفسي: لا بأس لقد هُزمت قبل كل هذا، ودفنتُ العلم مع الطيبين الذين ماتوا من أجل فكرتنا النبيلة وتغيير العالم الذي كنا نعيش فيه نحو الأفضل.
الهزيمة لا تحل بالناس هكذا دون توطئة ودون أسباب، بل لا بد من معطيات كافية تؤدي في النهاية إلى الفشل. ليس أوّلها الوحش الذي واجهناه، وليس آخرها مسألة الهويّة. علينا الاعتراف بالهزيمة أولاً، أما النجاة -كي تكون نجاة- فتتطلب العمل الدؤوب والمثابرة. ولكن أيضاً كيف سنتعامل نحن الذين “نجونا” كناجين مهزومين مع “ما لا يمكن الصفح عنه” على ما يقول جاك دريدا؟ ومع مأساوية ما وصلت إليه البلاد؟
أعيش الآن في تورونتو، أكبر مدينة كندية، محاطاً بالسوريين والسوريات أيضاً. أخطو خطوات بطيئة نحو “النجاة”، صلبة أحياناً وهشّة في أحايين كثيرة. أنظر إلى سوريا كل يوم عبر شاشة الحاسب المحمول، أعود إلى الكتابة بعد سنوات من الانقطاع واليأس، فقد تكون كتابة الماضي نوعاً من أنواع التعافي. لكن يداً واحدة لن ترسم ضوءاً في نهاية النفق. أرى أيادٍ كثيرة، ارفعوها، أرجوكم!