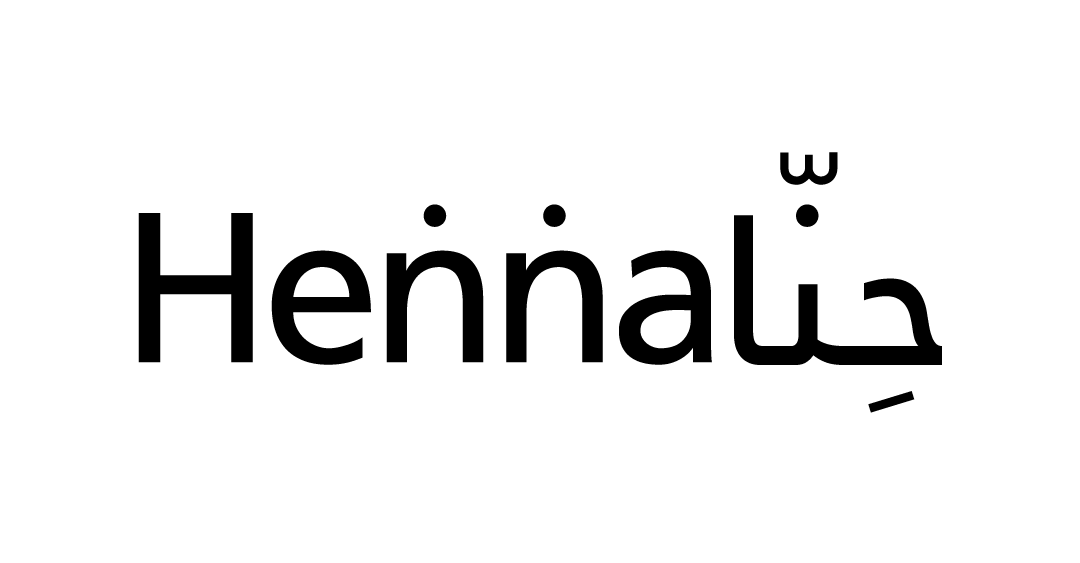المهاجرون في الدعاية الرسمية الكندية
سلام السعدي
كاتب وصحفي مقيم في كندا. يدرس حالياً الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة تورونتو.
سلط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتركز حالات الوفاة في صفوف مجتمعات المهاجرين وأصحاب البشرة الملونة في كندا، الضوء على موقع تلك الشريحة في أدنى سلم البنية الاقتصادية – الاجتماعية في هذا البلد، ما جعل أفرادها في مواجهة يومية وقاسية مع الوباء. وأظهر هذا الارتفاع في معدلات الإصابة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والصحي كمرآة لـ “التنوع” الإثني والثقافي الذي تحتفل به الرواية الرسمية ووسائل الإعلام الكندية.
يحضر التنوع الإثني بشكل إيجابي دوماً في الرواية المتداولة عن كندا، إذ لا يُنظر إلى تقاطعاته مع تفاوت مستويات الدخل وعدم المساواة وتوزع الفرص الاقتصادية بصورة عامة. لا يكاد يمر خطاب لجاستن ترودو من دون أن ترد فيه كليشة “قوتنا في تنوعنا“. يتم طرح هذا التنوع بشكل دعائي مبسّط باعتباره موزاييكاً وألواناً متعددة تزين الهوية الكندية من دون أن يكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية. بمجرد أن يحط لاجئ سوري قدمه على الأرض الكندية “يصبح مواطناً كندياً”، كما يقول ترودو. وعلى أرض المطار، ينصهر في هوية خيّرة مُتخيّلة يختفي فيها التنوع، ويختفي معه أي حديث عن التفاوت الاجتماعي والعرقي بين “القادمين الجدد” ونظرائهم الكنديين.
لا يقتصر هذا الخطاب على الرواية الرسمية، بل يشمل أيضاً أفراداً وجماعات من تلك الشريحة ذاتها، ومن ضمنها الجالية العربية في كندا. ينخرط أفراد الجالية العربية في الخطاب الرسمي المدائحي وفي ترويج صورة رومانسية متخيلة عن بلادهم الجديدة ورئيس وزرائهم الشاب. وقد تعززت هذه الصورة خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدا وكأنه النقيض التام لجاستن ترودو.
لا يخلو ذلك الاحتفال من الوجاهة تماماً. ففي نهاية المطاف، يأتي قسم كبير من المهاجرين من بلدان يسحقها الفقر والبطالة ويخنقها الاستبداد وتفتتها الانقسامات الأهلية والعرقية والطائفية. ولا شك في أن النظام الفيدرالي في كندا، القائم على الديمقراطية الليبرالية والذي يجمع بين الحقوق السياسية لكل من الأفراد والجماعات، هو تجربة سياسية تستحق الإشادة في جوانب عديدة.
لكن المشكلة هي في أن يهيمن هذا الوجه بالتحديد ويتحول في أذهان وروايات المهاجرين إلى “هوية” كندية جوهرية تُخفي جوانب أخرى. أحد هذه الجوانب ما ظهر خلال وباء كورونا من تفاوت اجتماعي وصحي، فضلاً عن سياسات كندا الخارجية فيما يخص بعض قضايا الشرق الأوسط والرقابة وتعتيم الحقائق التي يمارسها الإعلام الكندي.
يتجاهل الشغف بالرواية الرسمية أيضاً فصولاً مظلمة من تاريخ الدولة الكندية باعتبارها دولة قامت على الاستيطان الاستعماري ومارست التمييز المُمأسس قانونياً ضد السكان الأصليين. ليس هذا الفصل البائس تاريخاً سحيقاً لا يستحق الذكر كما يمكن أن يظن البعض. المدارس الداخلية التي كان يوضع فيها أبناء السكان الأصليين بعد انتزاعهم من أسرهم بالقوة من أجل “صهرهم” ضمن ثقافة كندية مسيحية بيضاء تم إغلاق آخرها في العام ١٩٩٦، أي ليس من وقت بعيد. كان ذلك جزءاً من عملية تطهير ثقافي وسياسي استهدفت وجود السكان الأصليين، فمارست الدولة ضدهم عمليات التهجير واستهدفت قادتهم ومنعتهم من ممارسة لغتهم وعاداتهم وشعائرهم.
لا يعني هذا أن لكندا هوية معاكسة “شريرة” نريد أن نكشف عنها في هذا المقال. وعلى مجتمع المهاجرين والجالية العربية بصورة خاصة التنبه إلى حقيقة أنه ليس لكندا هوية جوهرية واحدة، لا شريرة ولا خيّرة. لكندا هوية تتبدل بتبدل الفاعلين وتبدل الظروف السياسية والاقتصادية وعبر التفاعل مع الوضع العالمي. “الخير” الذي يبدو اليوم، والذي يُسعد الجالية العربية والمهاجرين، ليس جوهراً ثابتاً، وليس إرثاً ثابتاً لهذه الدولة. قد نفقده، نحن السكان الجدد، في أي وقت.
لا يتطلب إدراك هذه الحقيقة العودة إلى الماضي البعيد ولا حتى المتوسط. لم يمر وقت طويل على عهد رئيس الوزراء الكندي الأسبق ستيفن هاربر الذي سبق جاستن ترودو في الحكم. في تلك السنوات، ظهر النظام السياسي الكندي للمهاجرين، والمسلمين منهم بصورة خاصة، بصورة أكثر عدائية، أو على أقل تقدير أقل انفتاحاً وتسامحاً. لقد جرى وضع المهاجرين تحت المجهر السياسي والأمني، وبدا أنهم غير مهيئين تماماً لهذا القدر من الضغوط، خصوصاً بعد تنامي الهجمات الرسمية ضدهم والتشكيك بهم والتوجس منهم على المستوى المجتمعي.
وكي لا نعلَق كل الشرور على حزب المحافظين وعلى ستيفن هاربر شخصياً، من المفيد تذكر أن الحزب الليبرالي هو من طرح “قانون مكافحة الارهاب” عام ٢٠٠١. لقد وسّع القانون المذكور والمثير للجدل من صلاحيات الاستخبارات الكندية وقدرتها على التجسس على الأفراد، فضلاً عن تزويدها بصلاحية إقامة محاكمات سرية واحتجازات خارج إطار القضاء، وهو ما يخالف القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان والميثاق الكندي للحقوق والحريات.
لم يقتصر الأمر على انتهاك تلك الوثيقة الكندية التأسيسية، ولكن توسع بسرعة لانتهاك حقوق الأفراد. ويحضرنا هنا اعتقال السوري-الكندي ماهر عرار في الولايات المتحدة وهو عائد إلى كندا وذلك بدفع ومعلومات من الاستخبارات الكندية التي وافقت على ترحيله إلى سوريا رغم حمله الجنسية الكندية. أمضى عرار عاماً في السجن وتعرض للتعذيب قبل الإفراج عنه لا بجهود الحكومة الكندية، التي سهلت اعتقاله، بل بجهود زوجته الشجاعة. كيف فقد المهندس ماهر عرار، الذي كان مواطناً لعشر سنوات ودرس في أرقى الجامعات الكندية علوم الحاسوب والاتصالات وعمل في مجاله ذاك، حقوقه كمواطن في لحظة وأصبح في خطاب وسلوك الدولة الكندية خطراً أمنياً؟
كندا تتبدل إذن، ومعها تتبدل صورة مجتمع المهاجرين. تتلاعب بهم الرواية الرسمية وفق الحاجة، فتارة يكون المهاجر دخيلاً، كسولاً مستنزفاً لموارد الدولة ومهدداً لهويتها المسيحية البيضاء، وتارة أخرى يظهر في قوس قزح الدعاية الرسمية وخطابات جاستن ترودو.
كندا التي نعرفها اليوم لم تكن على هذه الحال قبل بضع سنوات فقط وربما لا تكون كذلك في قادم الأيام. يهدد الإيمان بالرواية الرومانسية المتخيلة والعابرة للزمن عن كندا بخسارة “المكتسبات” الحالية التي تشكل مصدر طمأنينة للبعض. الأهم ربما هو أنه يقيَد المخيَلة والحلم بمستقبل أفضل لا يكون فيه “التنوع الإثني” مرآةً للتفاوت الاقتصادي والاجتماعي والصحي.