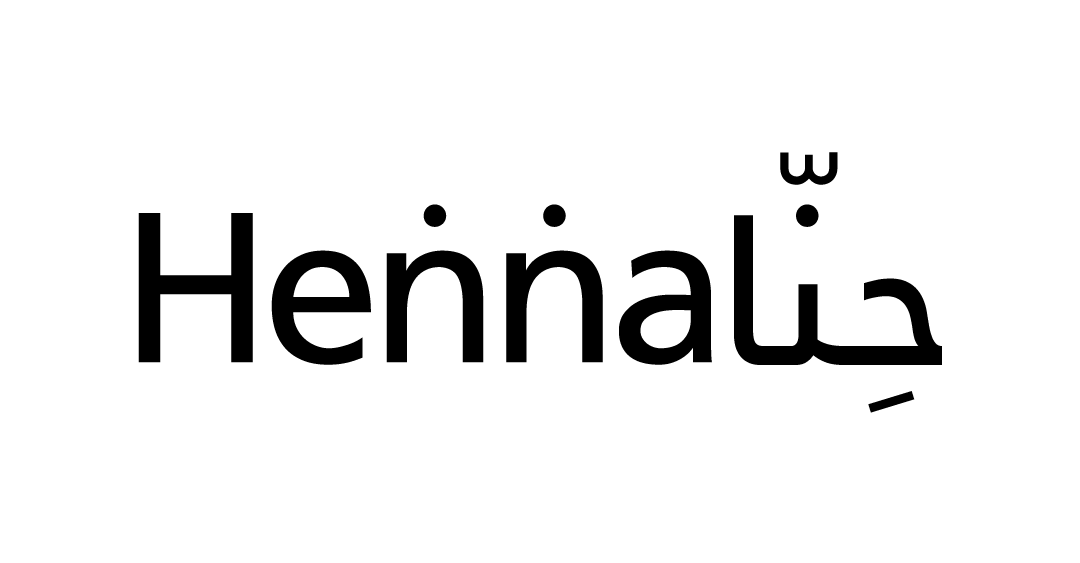العالم ليس قرية صغيرة
تأملات في المسافة والنجاة

هذا المقال هو جزء من مجلة مفازة الرقمية التي تبحث في موضوع النجاة. تقرأون أيضاً فيها: جمهورية الأجساد الكليمة لنبيل محمد، القيامة في الجسد لكنانة عيسى، حوكمة الأمل لحسين الشهابي، أن تهوي من اللامكان لنور موسى، نجاة الهوية في الشتات لعلا برقاوي، تأثيث الذاكرة لعلي زراقط، حين يفهمونك دون أن تضطر للكلام لشاونت رافي، والجروح الحية: عن الانتهاكات والمظلومية لساشا زاك.
___________________________
رجا سليم
صحفية سورية. مقيمة في كندا. درست التواصل والدراسات النسائية في جامعة كونكورديا مونتريال. يتنوع عملها بين الكتابة، إعداد البرامج، الترجمة، والتحرير.
______________________
“وسطياً، يفضل الأمريكيون ترك مسافة 18 بوصة بينهم وبين شخص آخر خلال محادثة عابرة. نظرية القربيات (proxemics) تم تطويرها من قبل عالم الأنثروبولوجيا إدوارد تي. هول في أواخر الخمسينات وبداية الستينات. خلال خدمة هول في الجيش الأمريكي، لاحظ المسافة التي يحتفظ بها الناس بين بعضهم، ووجد أن ثقافات مختلفة تدرك المساحة الشخصية بشكل مختلف. البريطانيون يحتاجون إلى مساحة كبيرة بينما يشعر العرب الشرقيون بالراحة في المسافات الأقرب”.1
في العقود الأخيرة احتلت كلمة مسافة، بشقها المجرد أو اللامادي، حيزاً كبيراً في الفضاءات الاجتماعية والثقافية. فمع زيادة الوعي بالذات الفردية والمساحات الشخصية وخصوصية الآخر، باتت المسافة حاجة ومطلباً وتوقُّعاً. مسافة الفرد من المجموعة، مسافة الفرد من الفرد، مسافة المجموعة من المجتمع، مسافة مجتمع من مجتمع، ومسافة الفرد من ذاته. بينما كان حضور الشق المجرد للمسافة يتعمق، راح الشق المادي للّفظة ذاتها بالتلاشي. التطور الرقمي غيّر في طبيعة المسافات بشكلها المادي، بدليل أن أول شعار اقترن بالعصر الرقمي هو “العالم قرية صغيرة”.
هذا النص هو مراجعة مع تجربتي الشخصية في الانتقال من سوريا وجوارها إلى كندا، وعلى وجه الخصوص، كيف صبغ مفهوم المسافة أول ثلاث سنوات من التجربة بطريقة لم تفعلها العوامل المفترضة الأخرى. مضى على هذا الانتقال ثماني سنوات، أزعم أنها كافية للحديث عن هذه التجربة من “مسافة” أبعد وبالتالي من منظور أشمل.

هذه أنا، إذا دققت جيداً في الصورة تجدني واقفة بجانب المنارة، أمام المحيط الأطلسي. التُقطت هذه الصورة لي من مسافة بعيدة نسبياً، ثالث أيام وصولي إلى مقاطعة نوفا سكوشا الكندية في 21. 05. 2016. كانت هذه أول مواجهة لي مع المسافة بشقيها المادي والمعنوي. بعد مغادرة سوريا، عشت لأربع سنوات بين لبنان وتركيا. لم أشعر يوماً خلالها بالبعد أو القطيعة عن البلد. كانت السماء هناك امتداداً لسماء البلد، والشمس كانت على مسافة واحدة من نوافذنا. يحل الليل علينا بالموعد ذاته، وعلى مد النظر وفي نهاية الأفق، حتى ولو لم نرها، كنا ندرك أن بيوتنا موجودة هناك، على بعد فجر أو ظهيرة.
على ضفة المحيط، لا مكان للخيال. على عكس ما تصوره الروايات والأفلام، غاب الخيال في حضور المحيط. تآمرت عناصر الطبيعة على ذاكرتي وعلى قوة مخيلتي، فأنا من برج السرطان ولي في الخيال مستقر وهو جزء من واقعي. الأفق كان بعيداً وما وراءه كان مجهولاً. السماء غريبة ومستترة خلف غيم كثيف. الصخور تحتي عابسة. أردد في نفسي أن العالم قرية صغيرة، العالم قرية صغيرة، العالم قرية صغيرة… وأصبحت هذه الكلمات بمثابة التعويذة عديمة الجدوى للمكان الجديد.
“العالم قرية صغيرة”. هذا الشعار يحمل رفاهية وامتيازاً لا تملكه إلا قلة قليلة في هذا العالم. أولئك غير المجبرين على الفرار من بلادهم، من اختاروا التجوال في العالم مدفوعين بالفضول وبالرغبة في السفر والاستكشاف، من يملكون ميزة الذهاب أينما ووقتما شاؤوا ثم العودة إلى بيوتهم. أما نحن فعلينا أن نقبل بالمستقرات الجديدة وأن نخلق “مسافاتنا” مع مشاعرنا ورغباتنا وقضايانا، مع الأماكن التي نحب، مع كل من نحب وتركناه خلفنا. لأنجو في المكان الجديد كان علي أن أسخّر عامل المسافة الفيزيائية (8200 كيلومتر) لقبول حقيقة أنني بعيدة جداً، وعليه توجّب خلق مسافة معنوية من المكان الآخر (البعيد).
تقنيات التحايل على المسافة
1. أقرب طريق إلى سوريا: المعدة
لا متسع في حقائب الفارّين من الحروب لغير الضروري والمهم. لا بُعد الوجهة ولا قربها يسمح بحمل أي أغراض سوى اللازمة للنجاة وإثبات الهوية. حتى لو أتاح الظرف بحمل أكثر، هل من حقيبة، مهما عظُم حجمها، ستستوعب ذاكرةً، وهويةً، وعاداتٍ، ويوميات؟ على أولى عتبات سلّم الأولويات، تقبع النجاة. النجاة بالنفس، والوصول إلى مكان آمن، وتجنّب الموت. ما من خلاف غريزي أو اجتماعي على هذه المكانة، لكن ماذا عن العيش؟ يصبح العيش ممكناً بكل ما لا تتسع له الحقائب: طعمٌ يختصر ما نشتهي، رائحة تجعل البيت أدفأ، أو شكل طبق يفتح شهيتنا على يوم آخر.
لا يفقد المغترب عن بلاده شهيته لمأكولاتها مهما طالت سنوات اغترابه حيث “تبقى المعدة عصية على كل برامج الاندماج والتأقلم”. جملة قالها لي ذات مرة الصديق حسين غرير.
هذا أنا ذي، التي كنت أصف شوق وحنين المغتربين (المهجرين، المنفيين، اللاجئين) لأكل بلادهم بالـ “التشظي العاطفي” بتّ واحدة منهم. بات الطعام يحمل أبعاداً أكبر من المذاق بالنسبة لي، فالتمسك بنمط أكل أو مذاق معين هو من الأمور القليلة الباقية لنا من حياة سابقة. من غيّر داراً وعملاً وأرضاً، له أن يُبقي على عادة. في بلادنا لكل موسم أكلة، ولكل مناسبة طبق، وعلى كل ضرس لون. تفاصيل صغيرة على شكل طعم أو رائحة كفيلة بتلوين اليوم وتبديد الوحشة ولو لدقائق.
كل هذا جميل، ولكن تبقى الكلمة الفصل هنا للمسافة. ما أن ينتهي الطبق المشبع بالذكريات والهوية والألفة حتى تعود المسافة لتقف لك على شباك المطبخ، تحدق في منتصف عينك وأنت تغسل طبقك.
2.التفلسف
قياس الزمن مرهون بأفكارنا
قياس المسافة مرهون بإحساسنا
لمرتاح البال، اليوم دهر كامل
لكبير القلب، غرفة صغيرة هي البرزخ2
في الثقافة اليابانية ثمة مفهوم يسمى الـ”ما”. يوصف على أنه وقفة في الزمن وفراغ في المكان تحتاجه الحياة لتنمو. يصف الكاتب الياباني كيوشي ماتسموتو، الـ”ما” على أنها فلسفة كونفوشية عن المسافة بين حافتين، بين بداية ونهاية، وقفة في الزمان والمكان فيها نختبر الحياة… هي معادلة الصمت بدلاً عن الصوت، والنقصان بدلاً عن الزيادة. إنها الوقفة الزمنية اللحظية في الكلام التي تعطي معنى لما يقال، والصمت بين نغمتين التي تصنع الموسيقى. المفهوم مستقى في الأصل من البوذية للتعبير عن جوهر الفراغ. يستشهد ماتسموتو بقصيدة للناسك سايغو خلال القرن الثاني عشر:
صوت الماء،
صوت العاصفة في الجبال
في الفراغ المطلق
يصبح الصديق الوحيد
لهذه الصومعة البعيدة3
فرض المكان الجديد تقنيات ومقاربات جديدة ومتغيرة للتعامل معه، كالتفكير في كل ما حولي من منظور فلسفي، حيث أصبغ الفلسفة، التي أراها مناسبة للحظة التي أعيشها وللمشاعر التي أختبرها، على العوامل المادية البحتة التي يتوجب التعامل معها. وفي كل مرة أقرأ فيها عن ثقافة أو فلسفة جديدة عن الذات والمسافة والوقت، أتبنّاها وأجرب تطبيق قواعدها على نفسي، فأنا الفأر وأنا التجربة. أطالع حسابات التواصل الاجتماعي للأصدقاء كل في بقعة الشتات التي انتهى به/ا المطاف مقيماً/ـةً فيها، وأتلصّص على تقنيات التعايش التي طوروها: هذا اختار السكن في حي ذي أكثرية عربية أو مشرقية ليبدد الشعور بالغربة، تلك التي سلكت درب الروحانية وباتت تتواصل مع ذاتها وهويتها وماضيها بالتأمل وتسخير الطاقة لاستحضار حالات من حياة مضت، هناك من سارع للارتباط والإنجاب وتشكيل أسرة بديلة، وهناك من رفض الواقع الجديد ولم تسعفه طاقته ولا محيطه على الاستمرار فوضع حداً لحياته القديمة والجديدة والقادمة. تفشل وسائل التواصل بدورها في صقل مهارات التأقلم والمواصلة، أغلق النوافذ المطلة على بيروت وبرلين وباريس وفيينا واسطنبول، وأعود لسريري الموجود في غرفتي الموجودة في هاليفاكس الموجودة في كندا الموجودة في أمريكا الشمالية والتي تبعد حوالي 8200 كيلومتر عن الـ”هناك”.
يوم، اثنين، أسبوع، اثنين، تنفذ طاقتي على فلسفة الأشياء وخلق بُعد جديد لها، وتفشل كل الكتابات الشهية من شعر ودراسات ومدونات بأن تسحبني مجدداً من الواقع الفج.
3.التوبيخ الذاتي
تنافي هذه التقنية مفهوم الصمت بدلاً من الصوت، فهنا يعود الصوت الداخلي ليصدح بالتذكير بأنني أختلق أزمة لنفسي من “فراغ”، وأتذمر من واقع يعتبر حلماً لأشخاص كثر. أفكر بأنني في مأمن من الحرب والترحيل والاعتقال والخوف، وأن بمقدوري أن أبدأ حياتي هنا بهدوء. ولكن أليست هذه أنانية؟ وهل النجاة الفردية تعتبر نجاة أصلاً؟ أنا لا أتحدث هنا عن نجاة الفرد مقابل دمار بلده، أعني نجاة فرد مقابل باقي عائلته، وأصدقائه. “عقدة الناجي”، بات هذا المصطلح حاضراً بقوة في حياتنا بطبيعة الحال بعد الحرب في سوريا: الحي يشعر بالذنب حيال من قضى، السليم حيال المصاب، من لم يخسر بيته حيال من نزح وتهجر، من غادر البلد حيال من بقي، من غادر إلى أوروبا والأمريكيتين حيال من علق في دول الجوار، من حصل على الإقامة حيال من يعيش بدون أوراق، من كان في وداع موتاه حيال من حرم من الوداع، وهكذا رحلة من الذنب لانهائية. لكن ماذا لو؟ احتمالات لا نهائية أطرحها على نفسي: ماذا لو التزمت الصمت في الـ2011 ولم أشارك في الحراك (على بساطة مشاركتي)؟ كنت اليوم في سوريا، بغض النظر إن كنت على قيد الحياة أو ميتة. ماذا لو أنني شاركت في الثورة وبقيت في سوريا وزاولت عملي كصحفية خارج مناطق سيطرة النظام؟ لم تكن حينها تلك المناطق موجودة رسمياً. ماذا لو كنت موالية للنظام؟ ماذا لو لم أغادر مدينتي الصغيرة يوماً وعشت وتزوجت وأنجبت، وليغير البلد من هم أقدر على التغيير؟ ماذا لو نجحت الثورة؟ ماذا لو لم تعش سوريا هذه الحرب؟ ماذا لو فقدت ذاكرتي؟
“لا تكوني جاحدة”، أوبخ نفسي مجدداً. ركزي على الناجي وانسي العقدة. في نهاية المطاف، أنتِ نجوتِ والعقدة ستأخذ وقتها للحل.
4. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل4
مثلما نفدت طاقتي على فلسفة الواقع لم أعد أطيق المضي برحلة الذنب كـ “ناجية”. هنا بدأت البحث عن أفق أتطلع له. مرة أمني النفس بأن الحرب ستنتهي والطاغية سيزول وسنعود للبلاد، مرة بأن الحصول على جواز سفر البلد الجديد سيتيح لي فرصة العودة إلى مكان قريب من سوريا، مرة بأن الوقت كفيل بأن أتأقلم مع المكان الجديد وأحبه وأصبح جزءاً منه، مرة بالنظر إلى المسافة الفيزيائية كفرصة حقيقية للنجاة واستغلالها لبدء حياة جديدة، ومرة بالإقرار أن النجاة هدف هدّام، تصور تحقيقها هو وهم وخيانة لقضيتنا ومطالبنا.
سألتني صديقة مرة عما إذا كنت لم أزل أعرف عن نفسي كلاجئة أو غريبة في البلد الجديد، أجبتها بأني لا أريد التخلي عن هذه الهوية طواعية، لأن التخلي عنها يعني نسيان السبب الذي جعلني آتي إلى هذا البلد في المقام الأول. إجابتي هذه كانت بمثابة إقرار بأن النجاة ليست بالضرورة القبول الكامل بالواقع الجديد وليست برفضه تماماً. أول خطوة باتجاه التفكير الإيجابي هي تغيير المدينة، ولنا في حيل الأصدقاء على الغربة أسوة حسنة، اخترت مدينة فيها كثافة مجتمعات “أجنبية” ومهاجرة. بتعبير أصح مدينة البيض فيها ليسوا أكثرية، مونتريال، حيث العرب – مشارقة ومغاربة – والكرد والأرمن واللاتينيون والأفارقة والهنود والشرق أوسطيون وغيرهم. تمشي في شوارع هذه المدينة فلا يطغى لون على لون ولا نمط على نمط، تشعر فيها أنك لست مميزاً ولست القادم الجديد الذي يهرع الجميع للتعرف عليه وسماع قصته. أنت هنا لا أحد طالما كان هذا خيارك. في المدينة الجديدة، تعرفت على أشخاص يشبهونني شكلاً ومضموناً. نتشارك الهوية والهمَّ والقضية والذاكرة، ونحاول تطوير أدوات نجاتنا. ننجح في دعم بعضنا أحياناً ونفشل أحياناً، نتشارك اللوم والتوبيخ الذاتي أحياناً متسائلين عن أخلاقية قدومنا إلى بلد قام على سلب السكان الأصليين لأراضيهم، بلد لا زالت تكتشف فيه مقابر جماعية لأطفال من السكان الأصليين خطفوا في وقت ما من عائلاتهم وزج بهم في المدارس الكاثوليكية لمحو هوياتهم وطمسها بالهوية الاستعمارية البيضاء وانتهى بهم المطاف جثثاً تحت أرضهم المسلوبة. ماذا لو قلنا لا لكندا، أين هي تلك الأرض البريئة من الدماء والذنوب؟ وإن وجدت هل نملك من قرارنا شيئاً لنقصدها مستقراً لنا؟
وثيقة الإطاحة بالمسافة
أيام بعد حصولي على جواز السفر الكندي حجزت تذكرتي سفر، واحدة للقاهرة وأخرى لبيروت. أردت أن أزور مدناً باعتقادي أنها الأقرب إلى سوريا، مسافة وثقافة. في المدينتين شعرت بأنني استعدت سيادتي على نفسي وقلصت المسافة المادية والمعنوية بيني وبين ثقافتي ومكاني الطبيعي. رجعت نفسي التي كنتها قبل ثماني سنوات، أتحدث لغتي وأتماهى مع ثقافة المكان. عشت تحت السماء ذاتها وحل علي ليل البلد ذاته وأطلت علي الشمس ذاتها. في “بلادنا” كانت لهجتي تفضح سوريتي، فيقابلني أصحاب الشقق المفروشة أو الفنادق أو أي خدمة تتطلب أوراقاً ثبوتية بالتردد في استقبالي باعتباري سورية. لكن لحظة الكشف عن تفصيل أنني أحمل الجنسية الكندية كانت تتبدل الوجوه وتلمع العيون وتنفرج الأسارير وتتضاعف الأسعار. تتجلى الحقيقة مرة أخرى، أنا هنا أصول وأجول في شوارع بيروت والقاهرة لأنني مواطنة كندية، جيد! وضعت هذه الحقيقة حداً للـ “تشظي العاطفي” الذي سمحت لنفسي بأن أعيشه وأعادتني للواقع. الواقع الذي يقول إن الأرض على امتدادها محتلة.
تزامنت هذه الزيارة مع اجتياح غزة في تشرين الأول 2023. كانت السماء ذاتها التي حلمت أن أعيش تحتها مرة أخرى تمطر غزة بالقنابل والصواريخ. كان الليل يحمل معه رعب الاستيقاظ على مجزرة جديدة. كان الهواء محملاً برائحة الموت والبارود، والأرواح تفارق الأرض أفواجاً. أمشي في بيروت، أرى الحزن وقلة الحيلة على وجوه الناس صباحاً، والغضب والرفض يملاً حناجرهم ليلاً، مجتمعين أمام سفارات الدول العربية والغربية للمطالبة بوقف الإبادة في غزة. كان وقتها عمر الحرب لم يتجاوز الشهرين. اليوم، نقترب من مرور عام على الإبادة. والحقيقة المؤكدة هي أنه قبل تسعة أشهر كان عشرات آلاف الحيوات تحلم بمستقبل ما، لديها أفق تتطلع له، قبل أن تصبح كل منها رفاة تحت تراب أرضها. في الطائرة عائدة إلى مونتريال والأسئلة تدور في رأسي: هل كان العالم دائماً بشعاً إلى هذه الدرجة ولم نكن ندرك حقيقته لأننا كنا صغاراً؟ هل سننجو بمعجزة في الحلقة الأخيرة؟ هل النجاة غاية تدرك؟
تحط الطائرة، أهمّ في النزول، ها أنا الآن عائدة إلى “بيتي” في النصف الآخر من العالم، أخرج من الطائرة وفي رأسي تتردد عبارة العالم ليس قرية صغيرة. وأتمتم مع نفسي:
يخيل لي أني أتيت بالحرب معيأراها عند قدمي بينما أشاهد التلفزيون
أسمع أنفاسها الرطبة في مكالمات الهاتف
تنام بيننا في الفراش
تفرك ظهري وقت الاستحمام
تزاحمني عند الحوض
في الليل، تناولني الدواء وتشد على يدي
لكن، عيوننا لم تلتقِ أبداً5.
- https://www.psychologytoday.com/us/basics/proxemics ↩︎
- MA: Place, Space, Void May 16, 2018 / HIDDEN JAPAN. Gunter Nitschke ↩︎
- MA: Place, Space, Void May 16, 2018 / HIDDEN JAPAN. Gunter Nitschke ↩︎
- الحسين بن علي بن عبد الصمد الأصفهاني الطغرائي ↩︎
- ترجمة ضي رحمي لقصيدة تذكار – ورسان شاير ↩︎