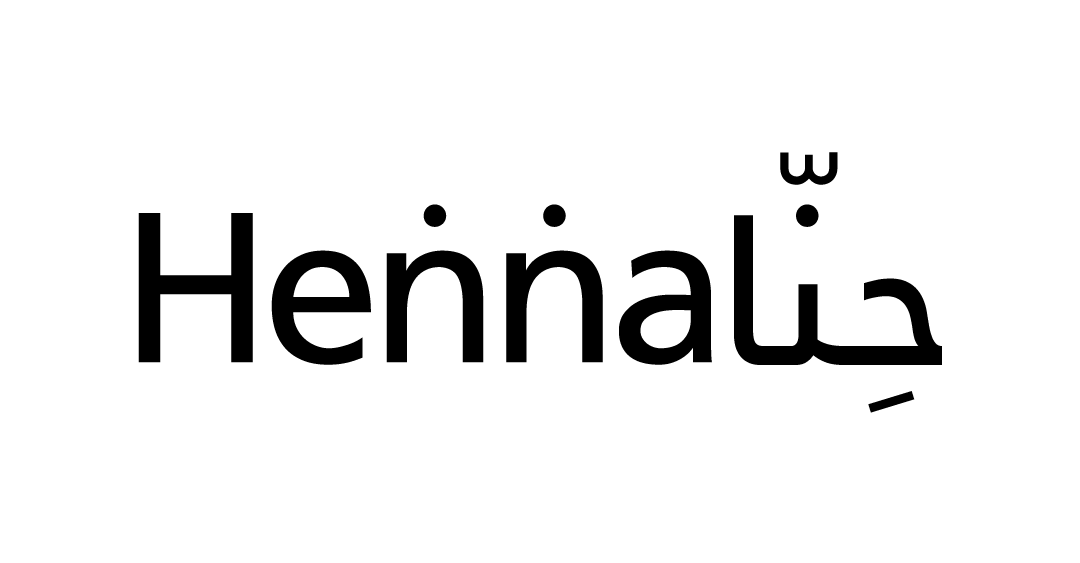الالتفات إلى مواضع التصدّع
عن الكدمات على أجساد وأرواح الناجين من الإبادة
هذا النص هو جزء من سلسلة مقالات ضمن مشروع مفازة الذي يحاكي موضوعة النجاة عبر الشعر والموسيقى. تم إنجاز مرحلة البحث والإنتاج لهذا المشروع بدعم من مجلس كندا للفنون. تقرأون في هذه السلسلة أيضاً: عن توأمة النجاة والهزيمة لوائل سعد الدين، والنجاة بالنغم لعبد الوهاب الكيالي.
مصعب النميري
شاعر وصحفي سوري مقيم في كندا، نشر ديواناً وله عدة مقالات في مجلات وصحف عربية.
العالم الذي يراه الناجون من فعل الإبادة ليس كعالم سواهم. قد نسير في الشوارع ذاتها، ونرتاد الجامعات ونعمل في المكاتب ذاتها، ولكن الأشياء تبدو أكثر شحوباً ورهبةً من هذه الضفة. أمام البحيرة، وفي الغابة، وقبالة المنظر البهي للعالم والحياة التي تتحرك، ثمة وخزة في القلب وشعور دائم بالاستنفار والانقباض.
البشر في أي مكان معرضون للأذى والانعطاب في أي لحظة. الموت والفقدان والرحيل والحوادث غير المتوقعة هي جزء من حياة كل أحد. ولكن الإبادة، التي تمارسها أنظمة الاستبداد أو الاستعمار بحق الشعوب، ليست حدثاً صادماً وعابراً في الحياة يجتازه الأفراد بعد الحداد عليه وطي صفحته. الإبادة هي فعل يُعاد تعريف الحياة على ضوئه. يسحق الأفراد وينسف مجتمعاتهم وشبكات أمانهم. لا يحدث هذا الفعل بومضة وينتهي تاركاً للضحايا متسعاً من الوقت لفهمه والحداد عليه وإكمال حياتهم. هو فعل مدروس طويل الأمد يودي بحياة الآلاف أو الملايين، ويترك الملايين الباقين في المنطقة المحايدة بين الحياة والموت، يتحركون بأعصاب مشدودة ويركضون دون أن يعرفوا الوجهة. قلوبهم وأعصابهم مسارح لمشاعر شديدة الحدة والتشابك والتعقيد والإبهام. علّمتهم الإبادة وما تلاها من تجارب الفرار واللجوء درساً بسيطاً وواضحاً وقاسياً: هذا العالم ليس آمناً. لا يستطيع الناجي التوقف عن الاحتراس والترقب. قد يحاول ذلك، ولكن العالم يجب أن يحاول من جهته بشكل مضاعف لإقناعه أنه مكان آمن ويستطيع فيه أن يغمض عينيه للحظة وهو مرتاح البال والأعصاب. لا ينجو من نجا إلا حين يستطيع تصديق ذلك.
خلاصات على ضوء الهزيمة
في سوريا حدثت ثورة شعبية على نظام حكم البلاد بالرعب لخمسين عاماً، رد النظام على ذلك بسحق الناس بالدبابات والتعذيب والكيماوي، ثم انتشرت التنظيمات المتطرفة كالفطور على امتداد الخارطة التي تفتت إلى أربع خرائط تحت وصاية قوى أجنبية. الأمم المتحدة أحصت أكثر من 300 ألف قتيل، وأكثر من 10 ملايين نازح ومهجر من أصل 23 مليوناً، ونحو مئة ألف قتيل تحت التعذيب أو مختف قسرياً ومجهول المصير، إضافة إلى 2,5 مليون طفل خارج التعليم وأكثر من 12 مليوناً تحت خط الفقر. ما يغيب عن هذه الأرقام هو عدد المصابين باضطرابات نفسية تشمل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وحالات الانتحار أو الإصابة بالجلطات.
ليس ثمة أحد من السوريين الذين أعرفهم بخير، رغم أن معظمنا يحاول هضم ما جرى بصعوبة والسعي إلى الخلاص. لقد كانت الخلاصات التي وصلنا إليها بعد التجربة السورية في غاية القسوة. الرغبة في المحاولة والمبادرة هي أول ما تصدع لدينا بسبب فداحة الثمن الذي دفعناه لقاء التجربة في تغيير مسار التاريخ المؤذي. لقد انتصر الطغاة والمجرمون وتتم إعادة تأهيلهم ونسيان ما فعلوا، فيما انهزم طلاب العدالة في معظم بلدان الربيع العربي وانتهوا إلى السجون أوالمنافي أو القبور. ننظر إلى ما يجري في فلسطين وأفغانستان وإيران ومصر والسعودية وتتعزز الخلاصات التي وصلنا إليها: من يكترث للعدالة ومصائر الشعوب إذا كان ثمة مساحة للمساومة والمناورة لتحقيق المصالح؟ نحاول الاستمرار على ضوء فكرة الهزيمة. ربما نجونا من البنادق والقذائف والأصفاد، ولكننا لم ننج بعد مما خلفته البنادق والقذائف والأصفاد في أرواحنا وأعصابنا.
اقتناص مساحة للحداد والإنصاف والتعافي
الخروج من أوضاع قاهرة ومتوحشة تُكسر فيها إرادة الإنسان وطموحه وعزيمته وصبره وكرامته قد لا تعني النجاة. ذلك أن النجاة تقتضي عبور الإنسان من ضفة الخطر إلى ضفة الأمان، ثم إدراكه أنه عبر واجتاز ووصل. ولكن الواقع لا يقول ذلك، فاللاجئ يُطالب منذ اللحظة الأولى التي يصل فيها إلى وجهته النهائية بأن يشد الحزام ويتأهب لما هو قادم، هذا إذا وصل إلى مكان لا يُستباح فيه مثلما يجري في لبنان وتركيا. ثمة سباق حواجز سريع بانتظاره وعليه الركض والمناورة لتأمين أبسط وأتفه مقومات العيش في بلاد اللجوء الجديدة، مثل ألمانيا وكندا والسويد، علماً أن كل ما راكمه من خبرات وتجارب قد لا تعني شيئاً في سوق العمل الجديد في مدن فادحة الغلاء مثل تورنتو.
دون عائلة أو أصدقاء أو شبكات أمان، يجد اللاجئون أنفسهم مطالبين بالركض في البلاد الجديدة. هم كانوا يركضون أصلاً للهرب من بلادهم وعبور الحدود والاحتماء من القناصة ومواجهة الموت في البحر والغابات أملآ بفرصة للعيش الكريم والعدالة والأمان مثل بقية البشر. خلال هذا الركض المستمر والحثيث الذي لا يتوقف لحظة، لا يتاح للاجئين إدراك حجم الهول الذي مروا به وفهم مشاعر الرعب والذنب والغضب والهزيمة التي تعرقلهم وتشلهم وتحول بينهم وبين الحياة “الطبيعية”. إضافة إلى ذلك، هم يعيشون بحالة من التأهب والرعب لأن أهاليهم وأحبابهم ما زالوا في عين الخطر والفاقة داخل البلاد أو في بلدان اللجوء المجاورة التي تلسط عليهم سموم العنصرية والترهيب وتشن حملات ترحيل بحق المئات إلى سوريا رغم المخاطر العالية بالاعتقال والقتل.
ولكن لماذا نقول كل هذا ونكرره ونؤكد عليه؟ لأن قضية اللجوء غالباً ما يتم تناولها بسطحية وتبسيط عبر ترسيخ صور نمطية للجوء. فاللاجئ إما يتم شيطنته واعتباره خطراً ويُستخدم كفزاعة في التجاذبات السياسية، أو يتم استخدامه كسلعة ترويجية لقيم النجاح والأمل في السردية الهوليوودية التقليدية التي يتحدى فيها البطل/ة كل المصاعب وينجح في الوصول إلى القمة. في الحالتين يتم طمس أو تحوير السياق الأساسي لقصة اللجوء والقفز عن المعاني المعقّدة والمعضلات التي يعايشها اللاجئون كل يوم. نسرد قصتنا كما نريد لإنصاف تجاربنا وامتلاك حقنا في الرواية، وحقنا البديهي في الحداد الذي لم نحظ بفرصة له بسبب كثافة الأحداث وتتاليها المجنون. الحداد على رفاقنا وأهلنا الطيبين الذين لا يستحقون ما جرى لهم. نقول ذلك ونفتضّ قصصنا بروّية وهدوء لكي نتحدى الركض المحموم واللهاث كعرف وقيمة ونحظى بمساحة للتأمل والمراجعة وطي الصفحات التي نريد، بخيارنا لا رغماً عنا.
نقول كل ذلك لأن ثمة معانٍ وأفكار وعلاقات إنسانية ثمينة تتبلور في الوحشة والهشاشة والضعف والمحاولات المتكررة للاستمرار في الحياة. نغوص في معاني النجاة واليأس والهزيمة، لا دفاعاً عن العدمية ولا رغبة في الشكوى المجانية، وإنما رغبة برؤية العالم من هذا الركن المهجور وغير المريح لمعظم البشر. من هذا الركن نختبر حدود طاقتنا وننصف أنفسنا، ونعاين أيضاً مدى قدرة الإنسان على المقاومة والتعافي والتشبث بالحياة. نقول ذلك لأننا جزء من حكاية مطمورة تحت طبقات متراكبة من التجاذبات والأيديولوجيات والتعقيدات الجيوسياسية، وهي حكاية الإنسان التواق إلى الحرية والعدالة، وحكاية القهر والخوف والخسارة والبحث عن المعنى في مكان افتقاده.