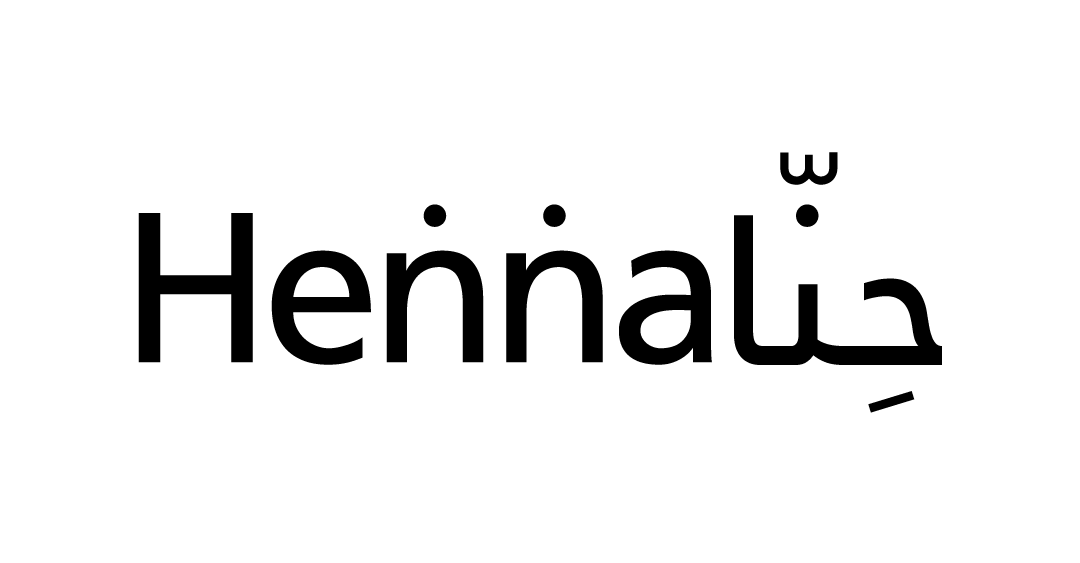نجاة الهوية في الشتات
في تحديات وامتيازات الهوية المركبة

هذا المقال هو جزء من مجلة مفازة الرقمية التي تبحث في موضوع النجاة. تقرأون أيضاً فيها: جمهورية الأجساد الكليمة لنبيل محمد، القيامة في الجسد لكنانة عيسى، حوكمة الأمل لحسين الشهابي، العالم ليس قرية صغيرة لرجا سليم، أن تهوي من اللامكان لنور موسى، تأثيث الذاكرة لعلي زراقط، حين يفهمونك دون أن تضطر للكلام لشاونت رافي، والجروح الحية: عن الانتهاكات والمظلومية لساشا زاك.
________________________
عُلا برقاوي
كاتبة فلسطينية-سورية مقيمة في تورنتو. تتابع دراستها بدرجة الماجستير في حضارات الشرق الأدنى والأوسط بجامعة تورنتو.
________________
“أنا من هناك، أنا من هنا. ولستُ هناك ولستُ هنا”1
يسعى كثير من الكنديين إلى فهم هوياتهم الأصلية والتعريف بها وممارستها عبر اللغة أو الطعام أو الملبس أو الدين. قد يحاولون الحفاظ على انتمائهم لإثنيتهم من خلال تداول أسمائهم وتقاليدهم عبر الأجيال، أو الانخراط في مجتمعات ثقافية تشبههم، أو ترسيخ مفاهيم مجتمعاتهم التي قدموا منها بقيمها وسلوكياتها. وقد لا يكون ثمة من ضير في أن تكون هويتهم غير واضحة المعالم بشكل تام، ولا مشكلة في بعض اللبس أو الخلط مع سمات هوية أخرى. فاكتساب قيمة ما من هناك وملاءمتها مع ما قد تحمله الهوية الحالية هنا قد يُظهر جمالية التناغم الذي يشكل الهوية متعددة الثقافات التي نشأت في كندا عبر السنوات. كفلسطينية هنا في كندا، أحاول أن أفعل كثيراً مما سبق. إنما ليس بشكل طوعي أو تلقائي أو اختياري. ليس عبر عملية تعريف أو فهم أو ممارسة أستطيع الخوض فيها بسهولة. إنني أفعل ذلك في سبيل النجاة بهويتي.
كنت وعلى مدار عدة أيام أمشي محاولة تجاهل شاحنة متوقفة في منتصف شارع ”Shaw“ حيث يصل بين شارعي ”King“ و“Queen“. ألمح من بعيد شاحنة تشبه واحدة لبيع المثلجات ظهرت في إحدى مقاطع الفيديو الآتية من غزة، لطفل يصاحب والده الذي يحمل أكياس قماش مدمّاة. يسأل الطفل إن كان سيتناول البوظة التي تبيعها عادة مثل تلك الشاحنات. يجيب الأب بأن تلك الشاحنة الآن مخصصة لحفظ الجثامين، حيث لا متّسع لها في مستشفيات غزة، وبأنه سيحفظ أكياس أشلاء أشقاء الطفل فيها.
في كل يوم، عندما كنت ألمح من بعيد الشاحنة، أحاول على الفور أن أشيح بوجهي عنها وأن أستبعد مشهد الطفل ووالده وأكياس الأشلاء من رأسي وأن أسرع بخطاي مبتعدة عنها. إلى أن رفعت نظري مرةً نحوها، لأجد عليها صوراً لعشرات الإسرائيليين تتوسطها عبارة ”أعيدوهم إلى المنزل“. كان ذلك خلال الأسبوعين الأولين الذين تليا السابع من أكتوبر، حين كان الشعور الغالب لدى كثير منا، نحن الفلسطينيون والعرب في الشتات، هو السعي للدفاع عن أنفسنا ومحاولة تعريف من لا يعرف بفلسطين، وحثهم لفهم ما يحدث والنظر إلى الصورة كاملة والالتفات لروايتنا. للرجوع بالتاريخ أياماً قليلة.. أسابيع.. أشهر.. أو سنوات وصولاً للعام ١٩٤٨. تحول المشهد الحي إلى سينمائي، عندما حاولتُ فور استيعابي لما هو معروض على الشاحنة أن أسرع قربها الخطا أكثر، وأن أستبعد مشهد الطفل ووالده وأكياس الأشلاء من رأسي، لكنها الآن تتحرك بمحاذاتي.. ببطء.. تمشي بالرتم ذاته الذي يقود قدميّ الهاربة منها، إلى قطعتُ إشارة المرور وسلكت الطريق المعاكس لها.
يناقش هذا المقال مفهوم نجاة الهوية الفلسطينية في الشتات، وخاصة بعد الحرب في غزة، من خلال توضيح مفهوم الهوية المركبة للاجئين الفلسطينيين التي فرضتها الأحداث التاريخية والسياسية في الشرق الأوسط منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً، وتسليط الضوء على الصراعات الفردية التي تتأتى من التفاعل مع المجتمعات الجديدة، والإشكاليات التي تواجه السياقات المتعددة لتشكيل الهويات لدى اللاجئين الفلسطينيين، وما يرافقها من مساعٍ للبقاء والنجاة بالهوية.
“هذه الأرض أصغر من دم أبنائها الواقفين على عتبات القيامة مثل القرابين”
قبل ذلك التاريخ، كنت في غالب الأوقات أعير أدنى شأن لانتمائي وهويتي الفلسطينية-السورية التي تفتقت عن إرث شائك خلّفه النمط الدموي الذي لا فكاك منه والمصاحب للمأساة والظلم، خلال سنوات تمنيت فيها الانعتاق من التراكمات التي حطَّت بثقلها على كاهلي. لم أكن أريد لأي شيء يربطني بتلك البلاد التي أشبعتنا قهراً ولفظَتنا إلى بلاد لم نسعَ يوماً أن نكون فيها، أن يثبط قدميّ اللتان تحاولان أن تمشيا بي إلى الأمام.
ولدتُ في مخيم اليرموك لأبوين ولدا لاجئين. خرجَت عائلتاهما من يافا وطبريا عام ١٩٤٨ واستقرتا في مخيم اليرموك جنوب دمشق حيث تم إيواء مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين آنذاك. سُمي مخيم اليرموك عاصمةً للشتات. وحيث أن الأمم المتحدة تضمن حق العودة إلى فلسطين، لم يحصل الفلسطينيون في سوريا ولبنان ومصر على جنسية البلدان التي ولدوا فيها. بل إنهم نشؤوا وماتوا لاجئين. أطفال فلسطينيي الشتات هم لاجئون قبل أن يفهموا ما يعنيه اللجوء، لكن فلسطينيي سوريا أدركوا المعنى الحقيقي للّجوء بكل تفاصيله المعاشة عندما أجبروا على اللجوء إلى عواصم أخرى. بدءاً من العام ٢٠١١ اكتملت الصورة الحية في أذهان اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لمصاعب اللجوء التي عاشها آباؤهم وأجدادهم الذين أخرجوا من فلسطين.
في دمشق، حملتُ هوية شخصية مكتوب عليها: ”هوية مؤقتة للاجئين الفلسطينيين“، و”وثيقة سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين“. لم تعد بي هويتي المؤقتة إلى فلسطين، ولم تخرج بي وثيقة السفر بشكل تلقائي خارج سوريا.
كان ابني قد أكمل عامه الثاني عندما بدأت الثورة في سوريا. في المنزل، يضيف ألحانه الخاصة إلى شعارات ”حرية للأبد غصباً عنك يا أسد“ و”الشعب يريد إسقاط النظام“. وفي روضة ”العودة“ يحدّق في صور بشار وحافظ الأسد المعلقة في واجهة الصف، ويحيّي علم النظام السوري ويردد نشيد جيشه الذي أخفى والده في أقبية التعذيب لأشهر ثلاثة. بعمر ثلاث سنوات ونصف، يلعن ابني النظام مرة بسبب انقطاع الكهرباء عن الصف ليتم استدعائي في اليوم التالي إلى الروضة حيث ستتجمع حولي جميع المعلمات وهنَّ يلقننه مرتعدات عبارات مثل: “نحن نحب السيد الرئيس بشار الأسد أليس كذلك؟”، “نحن نحب الجيش أليس كذلك؟”. قصف جيش بشار الأسد روضة ”العودة“ بعد حين. ركض ابني في سن الرابعة في ردهات سجن عدرا كثيراً لدى توجهه لمعانقة والده المتهم بالإرهاب. وفي طريقه إلى السجن، تجهَّم في وجه عناصر حواجز المخابرات الجوية والأمن العسكري الذين كانوا يطلقون النكات السَّمجة أمامه. من الحيز الضيق الذي اتخذناه ملجأ في منزلنا في أوقات القصف، تسلل ابني وهو بعمر الخامسة بسرعة لينقذ مبراة أقلامه المفضلة التي لم يُرد أن يصيبها ضرر في حال وجدت قذيفة ما طريقها إلى منزلنا.
مع الرحيل التدريجي لمن من حولنا من إخوة وأصدقاء وأقارب هرباً أو سفراً أو سجناً أو قتلاً تحت التعذيب، ضاقت دمشق بنا حتى بدت وكأنها لم يبق فيها غيرنا. لا وثيقة سفري الفلسطينية ولا جواز سفر ابني السوري يستطيعان إخراجنا من دمشق. اِلْتوتْ بنا السبل وطالت بنا أوقات انتظار التأشيرات التي كانت دوماً ما تنتهي بالرفض. وما إن تمكنّا من الخروج من سوريا حتى استمر ترحالنا زهاء عشر سنوات قبل أن نجد مستقراً لنا في تورنتو.
إذاً، هذا ما يعنيه حقاً أن يكون المرء لاجئاً. خرج أجدادي من يافا بحلم العودة إليها، أما أنا فخرجت من دمشق بغصة لا تشوبها رغبة بالعودة. خرجت غير آسفة على الرحيل، ممتنة لنجاتي وابني منها. لكن أمين معلوف يقول في كتابه ”الهويات القاتلة“، إنه ليس من الهيّن التخلص مما اختزنه المرء من مشاعر تجاه الأرض التي رحل عنها فهو إن “كان قد رحل، فذلك لأشياء رفضها – القمع والتسيب الأمني والفقر وانعدام الفرص. وكثيراً ما يصاحب هذا الرفض الشعور بالذنب بسبب الأهل الذين يشعر المرء أنه تخلى عنهم، والبيت الذي ترعرع فيه… والجذور التي تبقى قوية”.2 غير أنني كنت ما أزال ‘لى وقت قريب أحاول أن ألجم أي نتوء صغير لأي جذر بقدر ما كان قوياً وبالقدر الذي شعرت فيه بفظاظة وجحود فعلتي. ظناً مني أنني بِوَأْدي لتلك الهوية التي تقتل وسائل نجاتي من تلك البلاد، فإنني سوف أتحرر من كل قد ما يعود بي الوراء. ظناً مني أنني في بحثي عن السلام في السبل التي ستتقدم بي نحو الأمام، فإن علي أن أخلق ذاتاً متحررة من كل ما تم تلقينه إياها. وأنني إن كنت أريد التخلص من ذاك الشعور المثبط الناجم عن تنازع الهويتين الفلسطينية والسورية فيَّ، فعليّ أن أبحث عن اللا انتماء لأيّ منهما.
“لا الشرق شرق تماماً ولا الغرب غرب تماماً”
بعد السابع من أكتوبر، أدركت أنه ليس باستطاعتي سوى الانتماء إلى تلك البلاد. لكن، كان توجّب أن أدرك بأنني كنت أواجه لأول مرة مجتمعاً متنوعاً حتى في مستوى الفهم والمعرفة الكافييَن للمنطقة التي أتيت منها. وبأنني لو كنت قد نجحت ولو قليلاً خلال السنوات الماضية في طمس جوانب من انتمائي، لما كنت أشعر بالفزع الآن، وبالرغبة اليائسة في الكلام والشرح والدفاع عن نفسي وعن هويتي وبلدي أمام أشخاص لا يعرفون بنسبة كبيرة شيئاً عما كان يحدث فيها قبل السابع من أكتوبر. إذ إن حالنا كمهاجرين اليوم، بحسب معلوف، يعني وجودنا في زمن جعلنا ”مرغمين على العيش في عالم لا يشبه قط موطننا الأصلي… فيتكون لدينا الانطباع بأن هويتنا، كما نتخيلها منذ طفولتنا، مهددة“3. أدركتُ فجأة أنني لا أمتلك من وسائل أمام كل هذا الظلم سوى الغضب الذي يتوجب أن أحتفظ به لنفسي وأن يرافقه الحذر أمام من يسألني: “من أين أنت؟”. يتوجب علي من الآن فصاعداً أن أتفحص سريعاً انطباعات محدِّثي عن السابع من أكتوبر، أو أن أتجهز لردة فعل خائبة لم أتوقعها من أحد يسألني عن موطني. هل من العادل أو حتى المعقول أن يشعر أي أحد في هذا العالم بأن محدِّثه قد يصاب بخيبة لدى الإجابة عن سؤال كذاك؟
“وأنا آخري في ثنائية تتناغم بين الكلام وبين الإشارة”
لطالما كان من الأسهل علي أن أكتب عن ذاتي، خلال السنوات العشر الماضية، بصورتها المرتبكة من مسافة. لطالما نظرت إلى ما كنتُ عليه قبل خروجي من دمشق، التي شكّلت بطبيعة الحال هويتي، على أنها ذات منفصلة عني، بل وأقل شأناً مني. كل ”أنا“ بصيغها المختلفة، قد تمت كتابتها في هذا المقال بقليل من الراحة حتى الآن. لكن، لا يبدو أنه سيكون من الأجدى اليوم حديثي عن تلك الذات مستخدمة لصيغة غائبة عني في سرد ما تبقى من هذا المقال. إذ إن تلك ستكون مجرد محاولة يائسة أخرى أراقب فيها أشكال ارتباكاتي وإدراكاتي وتغيراتي ونجاتي، من منظور غير متورط بأية لهجة تقريع محتملة لي بسبب سعيي السابق للّا انتماء.
بعد السابع من أكتوبر، صار من الملحّ أن أجيب عن أسئلة من قبيل، لمن أنتمي؟ ومن هم الذين لا أنتمي إليهم؟ هل أنا سورية؟ فلسطينية؟ فلسطينية-سورية؟ عربية؟ لاجئة؟ مهاجرة؟ كندية؟ هل كان مخيم اليرموك وطناً؟ وماذا عن سوريا؟ ماذا أفعل باللكنة الدمشقية التي محت كثيراً من لكنتي الفلسطينية؟ من هذا الشخص الذي بإمكاني أن أتشارك وإياه/ا هوية ما؟ أي انتماء ذاك الذي شكّل ويشكل وسيبقى يشكل هويتي؟ تتوجب الإجابة على كل تلك الأسئلة، وأكثر، لاستيعاب كل الألم القادم من غزة.
كل مقطع فيديو مسجل لطفل يرتجف من الخوف أو مقتول أو مقطّع لأشلاء. كل المشاهد التي لم يتم توثيقها بالصور وددتُ مشاهدتها حتى تلك اللحظة كنوع من الندم. كحق يطالب به أولئك الأطفال، أنْ شاهديني.. هذا ما يحدث لي… وكلما أمعَنتُ النظر في خوف العيون أو طمأنينة ملامح الموت.. كلما تألَّمتُ أكثر، وكلما انتميتُ للألم الذي يحاصرهم وللموت الذي يترصدهم. كلما، نتأتْ جذورٌ من ذاك الانتماء الموؤود، وسمحت لها بالتمدد كيفما تشاء، وأكملتُ في طريق النجاة بهويتي.
“والريح بوصلة لشمال الغريب…”
جميع الأجوبة لأسئلتي كانت تلتقي في مصبٍّ واحد، وهو أن أعترف بأنني كنت وما زالت وسأبقى، واحدة منهم. يتوجب علي الآن تحطيم أشكال هويتي المشوهة التي ركّبتُها عن رعونة وعن قصد عقب خروجي من مكاني المؤقت، دمشق، قبل عشر سنوات مضت. كان النظر في تجربة إدوارد سعيد التي سردها في كتابه/مذكراته ”خارج المكان“ هو ما سهّل عليَّ التعامل مع ذلك الارتباك.
قبل الخروج منها، لم تقدم لي دمشق أي شعور بالمؤقَّت. كانت المدينة التي شكّلتُ فيها مفهوم هويةٍ غالَبت، دونما قصد، فكرة هويتي الفلسطينية التي لم أوقن أنني سأنتمي لها وحدها يوماً. وبعد خروجي من دمشق، لم أستطع يوماً أن أمتلك يقين فكرة عودتي إليها. ليصير انتمائي لكل من فلسطين وسوريا، كهويتين ومكانين، مجرد فكرة قد ينعدم اليقين فيها يوماً ما. يستحضر سعيد في ”خارج المكان“ مصطلح ”كآبة البواخر“، الذي يصاحبه شعور من الغبطة لكل من بقي في مكانه. ففي “اختفاء المغادر وكونه مفقوداً، وربما مُفتَقداً أيضاً… إحساس قوي وتكراري ومتوقع بالنفي ينتزعك من كل ما هو أليف ومريح… كما أن أعظم ما يخيف في المغادرة أنها حالة من الهجران، على الرغم من أن الهاجر هو أنت”.4
كل مغادرة لفلسطينيي الشتات لأرض ما تصبح نفياً بالضرورة حين تمنعنا تلك الأرض من العودة إليها في اللحظة التي نطأ بأقدامنا طائرات المغادرة. لكن، إن كنا قد اعتدنا سابقاً على وداع كل أرض نغادرها دون عودة، وحدث وأن تمكننا من الاستقرار في مكان ما، قد يحدث وأن نرغب بالتخلي مرّة عن دروعنا مصابين بالإرهاق من كل تلك الوداعات. سنريد أخيراً البقاء، في أي مكان وجدنا فيه حيزاً صغيراً من الأمان. حيث تم الاعتراف بنا، بتركيبات هويتنا، بتعقيدات نشأتنا وبالظلم الذي وقع علينا وعلى أهلنا وأجدادنا. وقد يحدث بعد ذلك أننا سندرك بأن كل رحيل عن مكان، ولو كان نحو فرص جديدة، سيصير إجباراً على القطْع الذي قد يثير لدينا رغبةً بمواجهةِ تحوُّلِ المكان إلى مجرد فكرة لا تحمل أي يقين. سيجعلنا نبحث عن أثر يجب أن نكون قد تركناه في المكان ربما يمكّننا من العودة إليه يوماً.
“إن الهوية بنت الولادة لكنها في النهاية إبداع صاحبها، لا وراثة ماض”
في تضادٍّ لكل ما قد يواجهه فلسطينيو الشتات من صعاب، يقول سعيد في مذكراته، إن حياته الجديدة في الولايات المتحدة، اضطرته إلى محاولة تناسي ما تعلمه في القدس والقاهرة. إذ إنه في الوقت الذي كان عليه أن يبدأ بتعلم الأشياء من الصفر، بدأ بابتكار “ذات جديدة، في رحلة تضمنت سبلاً عسيرة ومحاولات كثيرة من الفشل والتكرار في ابتكار تلك الذات”.5 لكنه يعود ويقرّ بأن عملية نسج الهوية والتفكير فيها استمرت قائمة حتى وقت متأخر من حياته، دون أن تنتهي. يقول في إحدى مقابلاته إن المنفى يتيح فرصاً أكبر، ليست متاحة لمن لازم مكانه ومارس حياته بنفس الوتيرة منذ نشأته. يقدم المنفى امتياز امتلاك أكثر من عين تطابق كل واحدة منها الأماكن التي زارَتها. بالتالي، بدلاً من رؤية تجربة ما كشيء مفرد متكامل، سيصبح لدى العين المنفيّة على الأقل جانبان اثنان. من جهة، جانب ينظر إلى التجربة في المنفى ويمعن النظر فيها مطولاً، وجانب نظر لتجربة مشابهة في المكان الذي أتت منه العين. فإذا اجتمعت التجربتان في عين واحدة يتم خلق ازدواجية إيجابية في التجربة. يقول سعيد في المقابلة أيضاً، إن ثمة فضيلة خاصة في كون المرء فلسطينياً. المتعة هي أن انتماءنا سيعلمنا الشعور بخصوصية هويتنا. سوف ينزع عنها صفة المشكلة ويحوِّلها إلى نوع من الهِبة. وفي الواقع، فإن الشتات يعطي نوعاً من الهالة.. ليست تلك التي تشبه القدسية أو ما إلى ذلك.. لكنها تلك المساحة التي توفر للفلسطينيين فرصة عيش تجربتهم الخاصة بطريقة جديدة، عندما يدركون أنهم يحملون هوية تستحق التشبث بها، وسط الشعور العام بأن ثمة نية لتدمير واسع للمجتمع الفلسطيني بشكل عام، ولهويته بشكل خاص.
كنت قد انقطعت طويلاً عن اللقاءات المعتادة لأصدقائي السوريين قبل أن أذهب إلى إحداها مؤخراً في احتفال بالحصول على الجنسية الكندية. ضمت الحفلة أصدقاء ومعارف من سوريا والأردن ولبنان وكندا، وآخرين لا أعرفهم بلهجات ولغات تنوعت بين عربية وإنكليزية. بدا لي وكأن مجموعة الحاضرين قد خلقت جواً من الألفة والدعم والمحبة بشكل لم أختبره من قبل، أو ربما أنا من اخترت ألا أنتبه لذلك قبل تلك الأمسية. الكثير والكثير من العناق والرقص والحميمية والأحاديث بين الجميع. وكأن المكان الذي لم يتجاوز خمسين متراً مربعاً قد أصبح للحظة قطعة من أرض أتى منها كلّ منا، اقتطعت من دمشق أو بيروت أو القاهرة أو عمان أو بغداد، وتم الإتيان بها إلى قلب تورنتو. وكل هذا، في حفلٍ لحيازة الجنسية الكندية. ويبدو أن حضور الكوفية التي اتكأت مرتاحة على كتوف الشبان والشابات مصاحبة لكل ما يفعلون، قد أصبح تلقائياً في تلك اللقاءات. تداولها الجميع فيما بينهم وتعالت الصيحات كلما رفعها أحدهم عالياً. حضرت الكوفيات في لقاءات الفرح تلك، هي ذاتها الكوفيات التي سوف تحضر في ظهيرة اليوم التالي في واحدة من المسيرات الأسبوعية التي يذهب إليها كثير من الأصدقاء المتخمين بالألم القادم من غزة.
في أيام كهذه، تتمتّن الهوية الفلسطينية لدى فلسطينيي الشتات وتتمدد جذورها عندما ندرك امتيازاتنا في كوننا ما نزال فلسطينيين في الشتات. لدينا ما يكفي من الخيبة والإحباط في وعينا الجمعي المترسخ بداخلنا منذ عقود لخلق ما يشبه اليقين بعدم وجود أية حلول سياسية قد يتأتى منها في المستقبل القريب عدالة أو إعادة حق. وعلى الرغم من أن هذين المطلبين هما أُسّ الاستحقاقات الأجدر بالحصول عليها قبل البحث عن الحلول، فإننا غالباً ما قد نجد أنفسنا في شتاتنا مجبرين على المساومة حتى لدى محاولتنا الحصول على اعتراف بصحة رواياتنا. لكن، طالما أن الرهان على تلاشي الهوية في وفاة من أُخرج من فلسطين ومن ثم ضياعها رويداً رويداً مع الأجيال اللاحقة ما يزال غير رابح حتى الآن، بل إن ثمة تعويل كبير على الجيل الجديد الذي يتظاهر ويقاطع ويقاوم كتم الأصوات ويتحدى الروايات المجحفة. فاليوم، بعمر الخامسة عشرة، يخرج ابني في تظاهرات مع أصدقائه في مدرسته وسط تورنتو دعماً للفلسطينيين في غزة، ويستبدل الغيتار بالعود ليعزف عليه أغنية “موطني”، ويتعلم عزف موسيقا أغنيات لأم كلثوم، ويستمع معي بفضول إلى قصائد محمود درويش ومن ثم يقترح عليّ أخرى.
إن الانطلاق من امتيازاتنا كفلسطينيي شتات وترجمتها إلى أفعال تتجلى في استكمال السعي لتحقيق العدالة والمطالبة بالحقوق وفتح عيون الناس على الحقيقة، قد يبعث بعضاً من الأمل. سوف تبني تجاربي على سابقاتها وربما ستزداد هويتي تركيباً، وقد يكون من الأجدى التسامح مع فكرة عدم الوصول إلى حل لمسألة الهوية المكتسبة، فالهوية التي تدرك أنها تحاول النجاة في مواجهة من وما يسعى إلى تهميشها، هي في النهاية هوية باستطاعتها لملمة ما تبقى منها لتشكّل من كل ما تستطيع إنقاذه، هوية أخرى، تنجو لتستمر في تشكيل نفسها المنتمية إلى تلك البلاد.