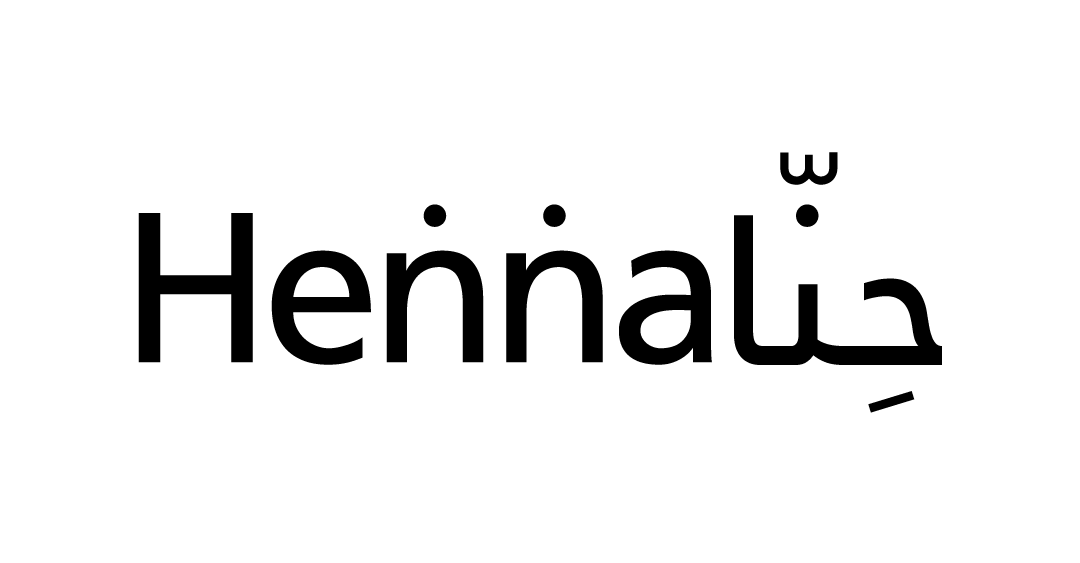محاولات النجاة والعيش خارج الكابوس
سما مكتبي
لاجئة سورية مقيمة في كندا منذ عام، وأم لطفلتين.
برميل .. برميل
أيقظني صراخ أحد الأشخاص في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية في حلب.كان يصرخ مُعلناً عن غارة مروحية. أغمضت عيني مستسلمه للنهاية القريبة، لكن عيوني حملقت في المدى بعد ارتفاع سحابة غبار من البناء المقابل لمنزلي. ركضتُ إلى طفلتي أبحث عنها بين الغبار الذي ملأ المكان، فحملتها وخرجت بها إلى الخارج. خطواتي كانت مُتعثرة، وعيوني كانت مشدوهة من الدمار الذي خلفه البرميل المتفجر. كان ثمة عشرة قتلى والعديد من الجرحى حصدهم البرميل دفعة واحدة. أكملت طريقي إلى مكان أكثر أماناً وبقي زوجي يوثق بكاميرته هذه المجزرة الصباحية.
أحاول منذ ذلك الحين الفرار من رائحة الموت التي تطاردني على الدوام. كانت الخطوة الأولى للفرار منها عبر الانتقال إلى مكان إقامة جديد. غير أنه في هذا المكان أيضاً كانت تطاردني فيه تلك الرائحة، إذ كانت تظهر في الأنفاس والنبضات والأحاسيس. رائحة الموت الذي يحوم حول القلب ويحتلّه.
لم يكن من السهل على شابة تنبض بالحياة مثلي الانخراط في العالم. كنت حديثة العهد بمفهوم الأسرة والارتباط الزوجيّ إذ كان قد مضى على زواجي حين اندلعت الثورة عامان. كنت أماً لطفلة تتدفق بالبهجة وأنا في العشرين من العمر.
حين بدأت الثورة، كنت أمنّي نفسي بمستقبل بهيج كجمال ضحكة طفلتي. كنت أحلم بحياة مختلفة عن تلك التي عشتها وأبناء جيلي تحت سطوة النظام الفاشي المستحوذ على السلطة لعقود، خاصّة بعد خروج معظم الأراضي عن سيطرته. كان الأمل بالتحرر وقيام نظام على العدالة والمساواة وحفظ كرامة الإنسان قريباً جداً. إلا أن ذلك الأمل الذي كان يشبه قبلة الحياة لمعظم السوريين قد تم اغتياله.
أصبحت الخيبة زاداً لنا نحن السوريين. وأصبح همّ معظمنا هو البحث عن بدائل واللجوء إلى دول الجوار القريب أو بلاد ما وراء البحار. نجحتُ بعد محاولات عديدة في اللجوء مع ابنتيّ إلى تركيا، إلا أنني تركت زوجي تحت الثرى في سوريا. كان يعمل إعلامياً وقضى برصاصة قناص.
كنت كمثل معظم السوريين أظنّ بأن تركيا لن تكون إلا مرحلة مؤقتة في حياتنا، نعود بعدها إلى حياتنا ورفاقنا في سوريا. لكن تلك الظنون تبددت مع نظرة شاردة إلى سوريا من خلف الحدود.
كانت الحياة الجديدة صعبة للغاية في تركيا، فهي تتطلب تعلم اللغة للتمكن من التواصل مع الأتراك أو إيجاد أي نوع من أنواع العمل.كان جل اهتمامي هو تربية طفلتي اللتين تكبران أمام عيني يتيمتان غريبتان لضمان مستقبل أفضل لهما، ولكن ذلك لم يكن متاحاً لي ولا لهما.
بعد إدراكي لمدى صعوبة الحياة ومتطلباتها في تركيا، بدأتُ البحث عن حلول جديدة ترضي طموحي وأحلامي بأن أكمل دراستي التي انقطعت عنها في وقت مبكر. قررتُ العمل على هجرة جديدة، لكنها هذه المرة لن تكون هجرية قسرية تشبه خروجي من حلب. كانت هجرة اختياريّة للابتعاد عن البلاد التي ربما لن يتسنى لنا فرصة العودة إليها مجدداً. لم يكن لطفلتيّ ذنب في كل ما يحدث، ومن حقهما أن تحظيا بفرصة أفضل للعيش والتعلم. ولأنني لا أريد لهما تكرار التجربة التي مررت بها، فقد حسمت الأمر نهائياً وتقدمت بطلب للأمم المتحدة للاشتراك في برنامج إعادة التوطين.
في الثامن عشر من أكتوبر 2019 تلقيت مكالمة هاتفية من موظف الأمم المتحدة أبلغني فيها بأن كندا ترحب بي وبعائلتي الصغيرة على أراضيها. كانت تلك المكالمة شهقة حياة جديدة لي؛ أربكتني وأفرحتني ونقلتني على جناح الخيال إلى بلاد يُعامل مواطنوها بكرامة، بصرف النظر عن اختلاف أعراقهم وأديانهم وطوائفهم.
مر الوقت سريعاً قبل أن يتحول هذا الحلم إلى حقيقة. وحين دقت الساعة في منتصف ليلة الثلاثين من يناير كنت أجلس أمام نافذة تطل على مهبط الطائرة وأضم إلى صدري قلبين، كل منهما بحجم الكون، لأعبر بهما القارات، ونحظى ببداية جديدة في بلاد البرد، علّنا نجمّد هناك حزننا البائس.
وصولي إلى كندا كان أشبه بالخروج من رحم مظلم إلى حياة فسيحة رحيبة؛ الحياة التي ظننا أننا فقدناها إلى الأبد. بدأنا حياتنا الجديدة من تحت خط الصفر في رحلة البحث عن الذات وإعادة تكوين الهوية. تم الترحيب بنا والتأكيد على أننا كنديون منذ لحظة هبوط الطائرة. كان ذلك الترحاب دافئاً وكفيلاً ببث السلام الداخلي في أرواحنا المرهقة.
في كندا، لم يكن يخلُ الأمر من الصعوبات والتحديات.كان أبسط هذه التحديات هو عائق اللغة، وصولاً إلى أكثرها تعقيداً، وهي تلك المحاولة المستمرة في إعادة تهذيب الفوضى الداخلية الذهنية والروحية التي تسببت بها سنوات الحرب. أصعب ما في الأمر هو التخلي عن ذلك الجزء المخيف من الذاكرة، المملوء بالفقد والدمار والانكسار والفجيعة، وإدراك أن ذلك الجزء يحتل مساحة يقظة من الذاكرة غير قابلة للاستبدال، حتى وإن تم استبدال الأهل والرفاق والوطن.
التجارب العنيفة التي يمر بها الإنسان تجعله يضاعف إصراره على اقتطاف فرص الحياة الكريمة وتثمينها. لقد استطعت وطفلتيّ أن نحدد، ولو بقدر بسيط، مسار حياتنا كما ينبغي لها أن تكون، وكما ينبغي للإنسان أن يعيش. طفلتيّ تذهبان إلى المدرسة وتمارسان هواياتهما كأي طفل في أي بلد يحترم الطفولة ويدرك متطلبات الأطفال. أما أنا فأعيش مراحل الشفاء من ندوب الحرب التي انحفرت عميقاً في الروح. لقد تبنّيتُ قطةً صغيرةً وتمكنت من تكوين صداقات ومعارف جديدة أشاطرهم اهتماماتي وهواياتي ونتبادل الزيارات والأحاديث، بالإضافة إلى أنني تجاوزت عدة مستويات في تعلم اللغة وصار وقتي مشغولاً بما أحب وما أريد. الحياة بدأت تستعيد معناها.
الكثير من النساء في بلادنا مررن بتجارب مشابهة لتجربتي. أقول لهنّ: ثقوا بأنكن تستطعن الإنجاز. آمنّ بأنفسكن. تجرأن على الحلم، فالحلم محّرك التغيير، والخوف قاتله. قد يكون الطريق صعباً ومعجوناً بالألم، إلا أنه في طيّات هذا الألم المرافق لرحلة التغيير، تكمن لذة الإنجاز واكتشاف الذات ومكامن القوة فيها. حين يخرج الإنسان من كهف الخوف يدرك كم أن الحياة لها معنى، وكم وأنها تستحق المحاولة.