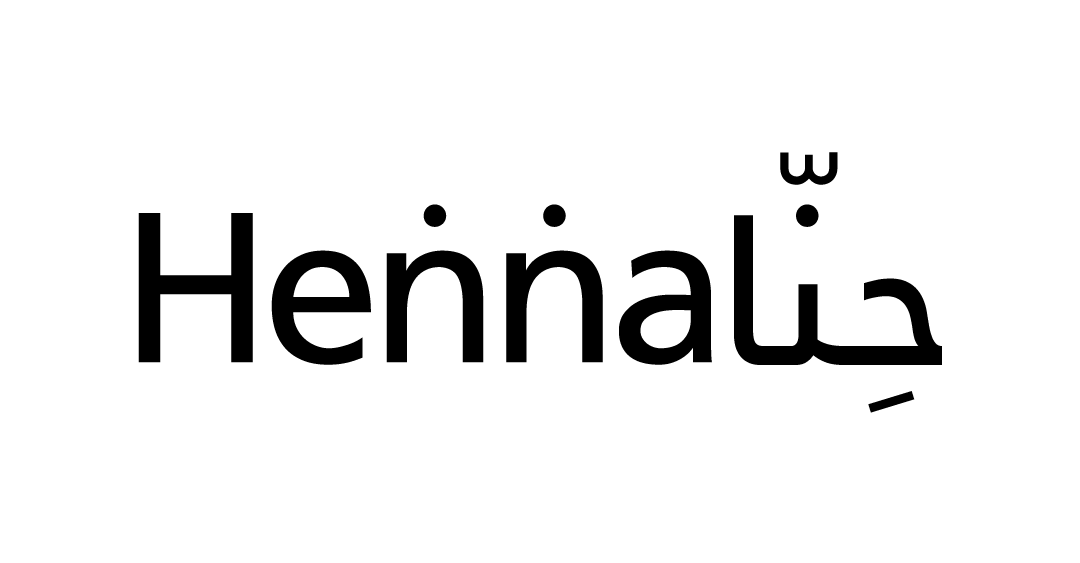قصص منسية غير عادية
هشام الهادي، اسم مستعار
“الضيق، يقتلنا الضيق”
هذه كانت كلمات المخرج السوري فواز الساجر قبل موته مختنقاً داخل شقته في دمشق.
لطالما أثرت بي هذه الكلمات وأثّر فواز الساجر بي بصفته أحد أهم المسرحيين المعاصرين. لطالما شعرت بالضيق أنا ابن هذا القرن، ابن الثورة المهزومة، ابن المسرح الضال، وابن اللاجدوى وحتمية التغيير، ابن هذه المدينة: دمشق.
أنا مسرحي سوري، أعيش في دمشق/سوريا. بدأتُ العمل على مسرحية مع أصدقائي في لبنان، موضوعتها الموت. قررنا البحث في الموت وتجلياته، في الانتحار وأثره، وفي الفقدان وقبحه، والبحث عن الحرية في طياته وثناياه. البحث هنا في عالم أصبح مقيداً من الداخل، في المدينة الكبيرة الخارجة عن البلاد. المدينة الباردة المهزومة الناجية من فوضى القتل، التي لا ذاكرة لنا فيها في حضور الموت، ولا قبول ولا اعتراف ولا عزاء. حيث انتفضنا وهُزمنا وقُتلنا وُولدنا ونُسينا. في غرفنا حيث ننتحر بلا رسائل. في دمشق، في بيروت، في هذه المدن المغضوب عليها.
جاءت اللحظة التي يجب أن أسافر بها إلى لبنان لبدء البروفات. كنتُ متحمساً لفكرة السفر، فأنا لم أسافر في حياتي قط. لم أجد أمامي إلا طريق التهريب “غير الشرعي”، بسبب تعقيدات السفر وتكاليفه. كان خيار الذهاب في هذا الطريق حتمياً، فبقائي في دمشق والتخلي عن المسرحية لم يكن مطروحاً بالنسبة لي أبداً. تحمستُ للتجربة وإلى ما قد تضيفه إلى خيالي في خلق شخصيات وقصص. كما أنها ستكون قصة جميلة بالنسبة لي، فأنا أسافر لأجل المسرح. كنتُ بحاجة هذه المخاطرة لكي أشعر بأنني على قيد الحياة بعد الموت البطيء القاسي في دمشق.
بدأت الخطوة الأولى من الرحلة بركوب سيارة ضيقة مع أناس كثر. انطلقت السيارة من دمشق مليئة برائحة العرق والخوف والرغبة والصمت. لم أتعرف على أي أحد، ولم يذكر أحدٌ اسمه للآخر. وخلال ساعة كاملة كانت نكات الشوفير الرديئة هي الوحيدة التي تكسر الصمت في السيارة.
ليلة مع حفيد نيتشه
وصلت إلى منزل في قرية بسيطة قريبة من الحدود، قضيت فيها ليلتي منتظراً الصباح، وهو الوقت المتفق عليه بين المهرّب والحاجز لكي نستطيع المرور بأمان. هذه الليلة كانت من أغرب الليالي التي مرت عليّ في حياتي، فقد تعرفتُ على صاحب المنزل، وهو الشخص الذي يُفترض أن يقطع بي الحدود.
المهرّب صاحب العشرين ربيعاً، بدأ بسرد قصة حياته التي تظهر فيها شخصيته النيتشوية، التي تؤمن بالعدم وبؤس العالم وكيفية مواجهته بإرادة القوة، ولكن بمنطقه الخاص البسيط. بدأ بالعمل في عمر السابعة بتهريب المازوت والمحرقات، مروراً بتهريب أكثر من مادة، ووصولاً إلى تهريب البشر. فتهريب البشر، بحسب قوله، هو أكثر أنواع التهريب أمناً ودرّاً للأرباح.
شرح لي الفتى كيف صنع ثروة من عمله هذا جعلته هو وأبناء قريته يبنون هذه القرية على الحدود بعد تدمير منازلهم إثر القصف. ثم انتقل إلى الحديث عن الفرق بين أبناء المدن وأبناء الأرياف، وكيف أن المكان “يطوّع أبناء المدن ويفرض عليهم شروطه، بينما أبناء الأرياف هم الذين يطوعون المكان ويتحكمون به”، بحسب قوله.
حاولتُ فحص هذه النظرية عبر إسقاطها على نفسي، فأنا أيضاً أعمل منذ كنت في السابعة من عمري، ولكنني اليوم بحاجة هذا الشخص لينقلني من مدينة فشلت بها إلى مدينة أخرى لأبدأ بها من جديد. بينما هو، حين خسر مكانه القديم بنى مكاناً جديداً على أساس اختياره لوجوده في العالم كمهرّب أولاً وكمتمرد ثانياً. أكد لي الفتى أنه مطلوب من السلطات أكثر من مرة. كنت أتابعه وأنا منبهر ومتفاجئ ومعجب وخائف، وتدور في رأسي أسئلة عن التمرد وجدواه وأشكاله المختلفة، عن كمية العوالم التي لا نعرف بوجودها، وعن هذه الشخصية التي يمكن أن تكون بطلاً تراجيدياً معاصراً.
انقطعت سلسلة أفكاري بجملته الأخيرة، ألا وهي: “إي بس كس أخت هالحياة”. لنصمت بعدها ونحدق بالفراغ، وأقضي ليلةً مليئةً بالهلوسات التي انتهت ببزوغ الفجر؛ العلامة المنتظرة لانطلاقنا.
طريق الخوف إلى بيروت
انطلقنا في الفجر ووصلنا إلى الحدود. تعرّفتُ على “زملائي” في الرحلة. عدد الناس الكبير الذين رأيتهم كان يُشعرني بالقلق والأمان في الوقت ذاته. بدأت الخطوة الثالثة ومشينا في طابور طويل في مشهد كمشاهد هجرة الفلسطينيين التي تكرست في عقولنا في الصور الوثائقية أو في الدراما التلفزيونية. بيد أن المشهد كان خالياً من الشحنة العاطفية التي نشعر بها لدى رؤية “مشهد الهجرة” الدرامي. كانت الرحلة كأي مشوار عادي، فبعض الناس كانوا يروون لي كيف عبروا هذا الطريق أكثر من مرة. مررنا عبر الحاجز الحدودي السوري، سلمنا عليه وأكملنا طريقنا وهو يقوم بإحصائنا لكي يقبض لاحقاً ثمن العبور. وصلنا إلى الجانب الآخر بسهولة تامة. لم أشعر بشيء. تلك المشاعر التي اعتقدت أنني سأشعر بها عند عبور الحدود، لم تكن موجودة. شعرتُ فقط بالتعب والخوف. داهمتني أسئلة البقاء والرغبة فيه. تساءلتُ عن معنى البلاد والأوطان. وفكّرتُ في المجهول والخوف منه والسعي إليه.
دخلتُ إلى لبنان. وهنا انتقلت رحلتي إلى مستواها الثاني والأصعب، ألا وهو الوصول إلى بيروت. تنقّلت بين أمكنة كثيرة هرباً من الدوريات اللبنانية. شعرتُ أنني مُلاحق. بدأتُ أفكر بأنني مجرم “خارج عن القانون” و “غير شرعي”.
حين كنت أتخيل سيناريو الاعتقال المرعب، كنت دائماً أفكر بالحوار المُتخيل الذي يمكن أن أحاجج فيه بأنني “لا أريد إيذاء أحد”، وأنني “أريد العمل في المسرح فقط”. من المُفترض أن يكون الإجرام مقروناً بالأذى، ولكن ما هو الأذى الذي أُحدثه الآن؟ وما الذي يجعلني ملاحقاً؟ كنوع من المساومة افترضتُ أن الإجرام مختلف عن الخروج عن القانون، ثم حاولت العودة إلى الواقع من خيالاتي وأسئلتي.
الحرية مع غريب
وصلت إلى المنزل الذي سأنتظر به 12 ساعة إضافية حتى أستطيع العبور من القرى الحدودية اللبنانية إلى بيروت. قضيت أول 6 ساعات في صمت تام منغلقاً على ذاتي.
بدأ الخوف يشل حركتي. عندما أدركتُ هذا حاولت الخروج من رأسي عبر التحدث مع الأشخاص الموجودين في هذا المنزل، وهي عائلة السائق الذي سينقلني. لم يكن هو موجوداً في المنزل. تحدثتُ إلى زوجته اللبنانية وتعرفت على هوسها بسوريا وحبّها لها، متفاجئاً من كمية هذا الهوس والإعجاب بمكان لم أعُد أرى فيه أي تفصيل من تفاصيل الحياة. تعرفتُ على أطفاله المُسيطر عليهم من قبل الهاتف المحمول والرغبة بأن يصبحوا كأبيهم.
تعرفتُ على أحد المسافرين خلال انتظاري هذا. رجل خمسيني يعمل في البناء. جاء إلى هنا لكي ينهي عملاً له، وحين أراد التعرّف علي، قلت له إنني أعمل في المسرح من باب الفضول لمعرفة ردة فعله. بدأ بذكر أسماء مسرحيين معروفين، وتطور الحديث إلى مناقشة فكرة الأحزاب السياسية وما فعلته في البلاد من تطويق للحرية والرأي واحتكار الفاعلية السياسية. دخلنا في صمت مربك بعد انتهاء الحديث وعدم قدرتنا على فتح غيره بسبب الريبة التي تسببها أحاديث كهذه، خاصة في مكان مجهول كهذا، ونحن ننتظر شيئاً لا نعرفه.
ظلّ الحديث يدور في رأسي. وشعرتُ أنني أبالغ في التفكير بسبب محاولة إيجاد معنى ما في هذه التفاصيل. فكرتُ بمحاولتي إقحام مفاهيم كبرى في تجربة السفر هذه لكي أرى أي معنى. قلت لنفسي إنني يجب أن أتعامل معها كرحلة بسيطة، وأن أرى هؤلاء كأشخاص عابرين في الحياة.
كليشيه الأمل
بدأتُ خطوتي الأخيرة قبل وصولي إلى بيروت. انطلقنا في منتصف الليل، وأخفيت أي إثبات لهويتي بحسب توصيات المهرب. كانت الخطوة الأصعب هي المشي لمدة 5 ساعات عبر طريق شائق ومُعتم دون إصدار أي صوت، لكي نعبر الحاجز الأخطر.
معنا الكثير من الأطفال وكبار السن. بدأتُ أتساءل عن مدى قسوة هذه الذكرى في عقول هؤلاء الأطفال. مع بدايات المشي وإدراكنا أن الرحلة لن تكون سهلة أبداً، تساءلت عن جدوى كل هذا. لو عرفتُ أن الخطوة الأخيرة ستكون بهذه الصعوبة لما أقدمت على هذه التجربة أساساً.
فجأةً، أمسكت فتاة صغيرة بيدي بعد أن أضاعت والدتها. سألتُها عن اسمها فقالت لي: “أمل”. ضحكتُ في خاطري ساخراً. رأيتُ اسم الفتاة في هذا الظرف ككليشيه باهت، وفكّرت بأن الكليشيهات تنتشر لأنها مريحة لشخص يقرأ العالم على شكل رموز وأسئلة. تساءلتُ عما إذا كان الكون يريد أن يقول لي شيئاً. نظرتُ إلى السماء ورأيتها تزدحم بالنجوم. لم أرها كذلك من قبل. أشرت إلى السماء لكي تراها “أمل” وتنظر هي بدورها إلى النجوم بعيون واسعة مليئة بالشغف والجمال والعطش للمعرفة. فجأة تعثّر أحد كبار السن فهرعنا لمساعدته، وعندما عاد الجميع إلى أماكنهم نظرتُ إلى “أمل”. لم تكن تأبه لما حدث، وتابعت تحديقها في النجوم وكأنها وجدت الله. كان هذا هو التفصيل الوحيد الجدير بالذكر في هذه الساعات الخمس، فبقية التفاصيل كانت مليئة بالخوف والرهبة والتعب والإصرار على طريق مظلم نحو لا جدوى مؤكدة. لم أعد أشعر بالزمن، وسيطرت على عقلي فكرة أنني لن أخرج من هنا أبداً، وأنني سأُخلد في هذا العذاب وأنا أحاول أن أصعد الجبل، كسيزيف، ولكنني تابعت الطريق بسبب انعدام الخيارات.
بزغ الفجر مع وصولنا إلى نهاية الطريق. ركبنا السيارات بسرعة خوفاً من الدوريات الصباحية، وانطلقنا نحو بيروت وأنا ممتلئ بالتراب والعرق والمفاجأة والبؤس والنشوة.
وصلتُ…
رأيتُ السماء والبحر والناس في يوم عادي جداً في هذا العالم البائس. شهدنا بزوغ النهار ذاته، رغم ليلتنا المختلفة.
سأعمل في المسرح الآن. سأكتب عن الموت والحرية والفقدان والضيق والرغبة والجمال. سأتجاهل هذه الرحلة حتى لا أعود قادراً على التجاهل. سيأتيني الضيق كقاتل متسلسل، مسرحُ جريمته هو مدننا المهزومة، المليئة بقصص منسية ليس في هذا العالم من يهتمُ لسماعها.