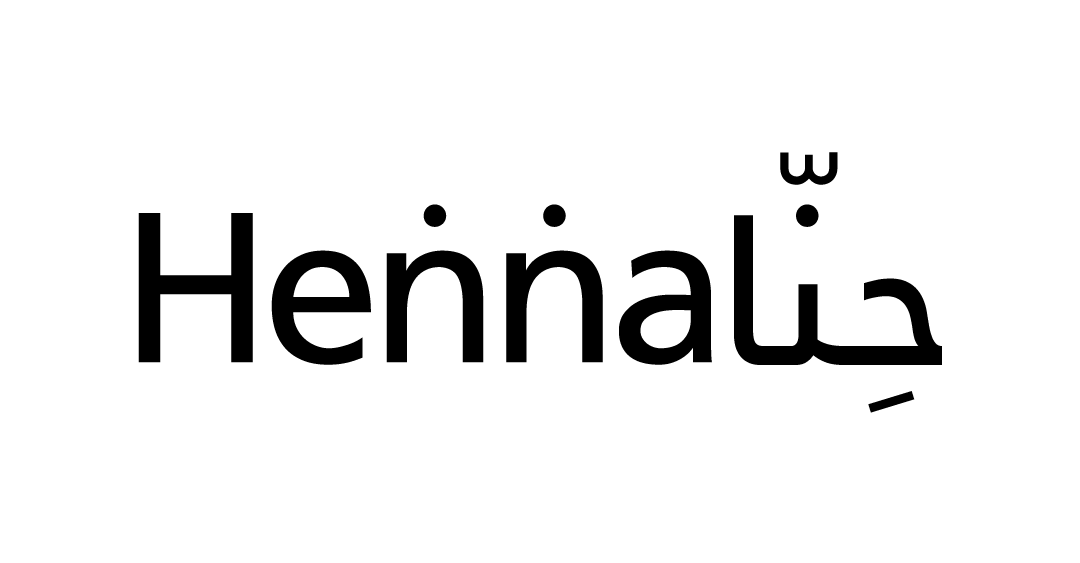النظر إلى موطئ القدم
جمال منصور
مرشح لنيل درجة الدكتوراة في العلوم السياسية في جامعة تورنتو.
مرّت ١٠ سنوات على اندلاع الثورة السورية التي بدأت بمظاهرات سلمية مدنية ومفعمة بالأمل، ترفع لواء قيم الحرية والعدالة بعد عقودٍ من حكم ديكتاتوري فرداني وحشي خنق كل مساحات العمل والتفكير الحرّ، إلى حلقةٍ مفرغةٍ من الوحشية المطلقة التي أخذت في ركابها السوريين بأكملهم. لقد عشنا أسرى في ظلّ نظام الأسد. كانت حياتنا في ظل هذا النظام أشبه ما تكون بالحياة في سجن “تدمرٍ” كبيرٍ، في بلد-معتقل، عرّضنا فيه سجّانونا إلى أدنى وأحطّ أصناف الإذلال بصورة يومية ومتكرّرة، وعاملونا بوحشيةٍ، وأساؤوا إلينا. لم نشعر مرةً بأننا مواطنون، بل كان يتمّ إشعارنا بأننا محض متاع—بأننا معتمدون كلياً على أهواء ومصالح “قادتنا” الفاسدين وعديمي الضمير. وحين نزلنا إلى الشوارع للتجمّع، فعلنا ذلك لأن جميع منافذ السياسة كانت قد سُدّت في وجوهنا ولأننا لم نكن قادرين لا على التواصل بحرّية، ولا النقاش والحوار المفتوحَين، ولا المشاركة في السياسة. لم تكن هناك “سياسة” يمكن الحديث عنها في سوريا الأسد: فما كان هناك إلا فرع للأمن السياسي من ضمن أجهزة المخابرات المتشعّبة، مصمّماً بالتحديد لاستئصال أيّ مظهرٍ ولو كان ضئيلاً للتفكير الحر أو للعمل الفردي أو الجماعي.
كانت لحظة اليقظة مفاجئة وغير مخطّطٍ لها بالمرّة، ولم تأتِ كصدمةٍ لسجّانينا فحسب، بل لنا أيضاً. فحتى لم نكن قبل ذلك نجرؤ على مجرّد التفكير حتى في ذلك الذي ما كان يمكن تصوّره في سوريا الأسد قبلذاك: مجرّد التفكير في أننا كنا أفراداً أحراراً يتمتّعون بالأهليّة والإرادة الحرّة، وقادرين على صنع أقدارنا بأيدينا. سرعان ما أدركنا أننا لم نكن نؤكد سيادتنا على مساحاتنا الخاصة، وعلى حيواتنا الخاصة، وتطلّعاتنا الخاصة فحسب، بل كنا نؤكد على انتمائنا، قولًا وفعلًا، إلى الإنسانية بصورةٍ أعمّ وأشمل، إلى تلك القيم الإنسانية العامة التي جوهرها النضال لامتلاك الحرّية والكرامة. ومنذ الأيام الأولى للثورة مددنا أيدينا إلى العالم خارج “بلدنا الرهيب” (كما يصف عنوان الفيلم الوثائقي المنتج عام ٢٠١٤ سوريا في ظل حكم الأسد)، بحثًا عن روابط التضامن الإنساني والعون الإيجابي الهادف. كنا نفترض، بسذاجةٍ ربما، أننا بمجرّد بدئنا في استعادة بلدنا من براثن هذا النظام الشنيع، فسنجد أيدي العالم ممتدّةً صوبنا لمساعدتنا على تغيير بلدنا من الداخل، لكن هذا التضامن لم يتحقّق قطّ. لقد تُركنا معرّضين ومكشوفين، نواجه وحدنا آلة بطشٍ وحشيةٍ ومجهّزة جيداً لمهمتها في قمعنا، وجاهزةً لضغط الزناد.
لنا الحق أن نشعر بالغضب والخيانة. فلم يُنظر إلينا أبداً على أننا بشر متساوون، بل اقتصرت النظرة إلينا من حلفائنا المفترضين كإحدى فئتين من “الرعايا”. فقد كنّا إما رعايا ما-قبل-حداثويين على مبدأ “صراع الحضارات” لصاحبه صامويل هانتيغتون؛ نظرةٍ اختزلتنا إلى رعايا قبليين غرباء، “آخر” مصمتٌ ومتجانسٌ، كائنات مختلفة وخطيرة. وكأننا، إذا تُركنا لخياراتنا الخاصة، سنعطل تقدم الحداثة، ونخرج أسوأ أشباح العصور المظلمة البائدة من قبورها. أو كان يُنظر إلينا، من وجهة النظر الأخرى، على أننا كتل من المهاجرين المدفوعين بدوافع اقتصاديةٍ صرفة. وبموجب هذه النظرة، فقد أصبحنا مادةً للصراعات الداخلية في مجتمعاتنا المضيفة الجديدة، يُنظر إلينا كمتلقّين بالكامل لكرم وشهامة هذه المجتمعات المضيفة ولمساعداتها الإنسانية، والتي يتوجّب علينا، بالتالي، أن نفتح بصمتٍ أيدينا لتلقّيها، وأن نندمج بامتنانٍ دون إظهار تميزنا الثقافي الخاص الذي من شأنه زعزعة السلم الأهلي في هذه المجتمعات. أو أن يُنظر إلينا بوصفنا تهديداً بالكامل لهذه المجتمعات المضيفة: كتلة كتيمة ظلامية، خبيثة، ضارةً بصورةٍ جوهرانيّة، ورماً في حاجةٍ ماسّةٍ ودائمةٍ إلى الاستئصال، تماماً كما يجري الآن بحق اللاجئين السوريين في الدنمارك، الذين أُلغيت تصاريح إقامة بعضٍ منهم على أسسٍ واهيةٍ تقول إن سوريا باتت بلداً آمناً. بات هؤلاء اللاجئون تحت خطر الترحيل إلى سوريا نفسها، التي تنتظرهم فيها أجهزة المخابرات التي أرعبتهم زمناً بأذرعٍ مفتوحة لتعيد اعتقالهم أو لتخفيهم إلى الأبد، ربما!
لذلك كله، من المفهوم مع كل هذا الإحساس بالخذلان وخيبة الأمل، أن يكون السوريون وسواهم من أبناء الشتات العربي مرهقين ومتعبين من عالمهم. أضف إلى أنهم بالكاد بدؤوا في العثور على مكانهم في بلدانهم الجديدة، فقد بدؤوا بتعلّم اللغات الجديدة، والتكيّف مع أماكنهم وأعرافها الثقافيّة الجديدة عليهم، وبمسيرة التعليم لهم ولأطفالهم، وبالعثور على وظائف وأعمال غير تلك التي أوقفتها ملحمة الهجرة القسريّة. يُضاف هذا المزيج إلى تاريخٍ طويلٍ من الصدمة والتشتّت والخوف من الجميع ومن كل شيء اضطرّوا إلى العيش فيه في ظل دولة بوليسية طاغية على سوريا الأمر الذي يجعل الثقة بالنفس والآخرين، وبالتالي العمل الجماعيّ، مرهقاً للغاية ومن الصعب تحقّقه. والثقة، على وجه الخصوص، هي حجر الأساس في كل عملٍ جماعي، وفي المشاركة العامة، السياسة على وجه الخصوص. رغم كل ما سبق، أزعم أن هذه الصدمة التاريخية وخيبة الأمل على وجه التحديد هي التي يجب أن تدفعنا أكثر نحو المشاركة الهادفة في القضايا العامة، والسياسية منها بالتحديد. نحن بحاجة لئلا نسمح مرة أخرى بأن يتمّ تهميشنا واستبعادنا وتفتيتنا والاستفراد بنا. نمتلك ثروة من الإمكانات في بلداننا الجديدة: لدينا قوانين وأعراف وديمقراطية. والأهم من ذلك، مساحات وأدوات اتصال متطوّرة ومتاحة.
لدينا، كذلك، الحقّ في التجمّع وفي مناقشة وصياغة ونشر الأفكار، بعيداً عن النزوات الوحشية لأنظمتنا الباطشة. كما أننا نملك المصلحة: ليس فقط الاندماج في مجتمعاتنا الجديدة ودرء الكراهية الموجّهة صوبنا؛ بل، وكذلك لمساعدة بلادنا، وللاستفادة من وجودنا ونشاطنا في بلداننا الجديدة. بوسعنا المساعدة عبر الجهر بقضايانا، والضغط لاتخاذ إجراءات في حال انتهاك حقوق الإنسان أو تعرّضها للخطر في بلادنا. لا نملك رفاهية التقاعس. بل علينا التزاماً تجاه أنفسنا، وبدرجةٍ أكبر تجاه بلادنا الممزقة، بأن نتصرّف ونشارك ونبذل قصارى جهدنا لتعبئة مواهبنا الفردية وقدراتنا للعمل الجماعي الهادف. لعلّه قدرنا أن نفعل.