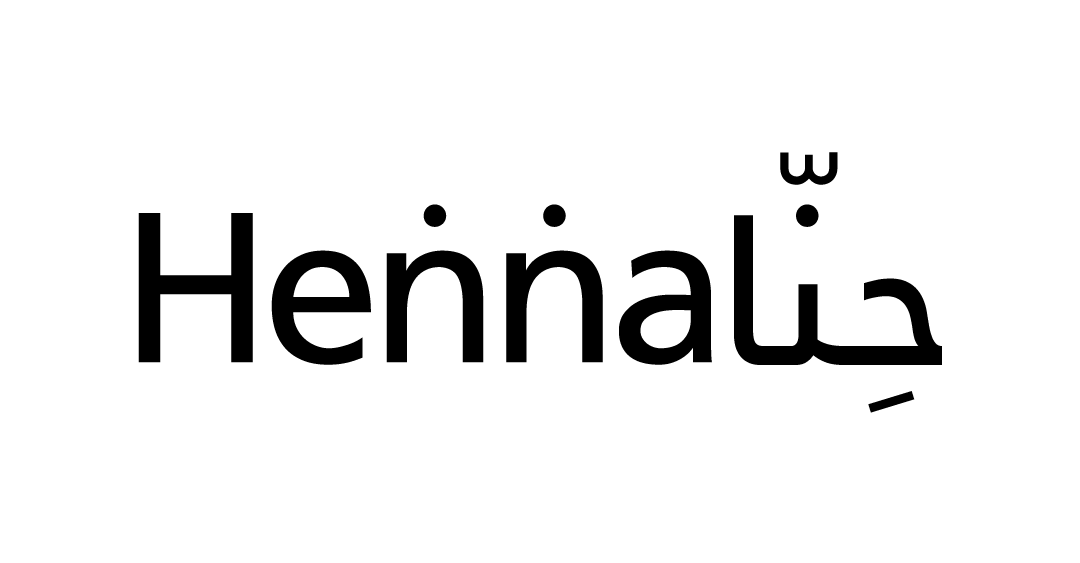رغبة الثورة ما بين دمشق وبيروت
هشام الهادي، اسم مستعار
بيروت، مدينة كُتب عنها كثيراً، المدينة الصغيرة الواسعة والتي لطالما كانت الملجأ الأول للمنفيين السياسيين السوريين، مدينة البحر، ذات الأفق الأزرق الكبير المرتبط بصورتها البصرية.
ولأن تجربة العيش في بيروت هي مرحلة هامة لمن يريد أن يصبح فناناً ( مثلما كان يقول لي والدي دائماً)، فقد كانت مثل بوابة لأحلام كثير من الشباب في دمشق، مدينتي.
ولكن كيف تبدو بيروت اليوم، بعد الانهيار الاقتصادي، والثورة المهزومة، والانفجار الكبير؟ هل ما تزال باستطاعتها احتواء المنفيين السوريين منذ 2011؟ وهل تتسع لمنفيٍّ آخر؟
التشوه الأجمل لجدران المدينة
انتقلتُ من دمشق إلى بيروت مؤخراً لعدم قدرتي على تحمل المزيد من الخيبات والضغوط في دمشق، قررت أن أبدأ سلسة خيبات جديدة في مدينة أخرى، علّها تمنحني مزيداً من الوقت الزائف في هذا العالم البائس. أنا الذي أسعى الآن إلى أن أكون فناناً مسرحياً، جئت إلى بيروت محتفظاً بكلمات والدي عن التأثير الذي ستكشفه هذه المدينة في حياتي كفنان. لم يكن البحر والأفق الأزرق أول ما لفت انتباهي فيها، إنما شعارات الثورة على جدرانها “الثورة مستمرة”، “كلهن يعني كلهن”، “ثورة”. تصارع إحساسي باللاجدوى والبؤس مع رغبتي بالتعرف على شوارعها، فصارت عيناي غابات ملونة تكتسح برودة المدينة. كانت شعارات الثورة المتبقية على الجدران هي أول ما وقعت عيني عليه حقاً في بيروت، وقد حركت في داخلي من جديد مشاعر الرغبة بالانتفاض التي اعتقدت أنها ماتت منذ زمن. لطالما اعتبرت أن شعارات الثورة على الجدران هي التشوه الأجمل لصور مدننا البصرية المختبئة خلف قناع الحضارة، المعلَم الأول من معالم جماليات الفوضى، والتمرد على الأنظمة القمعية بأسلوب وقح مباشر يشكل وجهاً حقيقياً من أوجه المدينة المتعددة التي أرغب بالتعرف عليها.
ملأت هذه الشعارات قلبي وعيني، لأننا في دمشق كنا نلتفت إلى بقايا شعارات ثورتنا المهزومة بخجل وخوف وقد مُحيت واستبدلت بأخرى وحشية تؤكد هزيمتنا وتذكِّرنا بها يومياً، مثل شعار “الأسد أو نحرق البلد”، “حاربوك ونسيوا مين أبوك”، أو استبدلت بصور أيقوينة لبشار الأسد أكلت معالم المدينة وشوهت صورتها.
أما هنا في بيروت فتُذكِّر تلك الشعارات الناس دائماً بالثورة، عندما عبّروا يوماً عن غضبهم، وعن الهيئة التي يريدون لبلادهم أن تكون عليها.
ازداد شغفي بالتعرف على هذه المدينة وناسها، وفهم ما تعنيه أن يكون باستطاعة مدينة ما تذكير سكانها دائماً بأنها في ثورة مستمرة. أشعلت فكرة عملي في المسرح هنا حماسي، وأسئلة عن بقاء معالم الثورة رغم هزيمتها، وعن طبيعة هذا المنفى الذي جئت إليه.
بين الألفة والغربة
أتذكر أول سيارة أجرة أستقلُّها في بيروت، متجهاً إلى البروفا الأولى لي، تحدث سائق السيارة عن الوضع الاقتصادي الخانق في البلاد. ذكرني بأحاديث سائقي سيارات الأجرة في دمشق، والتي لطالما اعتبرتها إحدى علامات الهزيمة.
في دمشق، كنت دائماً ما أخوض في هكذا أحاديث، أبرع خلالها بالألاعيب الذهنية والمراوغة والأسئلة حيث تنتهي دائماً بارتياب السائق مني، ولكنها بالنسبة لي تترك شعوراً مرضياً وممتعاً. أما هنا في بيروت فلم أتجرأ بنطق كلمة، بل حاولت جاهداً أن أخفي عن السائق لهجتي السورية، دون أن أفهم شعوري تماماً في تلك اللحظة، الذي كان ممزوجاً بين ألفة وغربة في آن واحد.
دخل السائق في شوارع فرعية كثيرة متفادياً أزمات السير، بدأت أرى الشوارع بشكل أوضح. ها هي شعارات الثورة مرسومة على الجدران ومختطلة بصور لساسة وقادة كثر، شاهدت صورة لقائدين عسكريين كُتب عليها “دام رُعبكم”، وكأنهما يحدقان بي بعيون سوداء كلياً، في الوقت الذي كنت أحاول إدراك ماهية الصورة، هل هي جديّة أم تهكمية؟ هنا بدأت بإدراك تعقيد أوجه المدينة وصعوبة الوصول لحقيقتها.
ما بين الثورتين، السورية واللبنانية
عاش كلا البلدان (سوريا ولبنان) ثورة في هذا القرن، بفارق ثماني سنوات تقريباً بينهما. ومع اختلاف معطيات وتحولات ومفردات الثورتين، وأساليب عقاب وقمع السلطات للثوريين، كانت الهزيمة مصيراً مشتركاً لهما، هزيمة يمكنك أن تشعر بها على مدار الساعة في التفاصيل اليومية الحياتية فيهما.
لا يمكن بالطبع اختصار ما حدث في الثورتين ببضعة أسطر. لكن يمكننا القول إن ما جرى كان محاولتَي رفض في منطقة أقسى من أن تقبل أي رفض. وكأن الهزيمة هي النتيجة الوحيدة الممكنة للثورتين. تعيش مصر اليوم مع الحكم العسكري مجدداً، أما تونس فتقبع تحت حكم دكتاتور يعتقد أنه يمثل الثورة بشخصه، ناهيك عن الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا. كل هذا ولّد لدي صراعاً آخر، ما بين رغبة الاستمرار في الأمل بالثورة وحتمية الهزيمة، ما بين شعارات الثورة التي تجعل من قلبي ملوناً، وصور الدكتاتوريات والعسكريين التي تجعل عيوني بيضاء.
لكن الثورة فعل مستمر لا يمكن أن يتوقف بعدم تحقيق أهدافها، هي حتمية مع حتمية وجود السلطة القمعية، كما أن فعل الثورة لا يقتصر على ثنائية الانتصار والهزيمة، بل إنه وعي متراكم في التجربة الثورية التي لا بد لها أن تحقق جدواها يوماً ما. من غير الممكن للبهجة التي شعرت بها عندما رأيت الشعارت أن تكون بلا جدوى، كما لا يمكن أن تقتصر أحلامنا وآمالنا ورغباتنا على شكل شعارات على جدران مرئية أو ممحية. ليس من المعقول أن نتحول إلى عبيد اللاجدوى التي تخلِّفها الهزيمة، ولهذا نحن اليوم مصرون على الكتابة والتوثيق، مصرون على تقديم الفن، وعلى أن نحتفظ بقصصنا وتوجهنا وفعلنا، و بتداعيات هزيمتنا أيضاً.
المسرح وحتمية الثورة
أقمت أول عرض مسرحي لي في مسيرتي الاحترافية ككاتب/دراماتورج، في بيروت، حاولت أن أخلق علاقة مع هذه المدينة حسب مقولة أبي عنها، يتحدث العرض عن الموت وكيف يمكن أن يكون وقعه علينا، نسأل فيه لماذا ننتحر ، وكيف لنا أن ننقل خبر الموت وكيف لنا أن نتقبله.
لكن جنون هذه المدينة ما بين أحلام الماضي وعبثية الحاضر ظهر لي قبل موعد افتتاح عرضنا بأسبوع. كان المسرح الذي سنعرض به في منطقة الطيونة في بيروت، المنطقة التي شعلت فيها بوادر حرب أهلية لمدة ساعات إثر مظاهرة لإقالة قاضي التحقيق المسؤول عن قضية انفجار المرفاً (حدثت في 14 أكتوبر 2021).
اشتعلت هذه الأحداث قبل أسبوع من افتتاح عرضنا، أتذكر كيف كنت متجهاً نحو المسرح عندما بدأت سماع أصوات صراخ متبوع بأصوات إطلاق رصاص كثيف، عدت من منتصف الطريق خائفاً من رصاصة عشوائية قد تنهي حياتي، وصلت إلى المنزل وبدأت متابعة الأخبار وأنا أسمع أصوات الرصاص بينما أتحدث في الموبايل مع صديقي ومخرج العرض الذي كان في مسرح الطيونة محاصراً لأربع ساعات.
صوت الرصاص عال جداً ومستمر. ما أدهشني هو تسارع الأحداث في هذه المدينة، أشعر بالخوف ولكن لا أشعر بأنني معني بطريقة مباشرة، فقد صدف لي ولأصدقائي السوريين أننا نعمل على مسرحية عن الموت في منطقة اشتعلت فيها بوادر حرب أهلية في لبنان بطريقة مفاجئة وغير متوقعة، خشيت على مصير عرضنا ضمن فوضى داخلية كهذه، تساءلت عن مصير الكثير من السوريين خلال انفجار المرفأ، والذين لم يكن تعنيهم سوى نجاتهم اليومية، ولا متسع لهم في مفاصل الحكاية، وكيف كانت هذه المدنية(المنفى) مع هؤلاء المنفيين وهي تقتل أبناءها بعبثية مطلقة، كيف أن وحشية المدينة لا تهمها جنسية المقتول، ولكنها ترسم طريقة نقل الحكاية وتضع أسساً لأحقية الغضب.
استطاع صديقي المحاصر الخروج من الطيونة هارباً عبر طرق فرعية، وصل إلى المنزل لاهثاً يطلب ماء يشربه، سكنتُ في مكاني لوهلة، نظر إليّ بعيون مليئة بالتحدي والخوف والقلق وقال لي: “تذكرت سوريا”، حاولت حبس دموعي في اللحظة التي شعرت بها بتوقف كلي لهذا الكون من حولي.
نعم مصائرنا مرتبطة، أشكال الموت والعنف والهزيمة مختلفة، لكننا نعيش الجوهر ذاته.
تمكنا من افتتاح عرضنا في موعده المحدد، ولكن لم يستطع أحد القدوم في أول يومين، فالمكان كان مليئاً بالعسكر والسلاح والحواجز، يغمرنا شعور بالإحباط، بالخوف، بالحزن والغرابة ونحن نمشي يومياً أمام المئات من العساكر النائمين والمتأهبين، المتحمسين والغاضبين والملولين، لكي ندخل إلى مسرحنا الفارغ، لم نستطع منع أنفسنا من الشعور أننا هُزمنا مرة أخرى.
في الأيام التالية بدأ الناس بالقدوم، وأصبح حضور مسرحيتنا تجربة كاملة متعلقة في القدوم إلى مكان لم تجف فيه الدماء أو يُنظف من حوله الركام بعد، مسرحية تسأل عن قبول الموت تُعرض في مكان عاش الموت بطريقة عبثية قبل أسبوع فقط، لا أعرف ما الذي دفع الناس إلى القدوم إلى هذه المنطقة الخطرة لحضور مسرحية، لا أعرف ما الذي دفعنا نحن لإكمال مسرحيتنا في هكذا ظروف. فمع وصولنا إلى اليوم الأخير من العرض كانت الصالة ممتلئة بالحضور.
لست موقناً فيما إذا كانت مسرحيتنا قد حققت لدى الجمهور شيئاً من جدواها . لكنني أعرف أنني ممتن لبيروت التي قدمت لي تجربة غنية دفعت بخطواتي قدماً في المسرح. أنا المنفيّ وجدت مكاناً داخل هذه المدينة المجنونة، ومتسعاً لي لأحاول أنا وغيري من الرافضين الخوض في هوامش الحرية الخاصة فقط بهذا المنفى، بيروت.
لكن عيني ما تزال على دمشق، التي ما تزال تشهد محاولات لإنشاء مسرح مستقل فيها رغم ضيق المساحة وهوامش الفعل، أتابع هناك أصدقائي الشابات والشبان الذين يحاولون يومياً وبأقصى ما يمكنهم صناعة مسرح خارج عن إيديولوجيات النظام وخطابه أحادي البعد، أتابع أخبار العروض التي تقام في أماكن بديلة وصالات خارجة عن المؤسسة الحكومية التي تعبر عن رفض ومقاومة لكل القسوة العبثية التي ملأت دمشق الآن، حالها كحال مبادرات الرفض الموجودة في السويداء ودرعا. الغضب في دمشق ما يزال موجوداً حتى وإن كان خارج الساحات، لأن الرفض ليس مرتبطاً بالأمل، بل إنه فعل الثورة المستمر، وهو قيمة وجدوى وجودنا، ورغبتنا الدائمة والحقيقية بالمضي بثورتنا.