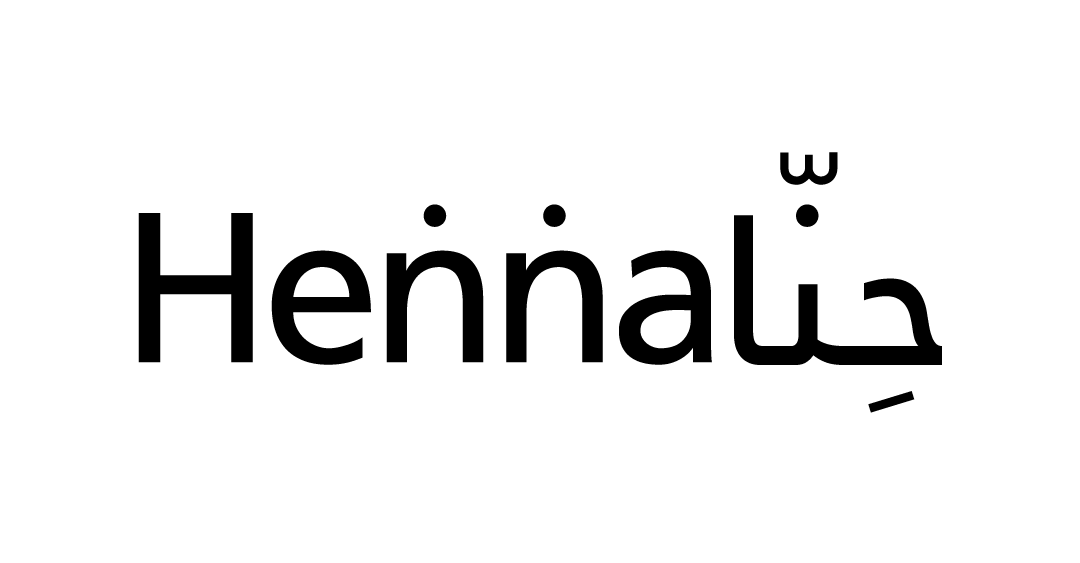خطى بطيئة في تورنتو
محاولات لترميم الذاكرة في آخر محطات اللجوء
عُلا برقاوي، كاتبة وصحفية فلسطينية-سورية مقيمة في تورنتو.
توقعتُ لقدَرِ هذا النص بأن يأتي مبكراً. قلتُ إنه سيُبصر النور بعد فترة وجيزة من وصولي إلى تورنتو، حكايات الأصدقاء وصورهم على إنستغرام أنبأتني بأن أسابيع قليلة هنا تكفي لخوض تجارب غنية تخلق نصاً عن المدينة التي انتظرت سنوات الوصول إليها، ووعدتَني بأنها ستكون محطة هبوطي الأخيرة.
يبدو أنني كنت مخطئة بالقدر الذي ظننت فيه أن سنوات الانتظار والبحث ومحاولة إيجاد الإجابات على أسئلتي الكثيرة عن تورنتو قد أعدّتني جيداً لما قد ينتظرني فيها. أفهم الآن جيداً بأن عليَّ إزالة كل تلك التوقعات والإجابات من رأسي، لأملأه بما يقدمه الواقع من جديد.
أنا فلسطينية لم ترَ فلسطين يوماً، ولدتُ في سوريا وعشت سنواتي الثلاثين الأولى لاجئة فيها، قبل أن تبدأ الثورة السورية. حملتُ وثيقة سفري المؤقتة وبدأت رحلات لجوء أخرى تضمنت أربع مدن، أبو ظبي فبيروت فالمنامة فاسطنبول، أبحث في كلِّ منها عن مُستقر. أعطتني تلك البلدان تأشيرات دخول إليها بصعوبة، وبشرط ألا أقيم فيها دون دفع أثمان باهظة، فهي لن تمنحني الشعور بالأمان الذي يسمح لي بالعيش فيها أكثر من عام. لازمني القلق في رحلة اللجوء المتتالية تلك 7 سنوات من المفترض أنها انتهت لدى وصولي إلى تورنتو.
أسأل صديقاً أمشي معه في شارع أوزنغتن: ”أين نحن الآن؟“، يجيب مستغرباً: ”هذه حارة منزلك!“.
يدور هذا الحديث مراراً بيني وبين أصدقاء أمشي معهم متجهين نحو منزلي. ستعلو الدهشة وجوههم عندما أقول إنني لا أعرف التجول وحيدة في تورنتو بعد، وأجل، حتى في المنطقة المجاورة لبيتي. وسوف يتحول هذا الموقف المتكرر إلى نكتة متبادلة بينهم عن تلك التي ما تزال غريبة عن حارتها.
بدلاً من وصل حبال الودِّ مع الشوارع والعناوين ووسائل المواصلات في أول مدينة تسمح لي منذ عشر سنوات بمحاولة الاستقرار فيها إلى ما يحلو لي من السنوات، صار تطبيق أوبر في تورنتو امتداداً لتجاربي معه في مدن سابقة.
مقهى وحيد ارتدتُه بضع مرات لا يبعد سوى مئة متر عن منزلي، ومركز تسوق أمِّيزه كأحد العلامات القريبة لعنواني. إذاً هي ثلاثمائة متر إلى الغرب فقط، تشكل أبعد مسافة يمكنني التنقل فيها دون الاستعانة بخرائط غوغل، أو بأوبر، أو بأصدقاء.
بضعة أمتار تبدأ من شرفة منزلي المطلة مباشرة على الشارع، سوف تستقبلني فيها لسعة هواء باردة تجفف عينيَّ وأنفي وحلقي. ستأخذني درجاتها السبع التي صارت طبقات الثلج المتراكمة على جانبيها جزءاً من تكوينها، لأمشي بحذر على الرصيف المتجلِّد منذ شهرين، وأحيِّي سائق الأوبر الذي سيقلُّني إلى وجهاتي المعتادة.
وسائل النقل العامة في تورنتو هي كمخلوق لا أعرف ماهيته يتربَّص بي، ينقر بأصابعه على جبهتي ليوقظني من سبات سنوات طويلة أبَت فيها المدن الأربع أن تستقبلني بصدر رحب. بادلتُ تلك المدن النفور أنا أيضاً، ووعدت كل واحدة منها بالمغادرة في أقرب فرصة وبأنني لن أتعلق بها مهما كان مقدار السعادة التي ستمنحني إياها، وأشحتُ بوجهي عن يد صلح قد تمدُّها نحوي خلال لحظات نسيَت فيها بأنها يجب أن تقسو علي.
إنها لعنة المؤقت لمن وُلد لاجئاً. يعتنق الطفل الفلسطيني اللاجئ خلال نشأته كل الأفكار التي تدافع عن حق عودته، دون آمال مؤكدة أو خط زمني واضح لتلك العودة. سيشاهد كلَّ من تمسَّك بهذا الحق وهو يموت حاملاً معه ذاك الحلم. قد يُجبر على اللجوء مجدداً، وقد يحصل على تأشيرات أو إقامات في بلدان أخرى، لكنها ستكون موسومة دائماً بالمؤقت. ستحتجزه المطارات وسينتظر على الحدود ساعات. سيتفحص موظفوها أوراقه وملامحه طويلاً. سيؤسس حيوات عدة قد تنتهي بقرار يمنعه من الإقامة بين ليلة وضحاها. سيلازمه ذنب اللجوء، وسيطرق أبواب سفارات بلدان العالم الأول التي قد تمنحه جنسية تُحيل حق العودة إلى فلسطين، إلى رغبة في زيارتها.
تورنتو هي المدينة الأخيرة. جئتها قبل أكثر من خمسة أشهر، ويبدو أنها ليست مثل سابقاتها، فهي تفتح ذارعيها لي، لكنني ما أزال لا أجرؤ على الاقتراب.
في سيارة أوبر، وفي مسافة لا تتجاوز 10 دقائق. أحاول تجاهل وسائل النقل الأخرى التي تبدو مريحة، غير مكلفة كثيراً، ومتوفرة. يكفيني أنني مجبرة على تقييد نفسي بارتداء طبقات عدة من الثياب ومعطف سميك ووشاح وكفوف صوفية تمنعني عن الحركة وتشتت ذهني عن الانتباه للطريق. يحدث هذا قبل أن ألمح الجسر الصدئ -أو ربما هذا هو لونه- الذي لا أعرف اسمه أو اسم المكان الذي يقبع فيه بعد، لكنه علامة أخرى أميزها في تورنتو حتى الآن، والتي تخبرني أنني في الطريق الصحيح.
لا شوارع المدينة الساكنة ولا قاطنوها بلطفهم البالغ يشبهون أي مكان سكنته أو مجتمع عشت بين أفراده. لا شيء يشد انتباهي هنا سوى رسوم الغرافيتي البديعة على الجدران أينما التفتّ. ولا تساعدني المحال والبنوك واللافتات المتشابهة المتوزعة في كل شارع على التمييز فيما بينها مهما حاولت أن أفتح عيني على اتساعهما. بجميع الأحوال، ها أنذا أقترب من المبنى الشاهق المشرف على البحيرة متفرداً في علوه وسط المنازل العادية. فأبتسم لعلامة ثالثة أميزها في تورنتو.
بمقدور هذه المدينة مع كل من أعرفه فيها أن يمسكوا بيديَّ ويدفعونني إلى الأمام. يقولون لي امضي في الطريق الذي تشائين. تورنتو تعاملني كما أحب، لكنني بدلاً من أن أفتح عيني وأوجِّهها إلى المدى المفتوح، أفضل إنكار المتعة التي تمنحني تورنتو إياها عندما تستقبلني باسمة. إنها كمرآة تعكس صوراً قاتمة متلاحقة لما تركته المدن السابقة في ذاكرتي. صور لطالما كنت أخشى استحضارها، رسَّخت في شخصي صفة اللاجئة حتى ظننتُ أنني سأبقى أحملها ما حييت. أضيع في دوامة إدراكي بأن كثيراً مما حدث خلال عقود كاملة قد كان غير منصف، وبأن عليَّ في الوقت ذاته أن أعيد إغلاق تلك العلب المهترئة في ذاكرتي بإحكام وأمضي قدماً.
وكأنني تعودت على الوداعات والتخلي حتى صار الجفاء وقسوة القلب مساراً هيِّناً وواضحاً لن يترك الكثير من الندبات. وكأن الأحمال مهما ثقلت ستكون خفيفة على الأكتاف. تتالى الأسابيع وألوم نفسي مرات على الوقت الذي يمر دون تقدم يذكر، أحاسبها أحياناً لأن لا حجة لدي هنا في التلكؤ. تنتهي الأشهر الخمسة الأولى وأنا أحاول تجاهل الكمِّ الهائل من المعوقات التي قد تواجه أي قادم جديد. وعندما يسألني أحد عن حالي في أول أشهر أقضيها في تورنتو، فإنني أكتفي بالقليل من إظهار الضيق ورسم ملامح متذمرة على وجهي دون إسهاب.
ربما ستمر سنوات أخرى أراوغ فيها ما استطعت لأجد الوقت للوقوع في حب تورنتو. ستمدُّ هي الأخرى يدها لي، ولن أشيح وجهي عن بادرتها حينها. ستكون قد غفرت لي كل الجفاء الذي أظهرته لها. ربما ستنتظرني حتى أستبدل كل ذكرى قاسية بأخرى أقل قسوة. سأغفر لها أنا أيضاً لأنها أنستني للمرة الأولى منذ سبعة عشر عاماً ذكرى وفاة والدي، لكنها زادت من لقاءاتي به في أحلام أستيقظ منها مذهولة وخائفة ومشتاقة له. سأغرم بتورنتو رغم أنها بعيدة وتجبرني على إغفال ما يحدث في سوريا الآن، لكنها أيضاً تفكُّ الالتباس الذي ملأ وعيي لسنوات عن الانتماء. أبعدتني تورنتو كثيراً عن دمشق التي لن أعود إليها حتى سنوات لا أجرؤ على توقعها. لكنها بعد قليل ستمنحني ممراً إلى فلسطين، لزيارة كانت مستحيلة الحدوث قبل خمسة أشهر.