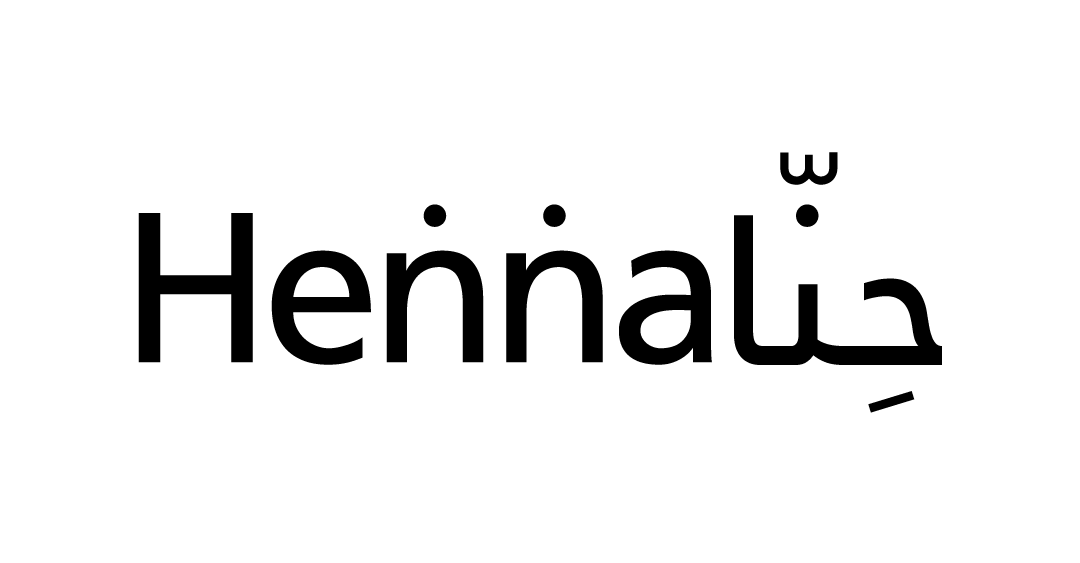جرح الكيماوي لم يندمل
سلام السعدي
كاتب وصحفي مقيم في كندا. يدرس حالياً الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة تورونتو.
تمر في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الذكرى السنوية الثامنة على تنفيذ النظام السوري هجوماً بالسلاح الكيماوي على غوطة دمشق الشرقية في العام 2013. ذهب ضحية الهجوم أكثر من 1500 من المدنيين، وهو ما جعله الهجوم الأكبر منذ استخدام صدام حسين للسلاح الكيماوي في حلبجة ضد الأكراد. أظهر الهجوم ما يعرفه واختبره السوريون جيداً بما يخص الطبيعة الطغيانية للنظام السوري والمدى الذي يمكن يذهب إليه في سبيل الحفاظ على السلطة. كما كشف حقيقة الموقف الأمريكي والدولي من المسألة السورية والذي شكل أحد عوامل امتناع التغيير والمحاسبة.
في “عقلانية” استخدام الكيماوي
في حين وجهت الدول الغربية أصابع الاتهام للنظام السوري، أنكر الأخير الأمر برمته قبل أن ينتقل لاستراتيجية اتهام المعارضة باستخدام السلاح المحرم دولياً. وشاركه في ذلك روسيا وناشطون وأكاديميون يساريون رفضوا اتهام النظام بالقيام بعمل لا يبدو “عقلانياً” عند وضعه بميزان التكلفة والخسارة.
أظهر ذلك الفجوة الواسعة بين ما يعرفه العالم عن النظام السوري وبين التجربة المعاشة للسوريين الواقعين تحت حكمه. كان النظام قد استخدم السلاح الكيماوي عدة مرات قبل هجوم الغوطة وتجنب ردود الفعل الدولية ووجد أنه من السهل التعايش مع إجراءات بيروقراطية تقتصر على إرسال لجنة تحقيق كانت تعمل في دمشق عندما وقع هجوم الغوطة.
الحقيقة التي يتجاهلها المتعجبون من استخدام السلاح الكيماوي باعتباره عملاً مجنوناً يتناقض مع مصالح النظام هي أن الأخير استخدم هذا السلاح في 336 هجوماً خلال سنوات الثورة. حدثت جميعها بعد إعلان باراك أوباما عن “الخط الأحمر” الشهير في شهر آب من العام ٢٠١٢. وجد التقرير الذي أحصى تلك الهجمات أنها استهدفت بصورة رئيسية المناطق السكنية وليس جبهات القتال، وهو ما يجعلها جزءاً من استراتيجية العقاب الجماعي التي اتبعها بشار الأسد. بعد استخدام غاز السارين في هجوم الغوطة، قرر النظام التحول لاستخدام غاز الكلورين وذلك بسبب سهولة تصنيعه واستخدامه دون الحاجة لتكنولوجيا وبنية تحتية معقدة (تستخدم البراميل المتفجرة والصواريخ لإطلاقه)، فضلاً عن كونه أقل فتكاً، ما يقلل من ردود الفعل الدولية.
لم تعتمد استراتيجية الأسد على كسب ثقة السكان في مناطق المعارضة عبر عقد الاتفاقات والتسويات او تزويدهم بالخدمات، وإنما على جعل حياتهم لا تطاق عبر القصف اليومي للمشافي والمدارس والأفران والأسواق والأحياء السكنية لمنع إمكانية قيام أي حكم أو استقرار في المناطق الخارجة عن سيطرته. وفي ظل معاناة النظام من نقصٍ حادٍ في القوة البشرية والتكنولوجية، كانت البراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي أحد أعمدة تلك الاستراتيجية. وقد اكتسب هذا السلاح أهميةً أكبر بسبب خسارة النظام للأرض وحاجته الماسة لإثبات وجوده في المناطق المحررة عبر استمرار الموت والدمار. كان الموت بالبراميل المتفجرة واختناقاً بالكيماوي أحد أشكال إثبات “السيادة” على الأرض المحررة.
يبدو هذا المستوى من العنف والإبادة، إذن، عقلانياً للغاية. وكما أشار ياسين الحاج صالح إلى أن السجين السياسي ليس استثناءً في سوريا بل هو “المعيار العام“، فإن مجزرة الغوطة ليست استثناءً لا عقلانياً أو خطأ وسلوكاً متهوراً، بل تمثل أحد مستويات العنف والإبادة الضرورية والعامة للنظام باعتبارها أداة حكم استخدمها منذ وصوله للسلطة. لا يهدف العنف إلى إقصاء المخالفين وإبادتهم فقط، بل إلى تأسيس وإعادة تأسيس مستمرة للحياة السياسية في سوريا ولمخيلة المحكومين حول حاضرهم ومستقبلهم وحول قوة وبطش نظامهم.
الموقف الدولي والامريكي
يُعتبر منع استخدام السلاح الكيماوي أحد الأعراف الدولية القوية التي جرى احترامها بصورة عامة خلال القرن الماضي بين القوى الدولية بعد الحرب العالمية الأولى. شهدت هذه الحرب مقتل نحو مئة ألف نتيجة استخدام الغازات السامة وهو ما خلف رعباً هائلاً ودفع نحو وجود عرف دولي يمنع استخدام ذلك السلاح. التزمت القوى الدولية بذلك حتى أثناء الحرب العالمية الثانية، أكبر مقتلة في التاريخ والتي شهدت قصفاً وحشياً للمدن واستخداماً للسلاح النووي. رغم ذلك، لم تكن محاسبة النظام السوري أمراً مطروحاً على المستوى الدولي، وهو ما يضيء على الحماية الدولية التي حظي بها النظام السوري على عكس الفهم السائد للعامل الخارجي في المسألة السورية.
في البداية، ظهر استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي كنقطة تحول قد تنهي سلبية الإدارة الامريكية التي كانت تكتفي بدور المراقب للمجزرة السورية تاركة الثورة لمصيرها الدموي. وكانت تبرر سلبيتها تلك بالموقف الروسي الذي عطل مجلس الأمن عن لعب دور فاعل في وقف قتل السوريين والدفع نحو التغيير. ولكن الضربة الكيماوية أسقطت تلك الذريعة، إذ بدأت أمريكا التحضير لتنفيذ ضربة عسكرية دون المبالاة بموقف روسيا وبمجلس الأمن.
بدا إذن أن السبب الرئيسي لامتناع التدخل الأمريكي هو عدم الرغبة بتغيير النظام السوري. شكلت إمكانية السقوط المفاجئ وغير المرتب لنظام الأسد في ظل وجود ترسانته الكيماوية وحدوده الآمنة مع إسرائيل رعبا حقيقياً للإدارة الأمريكية، وكان منع حدوث ذلك هو أبرز أهدافها في سوريا. في آب ٢٠١٣، وجدت الولايات المتحدة نفسها في مأزق. من جهة، لا يمكنها كقوة عظمى أعلنت عن وجود خط أحمر أن تكتفي بضربة متواضعة سوف يفسرها الصديق والعدو باعتبارهاً ضعفاً. وبالمقابل، بدا أوباما على يقين من أن نظام الأسد كان من الضعف بحيث يمكن لضربة متوسطة القوة أن تؤدي إلى إسقاطه.
في النهاية صدر القرار 2118 عن مجلس الأمن في نهاية أيلول (سبتمبر) 2013، والذي أعطى الشرعية للاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة حول انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتدمير ترسانتها مقابل تجنب الضربة العسكرية. هكذا، أظهر الهجوم الكيماوي وتداعيته أن أهم ما طبع السياسة الأميركية في سوريا هو إسقاط خيار الحسم العسكري الذي كان يمكن أن ينهي المجزرة السورية المستمرة حتى اليوم.
نقطة تحول في تاريخ الثورة
عوضاً عن إيقاف جرائم النظام السوري عن طريق تحييد الطيران الحربي الذي كان يدك مناطق المعارضة ويرفع بصورة هيستيرية من أعداد القتلى ويتسبب بالتهجير القسري، قرر العالم إيصال رسالة للأسد ولضحاياه مفادها أنه لا يوجد أفق حقيقي للمحاسبة.
ادعت المقاربة الأميركية أن الحفاظ على وجود “الدولة” يمنع العواقب الكارثية، سواء تلك المتعلقة بـ”الإرهاب” وخصوصاً ما ينتشر منه في الغرب، أو المرتبطة بالكلفة البشرية المرتفعة. ولكن استراتيجية الاحتواء وتجاهل العدالة تجنباً للفوضى والإرهاب أسفرت عن أعلى معدلات الفوضى والإرهاب في تاريخ الصراعات الحديثة في الشرق الأوسط.
ضمنت الصفقة الروسية-الأمريكية استمرار آلة الإبادة الأسدية وسدت كل طرق التغيير أمام الثورة الشعبية موفرة بذلك البيئة الأنسب لنمو الحركات الجهادية وفي مقدمتها تنظيم داعش الذي ظهر في العام 2014. بعد تفتت المعارضة السورية وضعف إمكانيات المعارضة المسلحة وفقدان الثقة بأي قوة خارجية يمكن أن توقف المذبحة، شكلت الفئات الريفية المهمشة والتي وجدت نفسها في جحيم آلة الحرب الاسدية- الروسية الايرانية فريسة سهلة للحركات الجهادية.
العمل من أجل العدالة
لا يبدو تحقيق العدالة ممكناً بالاعتماد على القنوات الدولية. ففيما شكلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لجنة لتقصي الحقائق منذ العام ٢٠١٣، لم يكن من صلاحيات اللجنة تحديد منفذ الهجمات الكيماوية وهو ما قوض إمكانية المحاسبة. كما تكفلت روسيا بتعطيل عمل لجنة جديدة شكلتها الأمم المتحدة في العام ٢٠١٥ وواصلت مع الصين استخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط أي قرار في مجلس الأمن يتضمن إجراءات عقابية أو إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. أما الضربة الصاروخية الأمريكية التي قامت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بصورة منفردة في العام 2017 كرد على هجوم كيماوي جديد على بلدة خان شيخون فقد كانت من من الهزالة إلى درجة أن طائرات الأسد الحربية أقلعت من قاعدة الشعيرات التي تعرضت للقصف بعد يوم واحد فقط لتعاود استهداف المدنيين السوريين.
ومع انسداد أفق المسارات الدولية لتحقيق العدالة، يعمل اليوم قسم من الناجين وعائلات الضحايا بالتعاون مع منظمات حقوقية سورية لرفع قضايا جنائية في بلدانهم الجديدة ضد عدد من المسؤولين في نظام الأسد كما حدث في فرنسا وألمانيا. يعمل هؤلاء في مواجهة محاولات روسيا والنظام السوري تدمير جميع الأدلة التي تشير إلى استخدام السلاح الكيميائي فضلاً عن ترهيب الشهود والكوادر الطبية والتهديد باعتقال أقاربهم الموجودين في مناطق النظام أو اغتيالهم. مع ذلك، يعمل السوريون بمثابرة على جمع الأدلة والشهادات حول المجزرة الكيميائية ويحلمون بلحظة فارقة يمكن فيها تحقيق العدالة للضحايا.