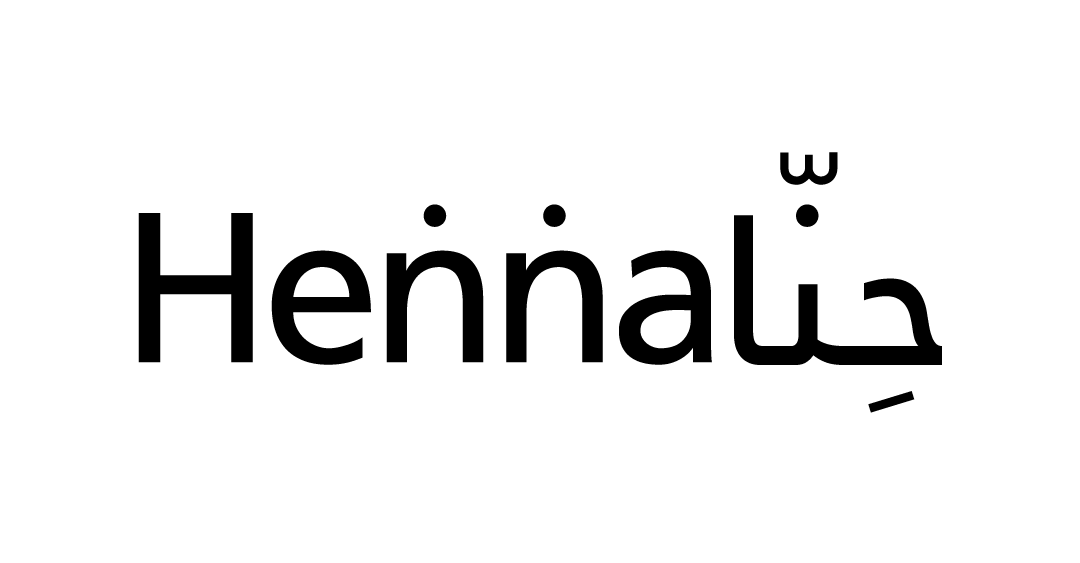تأثيث الذاكرة
البحث عن طريق النجاة في ظلال المقتلة

هذا المقال هو جزء من مجلة مفازة الرقمية التي تبحث في موضوع النجاة. تقرأون أيضاً فيها: جمهورية الأجساد الكليمة لنبيل محمد، القيامة في الجسد لكنانة عيسى، حوكمة الأمل لحسين الشهابي، العالم ليس قرية صغيرة لرجا سليم، أن تهوي من اللامكان لنور موسى، نجاة الهوية في الشتات لعلا برقاوي، حين يفهمونك دون أن تضطر للكلام لشاونت رافي، والجروح الحية: عن الانتهاكات والمظلومية لساشا زاك.
_________________________
علي زراقط
كاتب وصانع أفلام من لبنان، يعيش في تورونتو، كندا. عمل في الصحافة والتلفزيون كما نشر كتابي شعر، وفي رصيده العديد من الأفلام بين روائي قصير ووثائقي.
_______________
عندما طُلبت مني المشاركة في مشروع مفازة للحديث عن فكرة النجاة، سألت نفسي لوهلة: هل يمكن لي الكلام عن النجاة؟ وهو سؤال مرآة للسؤال الداخلي الآخر: هل أستحق النجاة؟ كلنا يعلم أن الناجي يحس بالذنب تجاه الضحايا من أبناء جلدته. كان جوابي أنني لا أعلم إن كنت أستحق الخوض في مسألة النجاة والكلام عنها. ويزيد على هذا أنني لبناني. فحين سألني أحدهم عن مأساة اللبنانيين مقارنة بمآسي السوريين أو الفلسطينيين؟ رأيت السؤال مربكاً. فمأساتي، كي لا ألتزم بقول مأساة اللبنانيين، لم تنفصل يوماً عن مآسي الفلسطينيين والسوريين. ومربك هو أن تحاول تبرير مأساتك الشخصية والوطنية أمام شخص منغمس في مأساته. سؤال قد يكون سببه الجهل بالواقع اللبناني، لكنه مدفوع بالألم الذي يغشى العيون. من منا مأساته أكبر؟ من منا أوجاعه أكثر؟ كيف لك أن تجيب شخصاً لا يرى سوى ألمه، وبالتالي لا يرى سوى ضرورة نجاته؟ وأسأل نفسي، أليس هذا هو السؤال نفسه الذي يدفع بعض العنصريين اللبنانيين لملاحقة لاجئين سوريين في لبنان؟
مقدمة كان يمكن تفاديها
لا أعلم إن كنت بالحق مهدداً، أو إن كانت حياتي على المحك. لكنني أعلم أني ولدت في حرب، ولم أعش على مر واحد وأربعين عاماً أكثر من ثلاث سنين بلا حرب. ولدت وبلادي محتلة احتلالين، احتلال اسرائيلي في الجنوب حيث قريتي وبيت العائلة وأرضها على الحدود، واحتلال سوري لباقي الوطن بما فيها السياسة والاقتصاد. شهدت ثماني سنين من الحرب الأهلية، ونجوت مرتين من قصف طال محيط منزلي. كنت في الخامسة عندما قتل والد رفاقي في الحي بقذيفة. عشنا سنين نترحل من بيت إلى بيت عبر القرى، هرباً. حل السلم الأهلي، ولم نسلم من القصف اليومي الاسرائيلي حتى عام 2000. مات الآلاف من مدنيين وعسكريين، واعتُقل الآلاف بعضهم من أبناء العائلة. تعرضت منطقة سكني لحربين اسرائيليتين مدمرتين في 1993، و1996. نزحنا وهربنا وغنينا مع مرسيل خليفة وأحمد قعبور أغاني الوطن فيما يعرض التلفاز صور الشهداء، وسيارة المنصوري وأطفال قانا. عندما عدنا كان البيت هناك لكن المبنى المقابل تهدم، ومات من مات فيه. تحرر الجنوب في عام 2000، فتبقى لنا تحرير باقي الوطن من الاحتلال السوري. مظاهرات واعتقالات للأصحاب والرفاق، كنت غراً ومشاكساً، لكنني كنت حذراً. خرج الجيش السوري في 2005، فأتت حرب تموز 2006. حين قصف الجيش الاسرائيلي بيوتنا، حتى تحولت غباراً. عملت في الإغاثة مع مجموعة رائعة من المتطوعين والمتطوعات، وشاهدت دماراً وقتلاً. كتبت نصاً يقول: “بين الضباب الذي تصنعه القذائف يولد الرماد/ المدينة أصبحت الآن رماداً/ وسنبني فوق الرماد رماداً/ هو لون بلادي الآتية في اللوحات الآتية/ هو لون سمائي الآتية في الأماكن الآتية”. تهدم 30 بالمئة من البلاد خلال الحرب الاسرائيلية، ومات الآلاف. تضرر بيت القرية في الجنوب وأعدناه أجمل. بين 2004 و2008، عشنا مواسم الاغتيالات والتهديدات. عشرات من السياسيين والصحافيين قتلوا على يد نظام نعرف كلنا إجرامه. في 2007 بدأت موجات الحروب الصغيرة. معارك مخيم نهر البارد، تهجير للآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين من المخيم، ومعارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين. احتلت الميليشيات مدينة بيروت في أحداث السابع من أيار 2008. قتلى في الشوارع. قمع واعتقالات. في 2011 انغمسنا كما كل العرب في الربيع، لبنان الواقع تحت حكم أمني ومخابراتي، ثار ثواره مع كل الثورات ودفعوا ثمنها ضريبة سياسية باهظة. يعلم من يعلم فاسألوهم.
شاركت ميليشيات محلية في حروب سوريا واليمن. في 2013، وقعت أحداث عبرا، بمواجهات بين الجيش اللبناني وخلايا إسلامية. لم تتوقف المواجهات الأهلية في طرابلس بين 2011 و2019، وكذلك الأحداث الأمنية المتفرقة من اغتيالات. معارك صغيرة وتفخيخات في كل البلاد. البلاد الواقعة تحت حكم أمني خانق، وفساد وسرقة في الإدارة قد يكون الأكبر على الإطلاق، شهدت تدهوراً شاملاً في الخدمات حيث عاشت وتعيش الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بلا مياه ولا كهرباء، وبلا خدمات رعاية، وفي ظل إدارة ترعى التلوث القاتل، حتى اختنقت البلاد من شمالها إلى جنوبها بالنفايات في سنة 2015، وحتى احترقت البلاد ووقعت في الأزمة المالية القاتلة في 2019.
في 2019، بينما كان اللبنانيون يقاتلون لأجل حريتهم وحقهم ببلاد أفضل، كان الكثير من إخواننا العرب يطلقون النكات على النساء اللبنانيات لتحررهن ولبسهن الشورتات وأشكالهن الجميلة في التظاهرات. سنتها دخل أكثر من 70% من اللبنانيين تحت خط الفقر، بلا أي شكبة حماية. وماذا بعد؟ هذا غيض من فيض ما عاشه ويعيشه اللبنانيون. هل يكفي هذا للحديث عن المأساة اللبنانية؟ ربما قد كان يكفي القول إن لي بيتاً في جنوب لبنان وأرض مزروعة بالزيتون والصنوبر تطل على فلسطين، حررها يوماً أبناء عمومتي، ترزح تحت القصف من الجيش الاسرائيلي منذ أكثر من سبعة أشهر. في لبنان هناك أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى، عشرات آلاف المباني المهدمة، أكثر من 40 ألف شجرة محروقة وأكثر من 80 ألفاً من النازحين الداخليين منذ سبعة أشهر إلى اليوم. وهذا ليس كل شيء.
ربما لأننا تعودنا على الحياة على ضفاف البركان، نلهو ونلعب في الوقت عينه فيما نموت ونناضل. لا يعلم الكثيرون أننا نستحق النجاة نحن اللبنانيين أيضاً. وربما مأساتنا ليست بحجم المأساة الفلسطينية، لذا قد نخجل التصريح بالألم.
ثيمة النجاة
كي أكون واضحاً من البداية: لا أظن أننا نجونا. لا أظن أن من خرج من المقتلتين الفلسطينية والسورية أو الموت اللبناني اليومي البطيء نجا، حتى على أرض كندا، طالما أن آلة القتل لا زالت عاملة في البلاد. لكن لنا في عتمة العقل التي تحكمها التجارب القاسية وبين طيات الذكريات القاتمة مساحة كي نعمل على نجاتنا، التي لا بد ستحدث يوماً ما. في المقال التالي، سأكتب عن “تأثيث الذاكرة” بكونه الفعل الوحيد الذي يمكن أن يقوم به المهددون في طريقهم نحو النجاة. أنظر إلى مفهوم الذاكرة بكونها الشرط/المكان الذي يسقط سطوته على العالم الذي نعيش فيه ونتفاعل معه.
نحن نعيش في كندا اليوم، لكن عقلنا يحاكم الحياة فيها بأدوات ووعي ومشاعر الماضي القادم من البلاد. هذا الماضي المليء بالمشاعر القوية والارتباط العضوي بأماكن أخرى محملة بالشحنات العاطفية يدفعنا إلى المقارنات وإلى البحث في الذاكرة عن ملجأ للسكينة، أو يدفعنا إلى العزلة والانفصال. أقترح أن سيرة نجاتنا نكتبها عبر استرجاع الذاكرة وإعادة تكوينها ومزجها بما نعيشه الآن، لا عبر عزلها أو تجاوزها. وأقترح فكرة “تأثيث الذاكرة”: عبر استيعاب الطريقة التي نستعيد فيها الماضي وارتباطه بالمكان، يمكننا إعادة فهم ذاكرتنا وترتيبها شعورياً ثم تأثيثها بتجارب جديدة تربط تجارب الماضي بالواقع الحالي وتستخدم الخيال لخلق المستقبل.
انطلاقاً من فكرة غاستون باشلار، القائلة بأن المساحات يمكن أن تكون بمثابة ملاذات للذاكرة، حيث نعرف الأماكن بما نألفه منها ومدى اختبارنا لها،1 أنتقل إلى أن فعل “تأثيث” الذاكرة بتجاربنا وتفاصيلها هو وسيلة لخلق مكان مستقر وآمن في عالم غير مستقر. لا تتعلق هذه الرحلة بإعادة النظر في الذاكرة فحسب، بل تتعلق أيضاً بالعمل المتعمد المتمثل في تأثيثها وإعادة تشكليها لإيواء استمرارية الحياة والثقافة في ظل الاضطراب والنزوح. يمكن اعتبار هذا آلية بقاء، إذ نجد الأساس والاستمرارية في المساحات المألوفة للذاكرة. نحن نبني ونعيد بناء مساحاتنا الحميمة في أذهاننا باستمرار. لا تتعلق هذه العملية بالحفاظ على الماضي فحسب، بل تتعلق أيضاً بإعادة تصوره وتفسيره، بما يسمح للأفراد بالتكيف مع الظروف الجديدة والحفاظ على الشعور بالاستمرارية والهوية. الذاكرة ليست رومنسية بالضرورة، كما أنها لا تعمل باتجاه واحد، هو الماضي، وإنما تتعامل مع الآلام ويتجادل فيها الماضي مع الحاضر واحتمالات المستقبل.
تقادم الكلمات السريع
لقد محوت النص ثلاث مرات حتى الآن كي أعيد كتابته. كلما نظرت إلى الكلمات أراها تقادمت وتهالكت أمام الحدث. الشاشات التي أشاهد وأقرأ عليها الأخبار تسبقني وتسبق أفكاري. فكرتي هي أننا بحاجة لاستعادة الذاكرة كمكان للكلام. أريد التأسيس على هذا كي أسأل أسئلة عن موقعي وموقع من هم مثلي في عالم اليوم، وعن السؤال الأساسي: “هل نجونا؟”. لكن أمام الحدث اليومي، وامتلاء الوقت بمآس طازجة، كيف لنا تذكُّر المآسي للكتابة عن العلاقة المبتورة مع الذاكرة؟
لقد محوت النص مرة لأن الحدث سبقه. المقتلة ما زالت مستمرة، وكل كلام لا ينطلق منها هو محض هذيان. ومحوته مرةً أخرى حين ضبطت نفسي أكتب بصيغة الجمع، عن النحن. حين سألت نفسي: من نحن؟ لم أعرف الإجابة. ومحوته في المرة الثالثة غضباً، لماذا أكتب ولمن؟ من شرفتي التي تشرق عليها الشمس النادرة في تورونتو العزيزة، أنظر إلى العالم حيث الناس محبوسون في سماعاتهم العازلة للصوت، لا يسمعون إلا ما تختاره الألغريتمات. صار الصوت في هذا العالم مأتمتاً ملغرمأً، وصار الكلام صدىً في تصميم مسبق الصنع. مهما كان الكلام الذي تصنعه الآن مهماً فريداً خارجاً عن الصندوق فهو داخل في قنوات مصممة مسبقاً للفهم. هذه القنوات تحكم فهمنا للّغة والمعنى، تختار عنا الزمان والمكان والسياق الذي نسمع أو نقرأ فيه. وتختار لنا عبر قنوات التمويل المصممة سياقات ما يمكن أن يُكتب وما يمكن أن يُحكى وما يمكن أن ينشر. نظن أننا نحكي ما نريد، إلا أننا نحكي ما هو متاح. فلماذا نكتب، ولماذا نحكي إذاً؟ أحكي كي أرمم الذاكرة، كي أفتح الجروح المتقرحة وأسبّب الألم في نفسي، أو كي أنسى فأشيح نظري عن الحدث اللئيم لأصنع السلوى في ضحك أو وهم. لكن أحكي، وأظن هنا أنه يمكنني استخدام الجمع: نحكي في الغالب كي نستطيع بناء الذاكرة، كي نتذكر وكي نُذكر. الذاكرة هي الجدوى الوحيدة.
تأثيث الذاكرة
عالمنا تحكمه تجاربنا الحية، ولا يمكننا النظر إلى الذاكرة كمستودع رمادي للماضي فقط. هي كلوحة، أو شاشة إل سي دي متغيرة الألوان، يعاد طلاؤها باستمرار. الذاكرة ليست أرشيفاً ثابتاً؛ إنها مساحة معيشة. هي تتهدم وتتشوه، وتتغير وتنتقل بقدر انتقالنا. مثلما نعيد ترتيب الأثاث في منازلنا، يمكننا إعادة تأثيث ذاكرتنا. يظهر لي مفهوم “تأثيث الذاكرة” كمجاز عن فكرة استعادة ذكرياتنا ثم إعادة تشكيلها عمداً، لبناء ملاذ للهوية وربط حبل العقل وسط الفوضى.
بعض المساحات، مثل البيت والوطن والوطن البديل، ليست مجرد هياكل مادية بل هي خزانات للذكريات والأحلام. تصبح هذه المساحات أماكن يتم فيها الحفاظ على الماضي، المكان الوحيد الذي يتيح للخيال الازدهار. الخيال لا يمكن له أن ينمو إلا بقدر اعتماده على الذاكرة، على ما مضى وعلى ما هو معروف، أي على معطيات سابقة لها شحناتها المعنوية والعاطفية. بالنسبة لباشلار، المنزل هو مساحة تضم تاريخنا الشخصي وعواطفنا وأحلامنا، ويلعب دوراً حاسماً في تشكيل هويتنا وإحساسنا بالذات، و صناعتنا لمعنى وجودنا.
وجودنا منسوج بشكل معقد في نسيج المكان. تشكل المساحات التي نعيش فيها ذكرياتنا و إحساسنا بالانتماء. المكان هو تجربة حسية، هو نسيج من الروائح والأصوات. فلنفكر في منزل الطفولة حيث تبقى رائحة الخبز الطازج في المطبخ، حيث تحكي بلاطات الأرضية المصنوعة من الصلصال الملون قصصاً عن الأجيال الماضية. يصبح المكان مرسى، أو نقطة مرجعية لذكرياتنا. لكن المكان ليس ثابتاً. إنه يتطور معنا. مقعد الحديقة حيث تلامست الأيدي لأول مرة، وساحة المدينة الصاخبة حيث يتردد صدى الاحتجاجات. هذه أماكن أصبحت جزءاً من جغرافيتنا الشخصية، ومن أجسادنا نفسها. المنزل، بحسب غاستون باشلار: “يأوي أحلام اليقظة.. ويحمي الحالم.. ويسمح للمرء أن يحلم بسلام”.2
الذاكرة هي المكان الذي يقع في الوسط بين عالم الأحلام وعالم الأشباح المؤرقة لماضينا. تاريخنا الشخصي والجماعي يشكل هويتنا ويوفر سياقاً لوجودنا. عندما نقطع هذا السياق، نواجه فراغاً وتمزقاً في روايتنا. اللاجئ الذي أُجبر على الفرار من وطنه الذي مزقته الحرب لا يفتقد السلامة الجسدية فحسب، بل يفتقد أيضاً الاستمرارية في قصة حياته. وبالمثل، فإن المجتمع الذي يقمع ذاكرته التاريخية يخاطر بفقدان مرونته الثقافية. العادات هي الخيوط التي تنسج حياتنا اليومية، توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالأحداث، والتنبؤ بالأحداث هو السمة الأهم للاستقرار والقدرة على الاسترخاء.
الذاكرة كملاذ
كان لنا مكان قبل القدوم إلى بلاد اللجوء أو الهجرة القسرية. هذا المكان ليس الشقة التي سكناها، ولا حتى المدينة التي عشنا فيها؛ هو تراكم التجارب وخيالنا عن الحياة التي عشناها في هذا المكان. جزء من ذاكرة المكان يكمن في القدرة على مغادرته، وجزء من تجربة المكان هي الأحداث التي أثرت في مسار حياتنا، إضافة إلى الأماكن التي نحلم بها أو نقارن أماكننا بها. عندما كنا نعيش في بيروت وضواحيها مثلاً، كان نبحث دوماً عن حديقة، عن ملاذ نتخيله على شكل حدائق المدن الأوروبية والأمريكية. كان هذا البحث جزءاً من حقيقة المكان، وجزءاً من تجربتنا فيه. كان، بالتالي، جزءاً من ذاكرتنا عنه. خيالنا عن المكان، أو تمنياتنا لما يمكن أن يكونه المكان، يصنع ذاكرتنا عنه. رغبتنا بالحرية والديمقراطية في بلادنا الأصلية هي جزء من ذاكرتنا. لوهلة نتذكر فرحنا واحتفالنا بقدرتنا على الهتاف في مظاهرة لأجل الحرية، وفي وهلة نتذكر بطش الأمن وقنابل الغاز والمطاط والرصاص الحي على المتظاهرين. ها نحن اليوم نقف في حديقة جميلة في تورونتو، لكن حلم الحديقة الكندية في بيروت أو الشام الساكن في ذاكرتنا، مختلف عن الحديقة الفعلية في كندا نفسها. ذاكرتي تحس بالقطع، بأن لا علاقة لهذا الواقع بذاك الحلم.
فلأحكي لكم عن مشهد في الحديقة، وكيف يمكن أن تتحول المساحة المدنية المصممة للمرح إلى تجربة قادرة على تغيير في النظرة والتوجه. كانت السماء قد تخلت عن غيومها للتو، حين توقفت المسيرة بأعلامها ويافطاتها في حديقة “كريستي بيتز” في تورنتو. استمعت الجموع إلى كورال نساء عربيات، قادمات بكوفياتهن المستوردة من خلف المحيط ليغنين معاً لأجل فلسطين. غنت السيدات لأجل وصل ما انقطع من علاقة بين الذاكرة والمكان الذي يعشن فيه. استعادة العلاقة بين الذاكرة الشعورية والواقع عبر الغناء والمكان العام والمجتمع المحيط هي وسيلة لترميم الذاكرة، واستعادة قدرتها على صناعة المعنى. تتدخل الذاكرة هنا لتُسقِط المعنى على المكان بالصوت والصورة، فيُعاش كامتداد لحياة كانت. هذا الفعل هو فعل تأثيث للذاكرة بتجارب جديدة. يمكن عبر هذا الفعل لحلم حديقة في بيروت أن يمتلئ بأغنيات نساء تورونتو العربيات فيصنع جسراً ما كي لا ننسى، وكي لا نغرق في الشجن من كثرة العيش في الماضي.
هكذا، يمكن أيضاً اعتبار المساحات التي نتشاركها كمجتمع، أو كمجموعة ضمنه، مستودعات ذاكرة جماعية. يمكن لإعادة تزويد هذه المساحات المشتركة بذكريات جماعية أن تعزز الروابط الاجتماعية والهويات الثقافية، مما يساهم في البقاء الجماعي لمجموعة أو مجتمع. يتمدد تركيز باشلار على المنزل إلى المستوى المجازي، حيث يمثل المنزل جوهر كيان الفرد أو هويته. في النضال من أجل البقاء، وخاصة في أوقات النزوح أو الأزمات، يمكن لتأثيث الذاكرة، عبر مدها بتجارب جديدة، أن يعزز الإحساس بالاستقرار والهوية.
في الحديقة
في الحديقة نفسها التي تجمع فيها محبو فلسطين من بيض وسود ويهود وعرب كان هناك امرأة ورجل من السكان الأصليين لـ”جزيرة السلحفاة” (كندا) يشعلان النار المقدسة لاستذكار أرواح الراحلين من أهلهم بفعل الاستعمار المتوحش. لم تكن لحظة بسيطة بالنسبة لي أمام السيدة من السكان الأصليين التي شاركت الفلسطينيين أوجاعهم. كانت ذاكرتي مشغولة بالمأساة الحاصلة، لكنها في لحظة واجهت سؤالاً معقداً: كيف أقبل أن أكون مستوطناً في أرضٍ لم يسمح لي أصحابها بالإقامة؟ أنا لم أسألهم؟ كيف لي أن أطلب السماح منهم؟
في الحديقة، كان علي أن أقترب من النار المقدسة من جهة الشرق وأن أدخل إلى الدائرة الخاصة بها. تعلمني السيدة من السكان الأصليين عن تقاليد حرق “الأدوية” بعد التمني، والأدوية هي قليل من التبغ وورق الأرز. تحملها في يدك اليسرى، تغلق عليها أصابعك وتتمنى، أو ترسل طاقتك، ثم ترميها في النار. أنظر إليها تحترق، وأشم رائحتها. كم مرة رأت السيدة النار تحرق غصون الأرز؟ وكم مرة أحست بالوهج وتنشقت رائحة التبغ، ثم نظرت إلى الأعلى ورأت الشمس تغيب؟ وكم اسم من أسماء أبناء جلدتها يتساقط أمام عينيها في المساحة التي احتلها الهواء البارد بينها وبين النار؟ أسماء كثيرة تحتل المكان، أسماء لا أعرفها، أسماء موتى قتلهم الاستعمار. وأنا هنا مثلهم أتذكر أسماء موتاي، على أرض ليست أرضي، وفي بلاد ليست بلادي. كيف يمكن لهذه البلاد أن تصير بلادي؟ هل أدور على كل قبائل السكان الأصليين أستأذنهم شخصاً شخصاً كي أصير ابناً لهذه الأرض؟ أم أكتفي بنظرة محبة واحدة من الرجل الذي أشعل النار في حديقة كريستي بيتز لتذكر أرواح بني جلدته؟ أشعر بذنب، منذ سنة، منذ أن حطت قدماي على هذه القارة. أشعر بذنب منذ سنة. لكن عمر هذا الذنب من عمري، من عمر معرفتي بكل الأهوال التي عرفتها، كما لو كانت كلها ذنبي أنا. فأعتذر. اعتذرتُ من هذه الأرض قبل أن ألقي حفنة التبغ وبضع أوراق الأرز من يدي في قلب النار. اعتذرت من الهواء الذي لا أعرف كيف أتعامل مع برودته. اعتذرتُ من كل اسم مات، وعلّقتُ اعتذاراتي في الذاكرة، أثاثاً جديداً، يضاف إلى ما فيها.
البقاء على قيد الحياة كنمط مستمر
خلال الشهر الماضي كنت في بيروت، مدينتي، في زيارة أولى بعد قراري بالهجرة إلى كندا. وبيروت لمن لا يعرفها هي مدينة تعيش، بكل ما للكلمة من معنى، على ضفة بركان. وحياة بيروت لا مثيل لها، هي حياة تحس بها طوال الوقت، في كل دقيقة وفي كل ثانية، تحس بأنك حي. كثافة الاحساس بالحياة هذه سببها كثافة الإحساس بالتهديد. قانون الحياة العادية هو أن كل يوم هو يوم جديد يستحق الاحتفاء به، أو كما قالت لي صديقتي: “كل يوم هو يوم زائد”. والقصد أنها عاشت مراراً لحظات تقارب الموت، لا بسبب مرض أو حادث طبيعي، وإنما بسبب كارثة صنعها الإنسان، الاحتلال، الغباء، الإهمال أو العادات والتقاليد. قالت لي ماريا شختورة، الصحافية اللبنانية، معلقةً على كتاب لها حول الحياة في لبنان خلال الحرب الأهلية، إننا لا نعيش، بل نبقى على قيد الحياة. وسؤالي اليوم هو هل “ننجو” إذا بقينا على قيد الحياة؟
يقول الكاتب بلال خبيز في كتابه اللحظة التي تفتح فيها عينيك هي لحظة الفاجعة: “لم يعد اليوم الذي يعيشه المرء يقربه من الموت يوماً واحداً، كما هي الحال في العيش العادي. بل صار اليوم الذي يعيشه المرء هو يوم يقع في زمن ما بعد الموت. أي أن النجاة، التي يتحسس آثارها المرء في عظامه ولحمه كل صباح، هي بالضبط العيش يوماً إضافياً في زمن ما بعد الموت”.
البقاء ليس حدثاً فردياً؛ إنه نمط مستمر محفور في وجودنا. مثل النبض الإيقاعي للقلب، يصبح البقاء على قيد الحياة نبضنا، والإيقاع الثابت الذي يدفعنا إلى الأمام. عندما يصبح صراع البقاء دائماً، فإنه يعيد تشكيل تصورنا للواقع. اليقظة المتزايدة، والحاجة إلى التكيف، والاستعداد الدائم، تصبح كلها عادات متأصلة. يصبح القلق جزءاً من وجودنا اليومي، مما يطمس الخط الفاصل بين الحياة الطبيعية والأزمات. غالباً ما يؤدي البقاء على قيد الحياة وسط الشدائد إلى حالة عاطفية متناقضة. يتعايش الفرح والراحة مع القلق واليقظة. نحتفل بكل انتصار، مهما كان صغيراً، بينما نخشى في الوقت عينه التحدي التالي.. توازن دقيق بين الأمل والخوف.
القتال المستمر لأجل البقاء على ضوء الكوارث يبقينا في حالة طوارئ دائمة. تظل مسامنا نشطة وفي حالة تأهب للقتال أو الهرب، حتى خلال لحظات الهدوء الظاهر. يؤثر هذا الإجهاد المزمن على صحتنا الجسدية ورفاهنا العقلي ونوعية حياتنا بشكل عام. لقد أصبحنا بارعين في التعامل مع الأزمات، ولكن بأي ثمن؟ ذكرى تجارب البقاء السابقة تزن على القلب بشكل كبير. تؤثر على صنع القرار وعلى العلاقات وعلى إحساسنا بالهوية. نحن نحمل ندوب البقاء على قيد الحياة، وهي تشكل تفاعلاتنا مع العالم.
أتذكر هنا عندما كانت الممثلة أنجو ريحان تتساءل على المسرح إن كانت هي السبب. كانت ريحان تسأل إن كانت مذنبة لأنها بقيت على قيد الحياة. “الحق عليي؟” تسأل الممثلة على خشبة المسرح، فيما تروي سيرة فتاة اعتقل الجيش الاسرائيلي أباها خلال فترة احتلاله للبنان. تظن الفتاة الصغيرة أنها السبب في ابتعاد والدها عن البيت، وتربّي نفسها في عقدة الذنب. ذنبٌ لم تسقطه عليها الأم، ولم يشر إليه الأب يوماً. هو ببساطة الذنب لأنها ولدت في بلاد مكلومة بالاحتلال والحرب والرعب والخطف والسجن. هكذا أخذ الاسرائيليون والدها، فولد الجرح. في مسرحية شو منلبس؟ للكاتب يحيى جابر والممثلة أنجو ريحان تتراكم كل الأحداث على عقدة الذنب تلك. أحداث بحجم مرض، أو موت، أو حرب، أو تهجير، أو احتلال، أو اغتصاب حق. فهل الحق علينا؟ وكيف يستطيع الإنسان/ة معرفة ذلك؟ كيف نرتاح من عقدة الذنب التي تأكلنا؟ نحتار فنغرق في السؤال التالي الذي يفتح باب التذكر. وهنا تقع الخطورة في التعامل مع الذاكرة، فأي عالم نبني من الذكريات وفيها؟ هل هو عالم يحاول الهرب من الذنب؟ أم هو عالم يغطس فيه كما تفعل بطلة المسرحية؟
المغادرة كطموح
كنا 14 طالباً في الصف حين تخرجنا، لم يتبقَ سوى خمسة منهم في البلاد. لطالما كانت مغادرة البلاد طموحاً فردياً لدينا. حلم أوروبا الحرية والديمقراطية، وأمريكا الفرص والأرض الكبيرة، وكندا الاستقرار والتقبل، أو الخليج الرفاه والقدرة المالية. أياً كانت الوجهة، كانت المغادرة طموحاً لدى جيل كامل بدأ يرى بلاده تتآكل أمام عينيه من نهاية التسعينات إلى اليوم. كتب عبد المجيد زراقط (وهو والدي) في مقدمة روايته الهجرة في ليل الرحيل توطئة تشرح الفارق بين الهجرة والرحيل. ففيما يكون الرحيل دائماً، تكون الهجرة كرحلة الطيور موسمية أو لسبب، على أنها تعد بالعودة. المهاجرون واللاجئون في تورونتو يحاولون صناعة وطن من جلسات غناء، أو بحث عن أطيب مكان للشاورما يذكرهم بما كان في الذاكرة، كما لو أنهم في مساحاتهم الداخلية كلهم “عائدون”.
ذاكرتنا عن الوطن أو البلاد ليست وردية، بل هي تحمل صدمات الموت والآلام أكثر من الضحك واللعب. لكن هذه الذكريات هي ذكرياتنا وهذا المكان الذي في الذاكرة هو ذنبنا الذي سنلبسه. تسأل أنجو ريحان شو منلبس؟ نلبس ذنبنا يا أنجو، ونحمله بكل تفاصيله في ذاكرة نعيد تأثيثها عند كل احتراق. نلبس ذنبنا ونحاول النجاة فيه.
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، وبدأت أوروبا باستيعاب توقف المدفع، دخل الجنود السوفييت إلى برلين. كانت حينها أمريكا تستعد لرمي قنبلتيها النوويتين على اليابان، وفرنسا “الحرة” تستعد لتأديب مستعمراتها بالنار والبارود. قال الحلفاء إن الحرب انتهت، وقرروا أن من بقي حياً فقد نجا. هكذا خرج من تبقى من يهود أوروبا إلى النور، متعبين محزونين، كي يحكوا حكاية النجاة. وحكاية النجاة هي حكاية المحرقة، واكتشاف القاتل وتحديد الضحية. هكذا كان اليهود ضحية محرقة أودت بحياة ستة ملايين، ودمرت نسيجاً اجتماعياً، ومؤسسات وعلاقات وقدرة على التمازج الحيوي مع الجغرافيا والتاريخ لم تعد متاحة. لذا فإن من عاش بعد ذلك منهم فقد نجا. أما في بلادنا، لم تنته المقتلة، لذلك فنحن لم ننج بعد. لم ننجُ حين غادرنا بلاد الحرب!
كي ننجو، على الحرب والمقتلة والاغتيالات أن تتوقف عن العنين في عقولنا وذاكرتنا. علينا إعادة فهم الضحية في موقفها الحالي، وتحديد موقعنا من الجلاد، وإعادة فهم العلاقة بين بعضنا البعض، نحن الخارجين. كذلك لن ننجو فرادى، وعلينا أن نفهم المكان الذي أتينا منه. كي ننجو علينا أن نصدق أن هناك من نجا قبلنا، وأن نتعلم من نجاتهم سبلاً. علينا أن نعيد وصل الذكريات وروايتها لكي نبني عليها حياة ليست منقطعة عن الماضي لكنها تعرف كيف تؤثث الذكريات كي تستضيف زواراً جدداً، وخبرات جديدة .
- باشلار، غاستون، شعرية الفضاء ص 5، ترجمة من الفرنسية بواسطة جولاس، ماريا مع مقدمة بقلم جون ر. ستيلجو، أعيد طبعه في عام 1994، مطبعة بيكون. (الأصل: فرنسي، نُشر عام 1958).
↩︎ - باشلار، غاستون، شعرية الفضاء ص 6، ترجمة من الفرنسية بواسطة جولاس، ماريا مع مقدمة بقلم جون ر. ستيلجو، أعيد طبعه في عام 1994، مطبعة بيكون. (الأصل: فرنسي، نُشر عام 1958). المقتطف من ترجمة الكاتب
↩︎