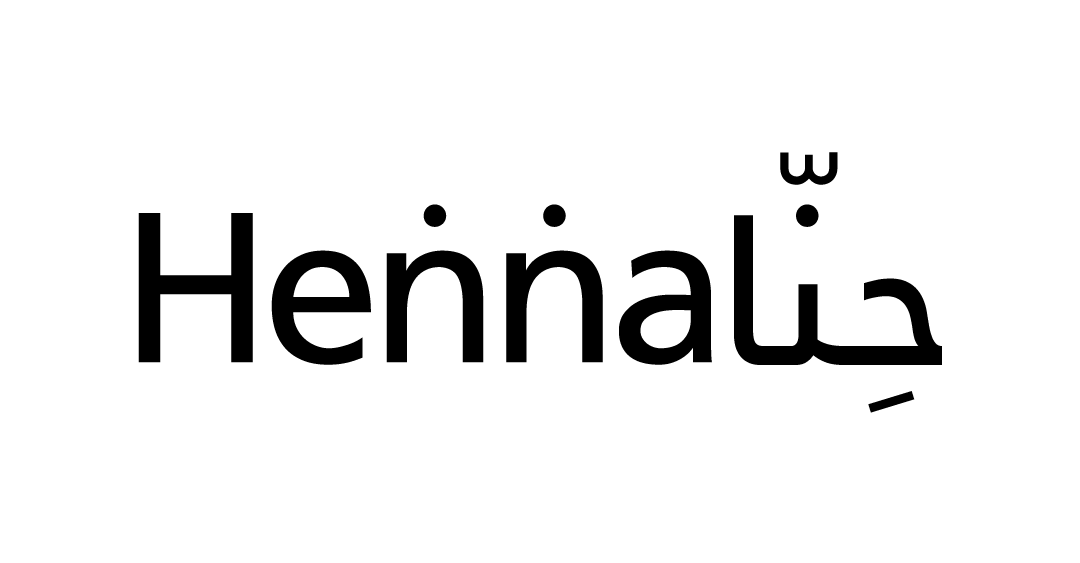بين التفاهم وسوئه
محاولة لفهم ملامح الخلاف مع أهالينا
مصعب النُّميري
صحفي وشاعر سوري مقيم في تورنتو. كتب وعمل محرراً في عدة صحف ومواقع عربية، وصدر له ديوان شعري. ويتابع حالياً دراسته للعلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة تورنتو.
بعد عقود على تلك الأمنيات البسيطة والحازمة، لم يتحقق منها الكثير. ندرك ذلك حين نتذاكر الأيام البريئة والساذجة في طفولتنا. قليلون منّا هم الذين أصبحو أطباء أو مهندسين نزولاً على رغبة أهاليهم. وكثيرون منا هذه الأيام منخرطون في أمور “ما بتطعمي خبز”، وفقاً لتصور هؤلاء الأهالي. ثمة ما يتجاوز الفروق الطبقية والاجتماعية والثقافية ويعبرها، ويتشابه في شكله ومضمونه والكلمات التي يتلخص بها. إنه “سوء التفاهم” مع الأهل، الذي يظهر كملمحٍ مشترك على امتداد الثقافات والأمكنة، ولكن بشكل أكبر في بلداننا المسحوقة أو التي تراوح على حافة الهاوية منذ بداية تاريخها المعاصر.
يحاول كثيرون تبسيط الصراع الدائر في كل عائلة شرق أوسطية ووصفه بـ”صراع الأجيال”. نظرية لا تصمد كثيراً أمام ملاحظتنا للتورط الذي نقع فيه بعد أن نعبر خط الثلاثين من العمر حين نبدأ تكرار بعض الأنماط السلوكية التي عارضناها لدى أهالينا، قبل أن ننتبه لها ونحاول فهمها وتغييرها. تتضح المفارقة أيضاً حين نتورط نحن وأهلنا بالسؤال المُربك والمكثّف ذاته، الذي نطرحه بالحيرة ذاتها، مثل ميمي سبايدر مان: “لك ليش ما عم تفهمو علينا؟”.
حتى لا تكون الصورة غائمة للبعض، أتحدث وأفكر في هذا المقال بالأبناء المولودين في الثمانينات والتسعينات على الأرجح، وهو الجيل الذي أنتمي إليه. أتناول فيه السوريين بصورة عامة، والشبان والفتيات التحرريين من أبناء هذا الجيل، اللاجئين في الغالب، وأهاليهم بصورة خاصة. قد تنسحب هذه الملاحظات جزئياً على بلدان أخرى في الشرق الأوسط، التي تتشابه في كثير من أوضاعها، ولكنها لا تتطابق من كل الجوانب. هي محاولة فردية، غير مستندة إلى أبحاث ومجموعات تركيز وجداول وداتا، وإنما آراء شخصية تحتمل الأخذ والرد والإضافة، أسعى فيها إلى الدعوة للتفكير فيما نحن فيه وحدود ما يُمكن أن نصل إليه في التجاذب اليومي مع أهالينا، دون أن يكسر أحدنا قلب الآخر أو يضحي بما لا يجب التضحية به. هو موضوع واسع وشائك ويحتمل التدبّر من زوايا عدة، ولكنني سأحاول وضع ملامح أساسية لهذين الجيلين عبر تأمل الظروف التي تشكّل فيها وعي كل منهما.
الحجر أصلب من الإزميل
جيل الأهالي المقصود هو الجيل المولود في الخمسينيات والستينيات. ولد أبناء هذا الجيل في مرحلة انتقالية وقلقة. في الغالب أصبحوا آباء وأمهات بعد سيطرة أنظمة ديكتاتورية على السلطة وتحويل البلاد إلى ممالك رعب يسودها الخوف والرهبة. في سوريا مثلاً، تجذرت هذه المخاوف وأصبحت نمطاً راسخاً للحياة بعد مجزرة حماة في الثمانينيات التي حوّلت الحياة إلى كابوس. كان لزاماً على من يعيش في هذه الظروف الرضوخ للسلطة القامعة وقتل حس المبادرة والاستنارة والعزوف عن التفكير النقدي. تحول هذا النمط في رؤية الأمور إلى منهج حياة شيئاً فشيئاً. وفي موازاة ذلك، ترسخت تقاليد وأعراف اجتماعية، متسقة مع ثيمة القمع، مالت إلى الانضباط والمحافظة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية.
قليلون هم الأهالي الذين استطاعوا تبني قيم تخترق خطوط المحافظة هذه، فالتحرر على أي صعيد في هذه المعادلة يتطلب مواجهات ومعارك دامية. في ظل هذه المعايير، كانت المسطرة التي يُقاس فيها سلوك الأبناء هي مسطرة العار والفخر، والحلال والحرام، والولاء والبراء. صار “النموذج الصالح” للابن/ة هو المؤدب المطيع، الذي يتجنّب مُحاكمة ومساءلة أي نوع من أنواع السلطة، ويتوخّى المغامرة والخروج خارج المضمار المرسوم له في الحياة. في ظل هذه الظروف، كانت توقعات الأهالي من الأبناء تتمحور حول الالتزام بهذه المعايير القاسية لنحت السلوك وتقليم الوعي. نموذج “الإنسان الطبيعي” الذي يستشهد به الأهالي في نقاشاتهم مع أبنائهم اليوم، ليس طبيعياً على الإطلاق، لأنه يُحمّل الإنسان أكثر من طاقته ويقتضي قتل الكثير من المواهب والأحاسيس البشرية الطبيعية. هذا التصور هو المسبب الأكبر للخلاف والتصادم مع جيل الأبناء، الذي عاش بدوره ظروفاً استثنائية توسّع هذا الخلاف إلى مداه الأقصى.
بعد الثورة وموجات اللجوء الواسعة، عانى هذا الجيل من الآباء والأمهات بشكل مضاعف. فإلى جانب الخسارات الشخصية الهائلة والعيش على الأعصاب جراء عمليات القتل والاعتقال الواسعة التي استهدفت أبناءهم وبناتهم في معظمها، اضطر أبناء هذا الجيل إلى عيش تجربة الاقتلاع عبر النزوح والهجرة والفقدان ومحاولات التأقلم الصعبة في بلاد وظروف جديدة. في الخمسين والستين والسبعين، يُطلب منهم اليوم تعلم لغات وثقافات وعادات جديدة، رغم افتقارهم للمرونة والطاقة اللازمة لهذا، خاصة بعد التجارب المهولة والصادمة التي مروا بها خلال الأعوام الأخيرة. الاعتراف بقسوة هذه التجارب وآثارها على هذا الجيل وحدود قدرته على الاستيعاب والتحمّل هو بوابة أولى لخوض أي نقاش معه. قد يكون وجيهاً سؤال “ليش ما عم تفهمو علينا؟”، الذي يوجهه الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، فالهوّة الفاصلة بين الجيلين تتسع كل يوم إلى حدود يصعب ردمها عبر مساومات لا يرضخ ويضحي فيها أحد الطرفين. هذه التضحية تشبه أحياناً عملية البتر دون مخدر.
نوافذ على العالم
شهد أبناء الجيل المولودين في الثمانينات والتسعينات في سوريا واحدة من أكثر فترات البلاد انقطاعاً وعزلة عن العالم. كثير من بلاد الشرق الأوسط شهدت ظروفاً مشابهة تحت حكم الأنظمة الاستبدادية، جمهورية كانت أم ملكية، بيد أن سوريا والعراق على وجه الخصوص كانا البلدين الأكثر انعزالاً تحت حكم البعثين. تربّى أبناء هذا الجيل على قيم الطاعة والخضوع والانضباط الصارم، وتكللت معظم نواحي حياته بالرداءة والشحّ في هذين العقدين.
في السياق السوري، شهدت الألفية الجديدة انفتاحاً مؤقتاً ومحدوداً. كان هذا الانفتاح كفيلاً بأن يُدرك أبناء هذا الجيل ما فاتهم في عالم يتطور بطريقة دراماتيكية. كنّا نطل عبر نوافذ الماسنجر والمدوّنات لنتأكد من أننا موجودون على الخارطة وأن لنا صوتاً. ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتتيح فرص التشبيك والتعارف وخوض النقاش العام.
جاءت الثورات العربية كإعلان جذري للقطيعة مع العقلية التي نشأ في كنفها هذا الجيل. وإلى جانب البعد السياسي لهذه الثورات، أُلحقت بثورات ثقافية وجندرية وتقنية وسّعت شكل التمرد ليصبح مواجهة مفتوحة مع كل أنواع الوصاية ومحاولات القمع والاحتواء وتقليم الأظافر.
مع تعثّر هذه الثورات وانزلاقها إلى آفاق مسدودة، تصاعدت موجات الهجرة واللجوء. خرج هؤلاء الشبان والفتيات من بلادهم محمّلين بمشاعر ثقيلة من الإحباط والانكسار واليأس والاغتراب عن البلاد والمجتمعات العصيّة على التغيير. هذا الجرح العميق ضاعف شعور النقمة ضد كل ما ساهم في تحطيم أحلام هذا الجيل، ومن ضمن ذلك الخطاب الوصائي العفوي الصادر عن الأهل. عبارات الحث على الطاعة واستثارة الشعور بالذنب صارت تضرب على العصب.
إضافة إلى ذلك، خاض هذا الجيل في بلاده الجديدة معارك مركّبة، أهمّها التأسيس من الصفر، ومحاولة فهم العالم والذات. لكي يتأقلم الشبان والفتيات مع محيطهم الجديد، يحتاجون إلى التآلف معه عبر بناء هوية مركبة تحول بينهم وبين الذوبان أو الخصومة مع هذا المحيط. هذا التآلف قد لا يبدو مريحاً في بعض الأحيان للأهالي المحافظين، فتظهر في المجادلات معهم ملامح الصدام بين عالمين.
كل ما ازداد التعمّق في ميدان الصحة النفسية، يزداد اتضاح الأنماط المسيئة في التواصل بين الأبناء وأهاليهم بسبب انعدام الحدود الضرورية فيما بينهم. في مقابل عقلية الأهالي، الحذرة الداعية إلى اختيار الطريق الآمن الخالي من الصراع والمساءلة لما تم التعود عليه، يحاول الأبناء والبنات التحرريون/ات المُحاكمة والانتقاد وعدم القبول والتحدي والتجريب. هذان المنهجان المتضاربان في الحياة يبرزان في معظم الأحاديث التي يخوضها الأبناء مع أهاليهم.
فليقولوا ما أرادوا..
كيف يجب أن نتحدث مع أهلنا؟ وما السبيل إلى إقناعهم بقبولنا وقبول أفكارنا وأنماط حياتنا دون اشتراط؟ كيف يمكن أن نتواصل معهم دون أن يلوح شبح القطيعة في الأفق بعد نوبة غضب؟ وما هي المساحات التي تقبل المساومة والتفاوض والرسو على برّ الودّ؟
اختار كثيرون القطيعة مع أهاليهم، أو التحدث بقناع يناسبهم والعيش حياتين متضاربتين. يحدث هذا في الغالب مع الفتيات اللواتي يخترن نزع الحجاب أو مع مجتمع الميم. الحرب المفتوحة مع المحيط والعائلة في غاية القسوة، وبإمكانها خلق غمامة من الحزن والألم والرعب في بريق العين.
في كثير من الأحيان، يكون الخيار الوحيد المتاح هو القطيعة التامة وطي الصفحة. يحدث هذا حين تتضارب القيم بشكل جوهري ويتضح حجم الأذى الذي يقتضيه التواصل أو الخضوع. ولكن هناك الكثير من الأهالي الذين يحاولون النقاش والاستفسار والفهم والتغير، هذا الجهد الذي يبذلونه يستحقون به قبلة على الجبين.
نحتاج إلى العاطفة والدعم من أهالينا. نحتاج إلى الشعور بالأمان الذي بدأ بالبهوت في هذا العالم بعد قطع حبل المشيمة والفطام. في مواجهة عواصف الحياة، نريد سنداً وحباً غير مشروطين لكي تتخدر الكدمات. ولكن مشكلة هذا الحب أن ضريبته تكون أحياناً الذوبان والامّحاء وقتل النفس.
نحن مطالبون كأبناء أن ندرك مدى قدرة أهالينا على التحمّل والانسجام. التنازلات التي يمكننا تقديمها لهم يجب أن تتأتى من الشعور بالرأفة والعطف والمحبة. كثير من أهالينا لم يكونوا مسؤولين عن أخطائهم ولم يمتلكوا الأدوات اللازمة لتغيير واقعهم والتغيّر معه. ليس سهلاً أن يتغيّر الإنسان كلياً حين يتقدم في العمر. الأفكار التي شبّوا وشابوا عليها يصعب نزعها وتغييرها جذرياً، ولكن يمكننا أن نحاول التفكير معهم في مدى صوابها، بلغة هادئة وغير مُدينة إذا كان ذلك ممكناً. هذا الخيار يحتاج إلى الصبر والحب.
يُطالب الأهالي من جهتهم أن يعرفوا الحالة النفسية التي نعيش فيها في بلادنا المتداعية ومغترباتنا الباردة. لقد قُتل أعزّ ما نملك في هذه السنوات: الحلم والأصدقاء. وفقدنا أهم ما يُسهّل علينا الاستمرار: الطاقة والعزيمة. ونعيش ما عشتموه قبلنا دون أن يكون كثير منكم قادراً على التعبير عنه أو فهمه: الكوابيس ونوبات الذعر والقلق المزمن.
إضافة إلى كل ذلك، ثمة حمولة ثقيلة على كاهل كل شخص فينا من الاضطرابات والجروح الغائرة التي خلفها العيش في بلادنا المريضة، فضلاً عن الأكوام الهائلة من الأوراق والملفات والالتزامات التي يجب متابعتها والانتباه المُرهق لتفاصيلها. يحاول جيل الأبناء اليوم قطع درب شائك في رحلة التعافي والاستقرار وإيجاد المعنى. ويتطلب هذا التعافي تفكيك كل الأفكار والمفاهيم والتابوهات التي ورثها، والتي تعمل في وجدانه كمحراكٍ يولّد مشاعر الذنب والعار والإدانة القاسية للذات.
في ضوء كل هذا، لم يعد سديداً ولا صحياً أن تتمحور جل الأحاديث على فكرة إدانة سلوك الأبناء غير المتسق مع رؤية آبائهم وأمهاتهم. سؤال “شو بدون يقولو الناس” ليس مقبولاً طرحه في جدالات اليوم. فهؤلاء الناس مشغولون بهمومهم ولم يعد لهم سلطة التدخل في شؤون سواهم في البلاد الجديدة. و”المجتمع” المُتخيل الذي يقاتل الأهالي للحفاظ عليه، قد تداعى وانهار وهرسته الدبابات. الحرية الشخصية هي ألف باء حياة اليوم، والإدانة يجب أن تقع على من يتعدى على هذه الحرية، لا على من يصونها ويمارسها كحق.
لقد اتضح لكثير من الأهالي أن القهر والقسر لن يؤدي إلى الألم والأذى. التواصل بينهم وبين أبنائهم وبناتهم لا يجب أن يكون قائماً على صراع الإرادات وتكسير الأضلاع. هناك ما يكفي من الكلمات للنقاش، ويُمكننا التفكير بالأمور التي يجب أخذها أو عدم أخذها بعين الاعتبار لجعل الحديث مثمراً. الاختلاف ليس مصيبة ولا سبباً لدق نواقيس الخطر وشن الحرب. العالم يصبح مخيفاً أكثر فأكثر كل يوم، والدفء الذي توفره العائلة لا يقدّر بثمن.