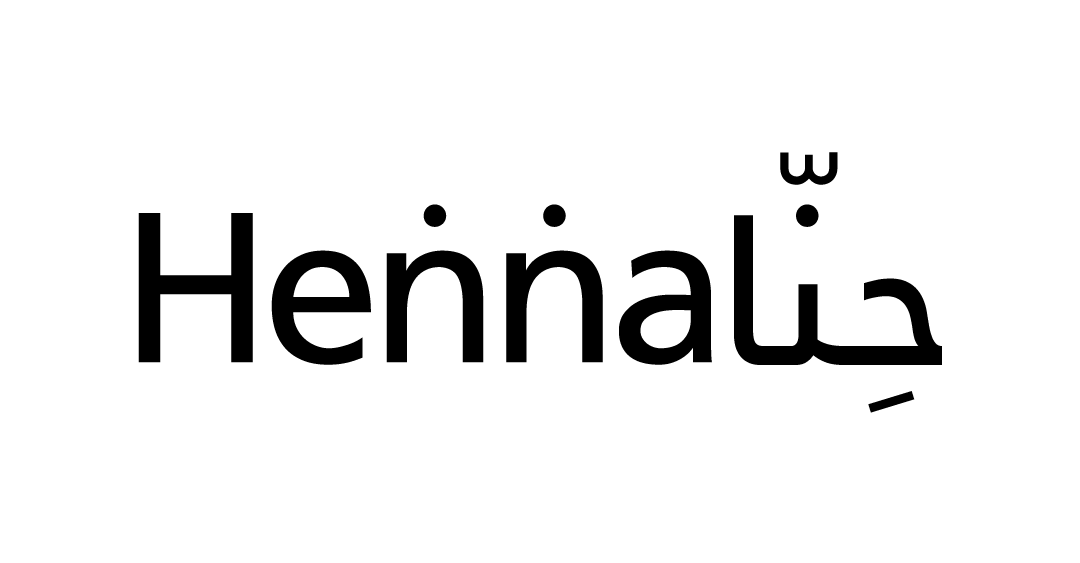بين الأسى والصبابة
محاولة للتفكير بعلاقاتنا في الشتات
مصعب النميري
صحفي وشاعر سوري مقيم تورنتو، كندا. صدر له ديوان وكتب عدة مقالات في صحف ومواقع عربية. يتابع دراسته حالياً في العلوم السياسية والشرق الأوسط في جامعة تورنتو.
ثلاث مدن في ثلاثة أسابيع بعد ثلاث سنوات من السبات في تورنتو. كان لا بد من رحلة كهذه كي أدرك أثر الترحال على مزاج الإنسان وأعصابه ومشاعره. السفر يُخرج الشخص من دائرة الروتين المُحكمة التي يعيش فيها في المدن الرأسمالية. في الحياة الروتينية تعرف متى تنام ومتى تستيقظ ومتى تأكل وكيف تعود إلى المنزل. ترى الوجوه والشاخصات الطرقية والمشاهد ذاتها. التكرار يسهّل توقّع الأشياء، ولكنه يعطيها حجماً أكبر من حجمها. الروتين يجعل الإنسان مُنتجاً، ولكن التكرار الذي يقتضيه يغلف الروح بغمامة من الملل والبرود ويغذي نزعة التمرد على هذه الرتابة. السفر هو تمرين للأعصاب وفرصة لإتاحة مشاعر جديدة بالتدفق. نوع من تدريب الجهاز العصبي على التحمل عبر تعريضه إلى أنواع جديدة من المخاوف. في السفر قرار طوعي بالتعرض لنوع خاص من القلق الوجودي آت من الانكشاف على عيون لا يألفها الشخص وعلى أناس لا يستطيع توقع ردود أفعالهم وقطارات لا يعرف بأي اتجاه تسير. غير أن هذه التجربة العادية للغاية، التي يخوضها البشر العاديون دون تفكير أو قلق، قد لا تكون سهلة على من يفتقد الإحساس العميق بالأمان. هناك أشباح مُفزعة تحوم في المخيلة لها علاقة بالمطارات والشرطة وضياع الأوراق والهلع لدى التفكير باحتمال وجود قطعة حشيش منسية في الحقيبة عند نقطة التفتيش. في السفر أيضاً فرصة لإعادة تنظيم كهرباء القلب جراء الالتقاء بالأصدقاء والندامى والأحاديث الطويلة التي تتضمن نوعاً خاصاً من البوح، بوح اللقى والوداعات الذي يولد مشاعر مكثفة تندر في اللقاءات اليومية. وفي حال كحالنا، يصبح السفر والاجتماع بالأصدقاء البعيدين فرصة للتفكير في واقعنا ومآلاتنا كأشخاص مشتتين فرقتنا الحدود وشغلتنا الحياة.
أحاول الكتابة عن هذه الرحلة وأتردد بشأن الطريقة. أكتب هذا النص لأنني اشتقت للكتابة الذاتية بعد انقطاع سببه الانشغال بالدراسة والعمل. لأن ثمة الكثير من المشاعر والأفكار في خلَدي، ولأنني اشتقت للسكينة التي يولدها النقر على لوحة المفاتيح والنظر إلى الغيم السارب في لحظة التأمل. والأهم من ذلك، أنني أريد قول شيء فيما خص حالنا في الشتات السوري. هذا الشتات الذي يترنح لدى محاولة الوقوف بسبب إدراكه يوماً تلو الآخر أن الأهوال لم تنته بعد، وأن أصداء المجزرة ما زالت هدّارة في المسامع، وأن القهر ما زال جارحاً وقادراً على سلب البهجة أو تغليف الضحكات بالنفس الحارق. الأسئلة التي أفكر في طرحها هي كيف نعيش في شتاتنا؟ ما هو شكل العلاقات التي تجمعنا؟ وما الذي يجمعنا ويفرقنا؟ بدأتُ بطرح هذه الأسئلة على نفسي بسبب سياق الرحلة الذي وضعها في وجهي بطريقة تقلع العين.
إبادة الإبادة على أرصفة فينيسا
جاءت رحلتي الأساسية إلى أوروبا ضمن فعاليات مهرجان أبكواد، القائم على هامش البينالي في فينيسيا. دُعيت إلى المهرجان لإلقاء بعض القصائد بعد فترة طويلة من الانقطاع الإبداعي بسبب كوفيد. هذا المهرجان، الذي أسسته واندا نانابوش برعاية متحف أونتاريو للفن، جمع نحو 100 فنانة وفنان من السكان الأصليين حول العالم. نوقشت خلال المهرجان قضايا الفن المعاصر للسكان الأصليين في مواجهة الاستعمار. تحدثت الفنانات والفنانون عن أدوات الفن في معركة امتلاك المساحة والتمثيل والصمود والتعافي. كان ثمة الكثير من الدموع والضحكات في هذا اللقاء الحميمي. اجتمع الحاضرون إلى المهرجان من كندا واستراليا ونيوزلندا والدول الاسكندافية والفلبين. كثير منهم لا يعرفون بعضاً بشكل شخصي، واجتمعوا للتعارف والتشبيك والتفكير في الحاضر والمستقبل.
لم يكن ممكناً التواجد في أجواء كهذه دون خوض تجربة وجدانية عميقة ومؤثرة للغاية. لقد جرّب الاستعمار الاستيطاني كل شيء بالسكان الأصليين في عملية الإبادة الثقافية التي انتهجها، الاستعمار الذي نألف صورته الأبشع في اسرائيل اليوم. مصطلح الصدمات العابرة للأجيال تطور في كنف الحديث عن قضية السكان الأصليين. القهر التاريخي الذي عايشوه ويعايشونه كان حاضراً في الأحاديث التي خاضها الفنانون/ات على مدار ثلاثة أيام. كان ثمة لحظات فكّرت فيها بأنني تلقّيت أكثر مما أستطيع الاحتمال. كان الحاضرون في غاية الجرأة في الحديث عن تجاربهم القاسية دون تحفظ. وفي المقابل، كان ثمة إحساس هائل بالتضامن والدعم والحب غير المشروط بين الحضور. ورغم قدومهم من مجتمعات ممزقة، كان واضحاً قرار الحاضرين في اعتبار أن ما يجمعهم أكبر منهم، وفي استصغار خلافاتهم وما يفرقهم. حاولت مقارنة أوضاعهم بأوضاعنا نحن أبناء البلاد المُبتلاة بالديكتاتوريات والميليشيات والاحتلالات، ففكرت بجرحنا الطريّ في مقابل قضيتهم المديدة. فكرت في أنهم، خلافاً لنا، يمتلكون هوية واضحة وعدواً واضحاً، وكان لديهم الوقت الكافي لتطوير أدوات نضالهم. هذا فضلاً عن وجود إقرار سياسي عالمي ومحلي بقضاياهم (فرضوه بالنضال ولم يأت من كرم أخلاق الدول التي تقمعهم)، رغم أن معاناتهم التاريخية لم تنته حتى اليوم.
تعلّمتُ الكثير في هذا اللقاء. ذُهلت من الروابط الوجدانية المتينة التي استطعنا بناءها بين بعضنا، من الدفء والقوة العاطفية التي تتحلى بها ثقافات السكان الأصليين، والتي تكاد تكون نقيض الثقافات الرأسمالية الباردة والأنانية التي تسود في الدول التي تسلبهم حقوقهم. بالمعنى السياسي/الثقافي، فكّرت كسوري لاجئ في أنني وجدت ضالّتي. ما شغلني هو قلة ما نعرفه عن بعضنا، نحن (أبناء وبنات الربيع العربي)، وهم (أصحاب المعركة التاريخية ضد الكولونيالية)، رغم التقاطع الفاقع بين الاستبداد والاستعمار في سياقاتنا، ورغم الجروح المتشابهة فيما بيننا، وانشغالنا وإياهم بقضايا الهوية والتروما وسبل النجاة والتعافي.
نحن بحاجة للاطلاع على هذه التجارب، لأننا في بلاد مثل كندا، يلزمنا التعلم عن أصحاب هذه البلاد كي لا ننجر دون دراية إلى صف قامعيهم. أدركتُ في فينيسا أن أهم ما يمكننا تعلمه من السكان الأصليين في هذه المرحلة هو كيف تطورت لديهم أدوات التعافي والتضامن والتنظيم وبناء المجتمعات، ذلك أن الصفعات مازالت ساخنة على نواصينا ولم نحظ بالوقت الكافي لاستيعاب ما يجري. التواجد بين السكان الأصليين جعلني أرى أوروبا بعيون مختلفة. صرت أرى التماثيل والمعالم المعمارية مكشوفاً على الجمال والألم في آن واحد. كل ما ازدادت هيبة الصرح ازداد إحساسي بالألم المطويّ في ظلّه. بعد أيام دافئة للغاية في فينسيا غادرت متجهاً إلى برلين، ومعي الكثير من الأسئلة حول النشاط العام والعلاقات التي تحكمه.
الجمال العدمي البرليني
“دارتِ الأرضُ دورتَها..
حَمَلَتْنا الشَّواديفُ من هدأةِ النهرِ
ألقتْ بنا في جداولِ أرضِ الغرابة
نتفرَّقُ بينَ حقولِ الأسى.. وحقولِ الصبابة”.
*أمل دنقل
تثير برلين مشاعر مختلطة لدى زائريها، وخاصة إن كانوا آتين من سياقات تشبه سياقاتنا، نحن أبناء الشتات والأحلام القتيلة. برلين واحدة من المدن التي لا يمكن فهمها أو وصفها ببساطة. مجازياً وواقعياً، فيها طبقتان من الألوان المتراكبة: الأولى فاقعة ومبهجة، والثانية رمادية وكئيبة. الاختلاط بالأصدقاء السوريين والفلسطينيين في برلين ذكرني بما كان بديهياً ومنطقياً: أننا لسنا على ما يُرام؛ أن العالم مستمر في سحقنا؛ وأننا، رغم ذلك، تواقون للونس والنجاة ونحب الحياة. بعد تجربة فينسيا، كانت برلين محفّزاً إضافياً للتفكير بعلاقاتنا كنشطاء وأبناء وبنات قضايا وعاملين/ات في الشأن العام.
زيارة برلين هي حلم للاجئين السوريين حول العالم، ففيها معظم من بقي من الأصدقاء والأقارب والزملاء في ظل صعوبة زيارة البلاد الأخرى. الحماس لزيارة برلين يغذيه شعور الافتقاد للرفاق المُتراكم في شتاءات المنافي الباردة. تفتح برلين الباب لزائريها على مشاعر دافئة وحميمية، ولكنها أيضاً مكان مربك ومعقد وله شجونه.
في برلين التجمع الأكبر للفاعلين في الشأن العام السوري بعد هبوط أسهم اسطنبول وبيروت وانتقال النشطاء والمنظمات إليها. فيها ملامح شتات سوري تقدمي ريادي ويمكن المراهنة على وجوده والاقتياد به، رغم الضياع الوجودي الذي يتسم به. في الزخم البرليني يزداد اتضاح محاولات السعي للموازنة بين الخلاص الفردي والخلاص العام، بيد أن هذين الخلاصين قد يتضاربان بسبب حدود القدرة لدى الأفراد على الاستيعاب والتحمل. في ضوء هذه الموازنة، يتكتلّ النشطاء وتتشكل دوائر ومجموعات من المنسجمين/ات مع بعضهم. بسبب كثافة حضور النشطاء والفنانين/ات، يوجد في برلين همّ عام استثنائي يميزها عن بقية المدن والبلدان التي يتوزع فيها اللاجئون، ولكنها تشترك مع بقية الأماكن في حضور الهمِّ الفردي والمعركة الذاتية التي يخوضها كل على حدة. مجزرة التضامن، وشاحنات المعتقلين، ومقتل شيرين أبو عاقلة كانت ثلاثة أحداث مهيمنة على الحديث العام. كانت هذه الأحداث القاسية مادة للتفكير والبوح، ولكنها أوضحت مدى الهشاشة التي يمكن أن نصل إليها حين نتعرض إلى كل هذا ونحن مكتّفو الأيدي. كثرة التعرض وقلة الحيلة وحدود القدرة على احتمال الأحداث والأشخاص يمكنها جزئياً تفسير “الشللية” البرلينية وتبرر الالتجاء إلى تبدية التعافي الذاتي أو الانسجام مع المحيط القريب على أي شيء آخر.
غير أنه في الزحام البرليني الذي يتسم بالكثافة والغنى والتنوع والصخب، هناك ما دفعني في التفكير بعلاقاتنا ببعضنا، كأصدقاء وزملاء ومعارف. لقد زرت برلين قادماً من كندا، التي يعد التواجد السوري فيها متواضعاً مقارنة بألمانيا. بسبب تواضع هذا الوجود، نشعر في كندا أحياناً أننا بحاجة بعضنا ونحاول ألا نزهد بالعلاقات الاجتماعية إلا للضرورة، وأن نتواصل بنوع ما من المرونة إذا لم يكن ثمة خلافات جوهرية بيننا في رؤية الأمور. في هذا الجو العام يجتمع ويتواصل من قد لا يجتمعون في ظروف أو أمكنة أخرى.
ما فكرت فيه في برلين هو ما يجمعنا ويفرقنا. بالتأكيد لا أتحدث هنا عن خيارات الناس في اختيار من يناسبهم/هن من أصدقاء ومحيط حيوي، بل أحاول التفكير فيما يفرق الناس أحياناً في الشأن العام. هناك اعتبارات وجيهة، سياسية وثقافية واجتماعية، من الممكن فهم دورها في تشكيل الجزر والدوائر البشرية المتباينة في الأوساط العامة. لا أرغب في التقليل من شأن هذه الاعتبارات أو الطعن في شرعيتها على الإطلاق، وإنما أحاول التفكير في الاعتبارات الأقل وجاهة من ذلك، والتي تؤدي إلى استسهال القطيعة والخصومة والعداوة أحياناً، وتصعّب الجمع العشوائي للناس على طاولة واحدة. دفعتني برلين للتساؤل إن كانت اعتبارات من هذا النوع، آتية من مواقف شخصية وحادة ولا يتم التفكير فيها أحياناً، هي اعتبارات نهائية أم أنها قابلة للرصد والتأمل، على الأقل في الدوائر المنسجمة فكرياً وسياسياً وأخلاقياً.
فوجئت في برلين بالعزلة التي يعيشها بعض الأصدقاء، إما بسبب الانشغال، أو بسبب عدم الراحة في التواجد في بعض الدوائر أو الانكشاف عليها. وكان واضحاً أن الأجواء العامة تحتاج إلى شيء من الرأفة واللطف والمراعاة والتفهم للذات والآخرين حتى يكون بناء العلاقات المتينة والدافئة متاحاً على نطاق أوسع.
لا يحتاج واحدنا كثيراً من الجهد لإيضاح كيف يمكن لهمّ كالهمّ السوري أن يسحق أهله ويدفعهم إلى الضياع والانهيار وفقدان القدرة على التحمّل. كأبناء وبنات لهذا الهم، يحتاج كل منا إلى المساحة الآمنة، وإلى الإحساس بالاشتراك والتضامن. كثير منا لا يمتلكون علاقات مثالية بعائلاتهم، وهذا العالم أقسى من أن يعيش فيه المسحوقون وحيدين وعُزّلاً. رغم الحب الغامر الذي شعرت به شخصياً مع الأصدقاء، إلا أنني شعرت في برلين أننا نحتاج إلى أوساط فيها القليل من الحنية واللطف، لا يُنتف فيها ريش أحدنا إذا لم يرتكب خطأً أخلاقياً فادحاً، ولا نعيش فيها كوابيس الإدانة على الصغائر والتوافه. هناك حصانة نفسية هائلة الأثر، نحن بأمس الحاجة إليها، تتأتى من الإحساس بالألفة والأمان والهمّ المشترك في أوساط رحيمة ومتفهمة.
خلق هذه الأوساط لن يكون سهلاً إذا لم نعمل كأفراد على تعافينا الذاتي وندرك ما نستطيع وما لا نستطيع تحمّله أو تحقيقه. هذه الملاحظات والأسئلة يمكن التفكير فيها في برلين وسواها، فجزء كبير من مأساتنا آت من افتقادنا للروابط المتينة التي يمكن التحصّن بها والبناء عليها، وهذا مردّه إلى تحطّمنا كأفراد وجماعات. في وضع مثالي، قد لا نكون مشغولين بأسئلة الهوية والنجاة والاتزان العاطفي، بيد أن الوضع ليس مثالياً وما زلنا نحاول. قد ينفع التفكير في مدى المرونة التي يمكن لنا أن نصل إليها في بناء علاقاتنا، وفي مدى الراحة الذي يمكن أن نؤمّنه لذواتنا حتى نستطيع تمريره إلى الآخرين على شكل قبول ودعم وتضامن.
…..
ثلاثة أسابيع مرت على عودتي من برلين، وما زلت معلّقاً في الهواء وأستصعب العودة إلى روتيني اليومي. هذا تحذير واضح للراغبين في زيارتها، فالإيغال في الفوضى البرلينية يعيد برمجة الجهاز العصبي لمن يعيشون في بلاد تؤخذ فيها الأمور على محمل الجد أكثر من اللازم. لا نزور برلين لأنها معلم سياحي وتاريخي، بل لأنها أميرة المنافي والبيت الدافئ لأحلامنا ورفاقنا؛ نزورها ونعود إليها ونهجس بها لأن من يعبر جسر الفارشاور شتغاسي مخموراً في ساعة الفجر يدوخ من رائحة البول الواخزة، ثم يفكر بالتبول على كل جسور العالم بسبب الجمال العدمي البرليني الذي ضرب مخيّلته.