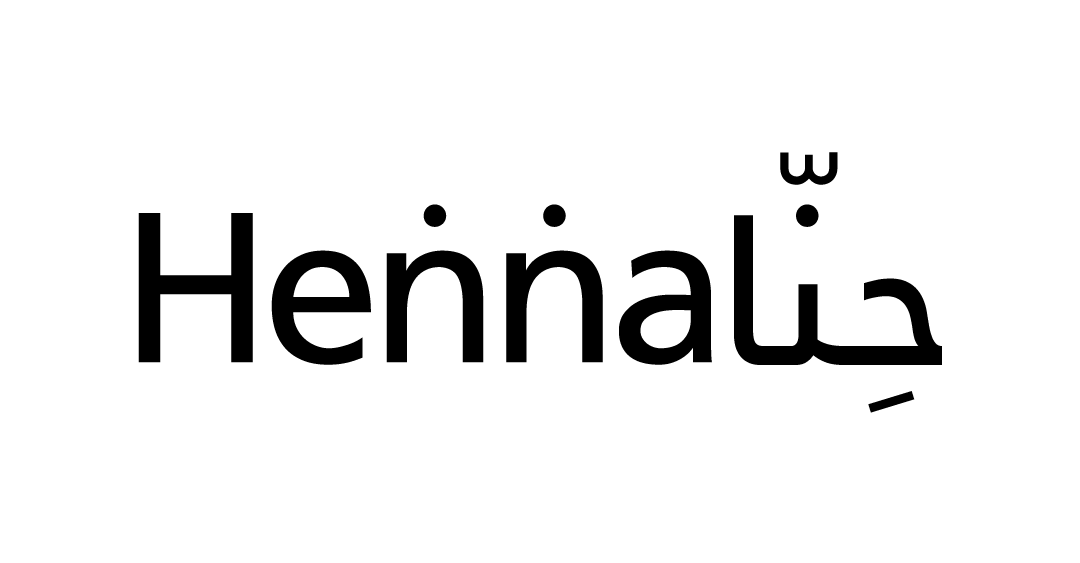القيامة في الجسد
كيف ننجو بعد تجارب الحرب والقمع في مجتمعات اللجوء؟

هذا المقال هو جزء من مجلة مفازة الرقمية التي تبحث في موضوع النجاة. تقرأون أيضاً فيها: جمهورية الأجساد الكليمة لنبيل محمد، حوكمة الأمل لحسين الشهابي، العالم ليس قرية صغيرة لرجا سليم، أن تهوي من اللامكان لنور موسى، نجاة الهوية في الشتات لعلا برقاوي، تأثيث الذاكرة لعلي زراقط، حين يفهمونك دون أن تضطر للكلام لشاونت رافي، والجروح الحية: عن الانتهاكات والمظلومية لساشا زاك.
____________________________________
كنانة عيسى
مدربة سورية كندية في مجال الصدمة النفسية وتمارين الحضور الذهني والعلاج الجسماني والعطف الذاتي. مختصة في مجال البرامج المجتمعية والتعليمية والبحث المجتمعي التشاركي. فنانة وكاتبة مقال وأدب وسيناريو. وزميلة فخرية لبرنامج جامعة أيوا للكتابة.
_____________________________________
تقف أذهان الناجين/ات عاجزة أمام فهم تجاربهم في النجاة من الحرب والقمع، فما بالنا بمحاولة إيجاد الحلول الأنجع للتعافي الفردي والجمعي أثناء استمرارنا بمحاولة النجاة؟ كان فهم النجاة العاطفية والذهنية أمراً يسكنني منذ طفولتي في دمشق، فقد كانت لوالدتي مكتبة مليئة بمراجع علم النفس، ومنها ما كان مبسطاً للأطفال. بعد وصولي سن النضج، وعلى الرغم من القيود السياسية في سورية والمنطقة عموماً، ساعدتني الأقدار للعمل مع مجموعات نشاط مدنية تهتم بتفعيل ثقافة المواطنة كشكل من أشكال النجاة الذهنية والعاطفية، وبالبدء في تأسيس مجموعات جديدة أيضاً. في عام ٢٠١١، شهدت البلاد موجة احتجاجات على قمع الأجهزة الأمنية، وخلال وقت قصير تحول القمع إلى حرب. دفعني التزامي بالمجتمع المدني حينها إلى مضاعفة جهودي في مجال المواطنة المدنية والأعمال الإنسانية، وهو أمر لم يكن محمود العقبى لدى الأطراف المستفيدة والمصعّدة للحرب، مما دفعني للخروج من البلاد. أثناء رحلة الشتات، كانت غريزتي الأولى هي الاستمرار بالعمل المدني عبر دعم الضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة في البلدان التي مررت بها في رحلة اللجوء. لم أدرك أثناء هذه العملية كمّ الضغط والتعنيف الذاتي الذي مارسته على نفسي لعدم قدرتي على إيجاد حلول جذرية لما يمر به أهل بلادي في سوريا ودول الشتات. بعد بحث طويل، والتزام بالتدريب المختص على وسائل التعافي من الصدمات بالإضافة للعمل مع مجتمعات أخرى، فهمت أن الصدمة أنستني واقعي البشري كفرد بجسد هش ومحدود القدرة. كلما أخذتني قدماي خطوة جديدة على درب التعلم، سامحت نفسي أكثر قليلاً وأعدتها للواقع، مذكرة إياها بدور المجموع البشري من مؤسسات وقوى سياسية في هذه العملية، بالإضافة لدوري ودور مجتمعي. الاعتماد على الذات أمر مهم، ولكن له حدود. إيجاد حلول رحيمة لواقعنا البشري المأساوي أمرٌ يحتاج تكاتف جهودنا جميعاً.
تطورت حضارتنا الإنسانية عبر القرون مدفوعة بالحاجة لحماية هشاشتنا الفردية وضمان عافية المجتمع واستمراره بالحياة والعطاء. ولذلك تتمحور حياة معظم البشر حول شبكات حماية اجتماعية أو مؤسساتية. تنص نظرية العقد الاجتماعي التي تم تطويرها من قبل عدة فلاسفة كتوماس هوبز وجان جاك روسو على أن الأفراد مستعدون للتخلي عن بعض الحريات مقابل الحماية وضمان الانتظام الاجتماعي. هذا في وقت الرخاء، أما عند حدوث الكوارث السياسية كالقمع والحرب يتغير كل شيء. تصير المجتمعات والمؤسسات مصادر للخوف. يصير كل فرد معزولاً بجسده الهش، ليس فقط أمام الأسلحة الثقيلة والخراب الشامل، بل أيضاً أمام الوحشية والهمجية التي يشهدها يومياً من كانوا جيراناً وأصدقاء. حتى العائلة والجيران وشبكات الدعم الاجتماعي والعاطفي قد ينصاعون للعنف البنيوي، وهو مفهوم قدمه عالم الاجتماع النرويجي جوهان غالتونغ قائلأ إن هذا العنف يقع حين تقوم بعض المؤسسات والبنى الاجتماعية بإيذاء الناس وتعريضهم للظلم بشكل تلقائي. يضيف غالتونغ أنه في وقت الشدائد الكبرى تصير هذه البنى “مشحونة بالعنف البنيوي الذي يزيد من معدلات العنف الفردي بالمقابل”.
في هذه المقالة، وعبر السرديات الشخصية وغيرها المستندة إلى البحث المنهجي، سأقوم باستكشاف تعقيدات عملية نجاة اللاجئين من العنف المباشر وغير المباشر قبل وبعد وصولهم إلى دول اللجوء. قد يكون العنف ثقافياً أو بنيوياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً، ومنه ما هو ذاتي يوجهه الضحايا لأنفسهم. سأقوم بالمساءلة النقدية لبعض الطرق التي يتم بها التعامل مع آثار صدمات العنف من جانب اللاجئين أنفسهم، ومن جانب المجتمعات والمؤسسات التي تعمل معهم، وذلك عبر استخدامي لمنهجية متعددة المرجعيات الثقافية لا تعمل على إطلاق الأحكام بقدر تفكيكها للواقع وفهمه. علاوة على ذلك، سأطرح بعض المفاهيم المعاصرة عن الصدمة النفسية ووسائل التعافي من الصدمة الفردية والجمعية التي نحتاجها في مجتمعات اللجوء.
العنف البنيوي، والقمع، والحرب
كي نتمكن من فهم تجربة اللاجئين وغيرهم من أفراد المجتمعات الملونة في الغرب، سنحتاج لتناول بعض المفاهيم في البدء. أول هذه المفاهيم هو العنف البنيوي، وهو مجموعة من الممارسات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية غير العادلة التي تلحق الأذى بأفراد أو مجموعات معينة. بعكس العنف المباشر الذي يتضمن الأذى الجسدي أو العنف اللفظي، تصعب رؤية العنف البنيوي، فهو يأتي منضوياً في المنظومة التي تقود حياة البشر ومؤسساتها وعاداتها الثقافية. يعمل العنف البنيوي على تهميش مجموعات بعينها وتقليص قدرتها على الوصول إلى الموارد والفرص والحقوق. هذا العنف يُحْدِث صدمات نفسية ممنهجة تُلْحِق الضرر النفسي والاقتصادي والروحي والجسدي والجنسي بأفراد أو مجموعات بعينها. العنف الذي تتسبب به الدولة هو شكل مكثف من أشكال العنف البنيوي الذي يطال المجتمعات ويتسبب بأشكال متعددة من الخلخلة والعنف المجتمعيين. كثير من علماء المشرق، كرائد النهضة العربية عبد الرحمن الكواكبي، قاموا بتحليل الأنظمة الاستبدادية. يتحدث الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (1899)، والذي يعتبر مرجعاً كلاسيكياً لكثيرين من الناطقين بالعربية، عن الطريقة التي يتحول عنف الدولة فيها إلى شكل من أشكال القمع الذي يُسْكِت من يعارضه ويخنق أي مطالب بالتغيير والإصلاح. يقول الكواكبي إن الاستبداد “يقلب الحقائق فى الأذهان، فيسوق الناس إلى اعتقاد أن طالب الحق فاجر، وتارك حقه مُطيع، والمُشتكي المُتظلم مُفسِد، والنبيه المُدقق مُلحد”.
في المقابل، يحدث العنف الذاتي أو المُبَطَّن1 عندما تمارس المجموعات المُعنَّفة القمع ضد ذاتها، وبالتالي تصدّر هذا العنف مجدداً ضد الغير. لكن حدوث هذا لا يعني انعدام المقاومة لمنظومة العنف، إذ يناهض البشر هذا الأثر اللاإنساني للعنف كي لا يتحولوا إلى طغاة بدورهم. تؤكد النظريات الاجتماعية النقدية على استقلالية الأفراد المقموعين وقدرتهم على مقاومة النظم القمعية. فمثلاً نجد في لدى الكاتبة الأمريكية السوداء القديرة بيل هوكس ما يقول إن المقموعين قادرون على استعادة إنسانيتهم ومقاومة تبطين العادات القمعية عبر التأمل والمراجعة الذاتيين والحوار والمساءلة واستعادة السيطرة على حياتهم. لكن هذا النوع من المقاومة له ثمن باهض أيضاً. فالعنف البنيوي يفرض أشكالاً مدمرة من الأذى المعنوي ويحول العادات الثقافية والمعتقدات إلى أدوات لتبرير للفظائع. وفي زمن الحرب والقمع يصير العنف موجهاً نحو قطاعات كبيرة من المجتمع.
القيامة في الأجساد
لا أجد أنه من الممكن فهم تجربة النجاة من الحرب دون توصيف ما يجري في جسد الناجي وذهنه، ففظائع الحرب ترسم داخل كل جسدٍ مشهداً خاصاً عن نهاية العالم، أو يوم القيامة، يستمر الناجي بحملها أينما ذهب. آثار الحرب العميقة لا تتغلغل في النفس إلا بعد ارتجاف فيزيولوجي يعيشه الجسد أمام آلات الحرب الثقيلة الذي يصم دويها المسامع. يتغلغل الضغط الناجم عن ترددات الانفجارات في ذرات الجسم ليهتز معها في وحدة حال ويحمل ذكراها حيثما حلّ وارتحل. بعد كل هذا، يتعلم الدماغ أن لأصوات بكاء الأطفال والضحايا أثراً عنيفاً على الجسد لا على النفس وحدها. ننجو من الحرب بأجساد مضطربة ومشاعر عنيفة مثقلة بالخسارة والذنب تجاه الأصدقاء والأهل الذين مازالوا تحت القصف. نحفر في مستنقعات الألم التي نعيشها بحثاً عن قوة داخلية ما تحمينا وتحفظ كرامتنا كبشر في الوقت الذي ترانا فيه الأخبار ككتلة واحدة من الضحايا بلا أسماء وشخصيات. لكننا نستمر في قلب العتمة والخوف بالمضي نحو الأمام، تدفعنا طاقة خفية ما لإيجاد طريق نجاة لأنفسنا ولمن نحب والاحتفاظ بأمل الوصول للحرية وبزوغ فجر جديد.
أنظمة البلاد الجديدة
يتمكن بعضنا من الوصول إلى أرض جديدة، لكن هذا لا يعني الوصول إلى الاستقرار والأمان. على المستوى الشخصي، وعلى الرغم من كوني كاتبة وفنانة وعاملة في القطاع الإنساني تتحدث الانكليزية بطلاقة، كان من الصعب علي البدء بحياتي الجديدة في كندا. على الرغم من استقبال كندا لي بمحبة ولطف شديدين، لم تكن إعادة التوطين نزهة ممتعة. على سبيل المثال، لم يكن طلب المحامية استذكار تفاصيل دقيقة عن سبب طلبي للجوء أمراً سهلاً. لقد تسبب هذا الطلب بتشنج مؤلم في جسدي قاد إلى زيادة في فرط التنبه والإنهاك المتزامنين مع تعنت الذاكرة ورفضها للتعاون. كانت سوريا حينها، ومازالت حتى اليوم، تأكلها النيران التي تشعرني بالعجز وقلة الحيلة، في حين كانت بعض الذكريات ضبابية لاقترانها بالألم. على الرغم من قدرتي على بناء العلاقات الاجتماعية والمهنية، كنت أعيش حالة عزلة داخل نفسي بشكل مستمر. لم يكن بإمكاني فهم مشكلتي حينها إلى أن بدأت بتدريب طويل في مجالات الصدمة النفسية وتمارين الحضور الذهني والعلاج الجسدي للصدمة وتمارين العطف الذاتي.
البحث عن الخلاص الفردي ليس أمراً سهلاً كما نظن. تقول الرائدة في مجال علاج الصدمة النفسية جوديث هرمان في كتابها المرجعي الصدمة والتعافي (1992) إن التعافي “يحدث فقط في إطار العلاقات مع الآخرين، ولا يمكن حدوثه في معزل عنهم”. مع الزمن تمكنت من تعميق فهمي للصدمة النفسية على أنها حالة جسدية بقدر كونها نفسية، ولا تكفي قوة الإرادة وحدها للتعامل معها. لم يكن ذلك ممكناً إلا بعد الدراسة والبحث والتعرف على أعمال خبراء الصدمة والعمل مع اللاجئين وغيرهم من ضحايا العنف. بإمكان قوة الإرادة كبت مفرزات الصدمة ودفعها بعيداً عن ساحة الوعي لفترة مؤقتة، لكن هذا لا يمنعها من التخمر في اللاوعي لتخرج في النهاية على شكل أعراض جسدية وصحية وذهنية. يؤكد الخبير الكندي المعروف في مجال الصدمة النفسية غابور ماتي في كتابه حكمة الصدمة (2001) على أن “تفادي التعامل مع الصدمة يقتضي صرفاً هائلاً للطاقة لمنعنا من الشعور بالألم الناجم عنها. مع البدء بالتعافي تبدأ هذه الطاقة بالتحرر والتحول إلى طاقة فاعلة في الحياة… المشاعر المكبوتة لا تختفي، بل تجد طريقةً للتعبير عن نفسها على شكل أمراض جسدية”.
تعلمت أثناء رحلتي بأننا نحتاج أثناء محاولتنا لإيجاد الخلاص الجماعي العمل على إيجاد مساحات اجتماعية وعاطفية أشد أماناً2 لتعزيز قدرتنا الداخلية على قبول المشاعر الصعبة والشعور بها والتعامل معها. هذا أمر ضروري ليس فقط للاجئين أو الناجين أنفسهم، بل للمجتمعات التي تستقبلهم أيضاً،3 مما يشكل تحدياً كبيراً لغالبية السرديات الثقافية في الغرب. في كتاب الطريق الواعي للعطف الذاتي (2009)، يقول عالم النفس الأمريكي كريستوفر جيرمر الذي ساهم في تطوير طرق الحضور الذهني للتعاطف مع الذات إن “التعاطف مع الذات يفسح لنا مجالاً لنحس بمشاعرنا ونفهمها دون الخوف من الغرق فيها”. عند تطوير قدرتنا على التعاطف مع الذات والآخر نتمكن من زيادة قوتنا العاطفية للتعامل مع الصدمات والمشاعر المؤلمة الناتجة عنها. يحتاج الجسد لدعم منا كي يتمكن من احتمالها وحملنا معها ومساعدتنا على الوصول إلى ما يسمى بنمو ما بعد الصدمة أو حكمة ما بعد الصدمة. هناك مدرسة علاجية للصدمات تسمى مدرسة العلاج الجسدي تركز على الآثار الجسدية للصدمة، وقد غيرت هذه المدرسة طريقتنا لفهم الصدمات وعلاجها. يركز الرائد في تأسيس هذه المدرسة، عالم النفس الأمريكي بيتر ليفين، على أن الطريقة التي نتعامل فيها مع الصدمة هي المفتاح لباب التعافي والنمو بعد التعرض لها، أو العكس. يقول في كتابه بصوت غير مسموع: كيف يتخلص الجسد من الصدمة ويستعيد الإيجابية (2010) إن التناقض الجوهري الذي تحمله الصدمات يكمن في “قدرتها على الهدم والتدمير، وقدرتها على الإحياء وإعادة البناء”.
تلعب المؤسسات والأنظمة والعاملون فيها دوراً محورياً في تأمين مساحات أكثر أماناً، واعية بالصدمة وثقافة الناجين، لتعزيز القدرة على الوصول إلى حكمة ما بعد الصدمة. التأقلم مع الحياة في مكان جديدٍ قد يكون منهكاً للغاية بعد كل هذه التجارب، حيث يحاول الأفراد الذين انتُزعوا من مجتمعاتهم تعلم العادات الثقافية والاجتماعية للبلد الجديد وتجاوز حواجز اللغة والمعاملات البيروقراطية، فضلاً عن محاولة فهم تجاربهم وإنقاذ بلادهم وأحبابهم. في كندا مثلاً هنالك كثير من الخدمات المقدمة للاجئين، كبرامج إعادة التوطين والصحة النفسية والمؤسسات المجتمعية. لكن هذه الخدمات غير مهيئة غالباً للتعامل مع الاحتياجات المركبة والمتعددة لأفراد يعيشون في أجساد وأذهان مصدومة. مازال هنالك نقص في التدريب الحساس للصدمات في مؤسسات إعادة التوطين والمؤسسات المجتمعية وخدمات التوظيف والقطاعات الصحية ومؤسسات التعليم المتنوعة. يتوجب أن يتم ترميم هذه الفجوة بالتعاون مع الناجين/ات أنفسهم ووضع تجاربهم وأصواتهم في المركز كقادة واستشاريين وصناع للتغيير.
هنالك كثير من الدراسات عن اللاجئين/ات تؤكد على الحاجة إلى خدمات تفهم الثقافة والظروف وخصوصية الصدمة. يشعر كثير من اللاجئين بضغط للانصياع للتوقعات المجتمعية الجديدة، وقد يكون ذلك على حساب هويتهم الثقافية وشخصياتهم. دينش بوجرا، المحاضر في مجال الصحة النفسية في جامعة كينغ بلندن، نشر عدة دراسات وكُتُب عن هذه المسألة. في مقال له بعنوان الهجرة والكرب والهوية الثقافية (2004) يبحث بوجرا في كيفية مساهمة مجهود اللاجئين للاندماج في زيادة شعورهم بالغربة واضطراب الهوية والكرب النفسي. من تجربتي الشخصية مع اللجوء والعمل مع اللاجئين، أعلم أننا نشعر باللوم لعدم قدرتنا على التعبيرعن احتياجاتنا بطريقة واضحة ومباشرة، أو عدم قدرتنا على التجاوب مع بعض الحلول التي نجعت مع آخرين، على الرغم من أن هذه الحلول لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل فرد من النواحي العصبية والشخصية وقدراتهم وتجاربهم الفردية.
الجروح الجماعية
التفكير باللاجيء كفرد مطلوب منه التماهي بشكل كامل مع المجتمع الجديد ليس سديداً. في بحث عنوانه تفكيك الحوارات الكندية عن اندماج اللاجئين (٢٠٠٣) ينتقد بيتر إس لي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ساسكاتشوان في كندا، حالة الامتصاص الثقافي المرتبطة بعملية إعادة التوطين. يدعو لي إلى الوصول إلى علاقة تحترم هوية اللاجئين الثقافية وروابطهم الاجتماعية، منتقداً السرديات التي تفضل التماهي مع الثقافة السائدة على حساب التنوع الثقافي، وداعياً إلى سياسات تعمل على استيعاب الجميع وتحافظ على التماسك الاجتماعي. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (2014) نشرت ورقة تناقش أهمية مراعاة سياسات الاندماج احتياجات كافة الأطراف، داعيةً إلى العمل على تأقلم اللاجئين مع المجتمع الجديد دون الاضطرار للتخلي عن هويتهم الثقافية، وحاثّةً المجتمعات المستقبلة على الترحيب باللاجئين وتحقيق احتياجاتهم المتنوعة ثقافياً.
عندما يمر الفرد بصدمة نفسية، غالباً ما يشكل مجتمعه وهويته/ا الثقافية وصداقاته نسيجاً قد يساعد على التعافي. لكن عندما تمر المجتمعات والهويات بالصدمات أيضاً يصبح التعافي صعباً للغاية. في كتاب الصدمة والتعافي على حدود الحرب لكاثلين ألدين ونانسي موكامي، نقرأ عن التقاطع ما بين الصدمة الجمعية والفردية وعلاقتها بالصمود المجتمعي. يتحدث الكتاب عن الكيفية التي يتعقد فيها التعافي الفردي وتطول مدة بلوغه عند حدوث الصدمة الجماعية. فالجماعة تساعد الأفراد على صياغة سرديات تساعدهم على فهم الصدمات وإيجاد طرق للشهادة عليها، وهي أمور ضرورية لاستيعاب وتجاوز الأحداث الصادمة ضمن الذاكرتين الفردية والجماعية. بعد الحرب والقمع غالباً ما تواجه المجتمعات والجماعات تحديات في إعادة بناء تماسكها وبدء العمل الجماعي الضروري لتعافي أفرادها. بإمكان التجارب الصادمة تفكيك النسيج المجتمعي وهدم الثقة والتجانس والبنى الاجتماعية بما يترك أفرادها في حالة من العزلة والهشاشة.
يعمل اللاجئون على إطلاق المبادرات لدعم بعضهم/ن والمساهمة في المجتمعات المستقبلة لهم/نّ وخلق المعرفة بطرق مبدعة. المنصة التي أكتب لها الآن، منصة حِنَّا، هي مثال على ذلك. عند التفكير بالمجتمع السوري أجد بأن جهوده في السنوات الأولى من اللجوء كانت مركزة على بناء جسور مع المجتمع الكندي وإيجاد سبل البقاء، بالتوازي مع دعم أهاليهم وبلادهم في الطرف المقابل من الكوكب. مع الزمن بات من الواضح بالنسبة لهم/نّ أن النجاة النفسية تحتاج حضور آخرين يشاركونهم/نّ الجرح ذاته كي يتمكنوا من الاستمرار. دون التجمع والتكامل ليس بإمكاننا إيجاد حكمة أو معنى متجانسين لتنشاركهما مع مجتمعاتنا أو المجتمعات المستقبلة لنا أو العالم بشكل عام. في كتاب الصدمة والتعافي تقول جوديث هرمان إن الناجين من الصدمات غالباً ما يستندون إلى سردياتهم الشخصية والمشتركة لاستعادة سيطرتهم على تجاربهم وفهم شرعية معاناتهم والتأسيس لشكل من أشكال التناسق والمعنى في حياتهم بعد التعرض للعنف. كي نتمكن من الوصول إلى التعافي سنحتاج إلى مساحات أكثر أمناً وشجاعةً لمشاركة التجارب وفهم المشاعر والحصول على بعض القوة من التضامن الجمعي. يحتاج الوصول إلى هذه المساحات طرق تفاعل واعية بالصدمات من ضمن ثقافة الناجين، قادرة على تدعيم الأفراد كي يستخدموا الفكر النقدي والسرد الذاتي ضمن خصوصيتهم الثقافية. ويتضمن ذلك أيضاً تدعيمهم لإيجاد طرق صياغة المعنى الجمعي الخاصة بهم والتي تمكنهم من استيعاب تجاربهم بقدر ما تمكنهم من ترميم الصلات الاجتماعية المهدمة ضمن المجتمع ذاته وبناء الجسور مع المجتمعات الأخرى.
في تجارب إعادة توطين مقلقة تتحدث لشونا لابمان، المختصة بقوانين اللجوء، عن السرديات التي تدعي أنه بإمكان اللاجئين النجاح في البلاد الجديدة عبر جهودهم الفردية وحدها. في هذا البحث وغيره تقوم لابمان بالحديث عن العوائق التي تضعها المنظومة السياسية والمجتمعية في وجه اللاجئ، كصعوبة القبول بشهاداتهم العلمية ودخول سوق العمل، إضافة إلى التمييز المجتمعي الذين يزعزع قدرة اللاجئ على الازدهار. بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أرى أن الاعتماد على الذات مهم دوماً طالما أننا منطقيون بتوقعاتنا. فللمجتمعات التي اختبرت الصدمة قوى وقدرات تدعم صمودها وتعافيها على الرغم من الجراح والعوائق المقامة في وجهها. جهود التعافي الجمعي المستندة على الإرث الثقافي وتضامن المجتمع وشبكاته المجتمعية هي أمور ضرورية لإيجاد التعافي واستعادة الثقة والاحساس بالأمل والاستقلالية.
هنالك منظور آخر أجده ناقصاً في معظم الأعمال البحثية والأكاديمية على الرغم من بديهيته، وهو الحديث عن الحب. قليل من الباحثين/ات تمكنوا من إيجاد السياق المنهجي لطرحه بسبب طبيعة الحب المركبة. تمكنت الكاتبة والناقدة الأمريكية السوداء القديرة بيل هوكس من الحديث عن هذا الأمر بطريقة فريدة في كتابها كل ما يتعلق بالحب (1999). الحب بالنسبة لهوكس جوهري في عملية التعافي لدى المجتمعات والأفراد المتضررة من صدمات العنف والقمع. تركز هوكس على أن الحب يتجاوز كونه شعوراً، فهو ممارسة وخيار فاعلين. تنتقد هوكس أيضاً الطريقة التي تحصر مجتمعاتنا المعاصرة الحب فيها بأشكاله الرومنسية فيما تهمل عناصره الأكثر عمقاً وجوهرية في الحياة البشرية. فكثيراً ما يتم ربط الحب بديناميكيات القوة والسيطرة عوضاً عن الاحترام والمساواة. عبر أخذ هذه العناصر بالحسبان، آمنت هوكس بقدرة الحب وقوته الفاعلة في تعافي المجتمعات والأفراد، وأهمية دوره في التغيير المجتمعي والشخصي.
لا يمكن فصل الجمعي عن الشخصي، في الوطن الأصلي أو في بلاد اللجوء. اللاجئون هم في حالة بحث مستمرة عن الانتماء الذي لا يتمكنون من إدراكه بسبب جراحهم. حتى نتمكن من الشعور بالانتماء نحتاج إلى العمل على خلق بيئة تساعد على تنمية القدرة الداخلية على قبول المشاعر الصعبة والتعامل معها كي لا تستمر بعرقلتنا. البعض قد يظن أن التعافي هو التوقف عن الشعور بالعواطف القوية والصعبة كالغضب والخوف والحزن، وهذا الفهم الخاطىء قد يقود إلى توقعات غير منطقية من قبل المصابين بالصدمة أو العاملين معهم/نّ. التعافي هو الوصول إلى حالة ارتياح للشعور بهذه العواطف وفهم ما تحاول إيصاله لنا عن طبيعة تجاربنا وما نحتاج إلى إيلائه الاهتمام، وهذا ما يوصلنا إلى حكمة ما بعد الصدمة. خلق مساحات أكثر أماناً للوصول إلى التعافي والانتماء يحتاج إلى إعادة مراجعة نظام القيم الذي نعيش في إطاره وتعزيز معرفتها بديناميات الصدمة والتعافي والتضامن. الوصول إلى ذلك لا يتحقق بتأمين مساحة فيزيولوجية بإشراف اختصاصيين، بل يحتاج إلى إعادة بناء نظام القيم بطريقة منبثقة من ثقافة اللاجئين أنفسهم، دون إهمال العطف الذاتي والحب كعناصر جوهرية في هذه العملية. اللاجئون هم ناجون، والوصول إلى مخازنهم الدفينة من حكمة ما بعد الصدمة يحتاج فهماً واحتراماً وتعاوناً وقدرة على مراجعة الذات، ومعرفة يكون الحب أحد محاورها الأساسية.
المراجع
عبدالرحمن الكواكبي (١٨٩٩) “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”.
فريري (١٩٦٨)، “منهجية تعليم المضطهدين”.
جوهان غالتنغ (١٩٦٩) العنف، والسلام، وبحوثات السلام.
بيل هوكس (١٩٩٩) “كل شيء عن الحب: رؤى جديدة”. (١٩٩٤)، “التدريس من أجل التغيير: التعليم كممارسة للحرية”. (٢٠٠٣)، “التعليم في المجتمع: منهجية لصناعة الأمل”.
جوديث لويس هرمان (١٩٩٢) “الصدمة والتعافي: إرهاصات العنف – من العنف المنزلي إلى الإرهاب السياسي”
غابور ماتي (٢٠٢١) “حكمة الصدمة”.
كريستوفر جيرمر (٢٠٠٩) “الطريق الواعي للعطف الذاتي: تحرير الذات من الأفكار والمشاعر الهدامة”.
بيتر ليفين (٢٠١٠)، “بصوت غير مسموع: كيف يتخلص الجسد من الصدمة ويستعيد الإيجابية”.
مفوضية الصحة النفسية في كندا (٢٠١٦) “دعم الصحة النفسية للاجئين في كندا”.
بوغرا (٢٠٠٤)، “الهجرة والكرب والهوية الثقافية”.
لي (٢٠٠٣)، “تفكيك الحوارات الكندية عن اندماج اللاجئين”
كاثلين ألدن ونانسي موكامي (٢٠١٥) “الصدمة والتعافي على حدود الحرب: دليل لعاملي الصحة العالميين”.
شونا لابمان (٢٠١٢) “على حدود القانون: تجارب إعادة توطين مقلقة”.
- للتوسع في الموضوع، بالإمكان الرجوع لكتاب باولو فريري “منهجية تعليم المضطهدين” (١٩٦٨).
↩︎ - خاص بالنسخة العربية: المساحة الأشد أماناً مأخوذ من مفهوم المساحة الآمنة، وهو مفهوم نسبي وقد يكون خادعاً في كثير من الحالات. يتم استبداله لدى بعض المختصين في مجال العدالة الاجتماعية بمفهوم المساحة الشُّجاعة أو المساحة الأشد أماناً. بمعنى أنها أشد أماناً من غيرها لا أنها آمنة بشكل كامل، والشُّجاعة بمعنى أنها تساعد المشارك فيها على إيجاد الشجاعة في داخله والمشاركة بحذر حتى ولو لا توجد مساحة آمنة كلياً. تنص فكرة المساحة الآمنة على أنها مكان يستطيع الفرد مشاركة مشاعره وأفكاره دون التعرض للمحاكمة من الباقي أو التعرض للعنف والتنمر بسبب ما يقول، وفي بعض الحالات تعني أنه لا يتم مشاركة ما يقال خارج المجموعة.
↩︎ - خاص بالنسخة العربية: قد تبدو الفكرة غريبة في البداية، لكن تبين معظم الدراسات المعاصرة أن العنف والتمييز وإطلاق الأحكام وعدم القدرة على تقبل اختلاف الآخرين تأتي من عدم قدرة الفرد على الشعور بمشاعره وقبول جوانب معينة من شخصيته. وكلما زادت قدرة الفرد على قبول نفسه كلما زادت قدرته على قبول الآخرين.
↩︎