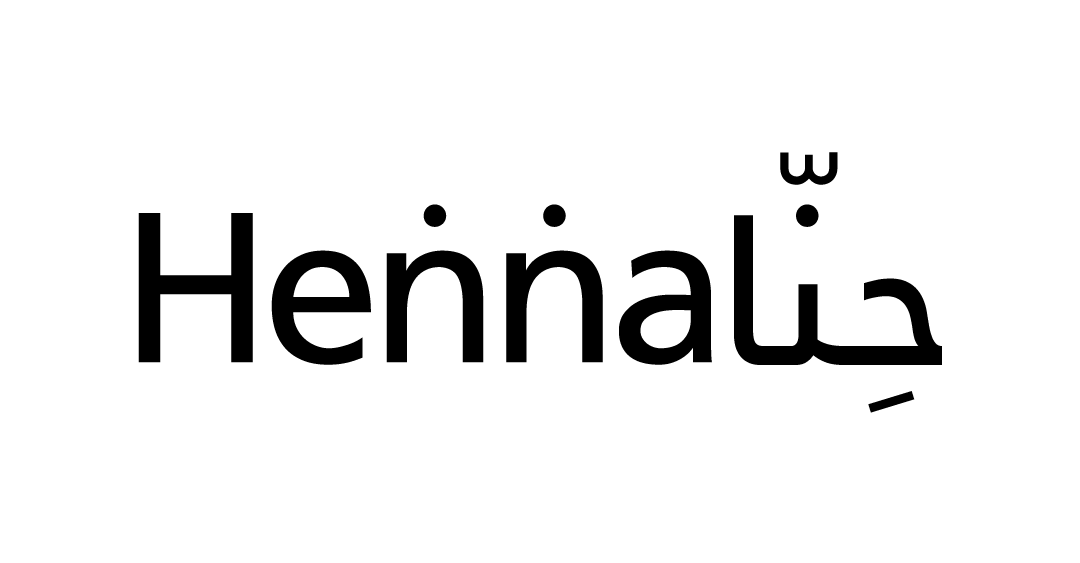الخوف كهوية مشتركة
تأملات في جريمة لندن-أونتاريو بعد عام على حدوثها
نورا موسى
كاتبة فلسطينية-سورية مقيمة في كندا
في مساء السادس من حزيران السنة الماضية، لم تكن عائلة أفضال تعرف أن هناك من تشرّب الكره الكافي لملاحقة خطواتهم وقتلهم على ناصية طريق. لم تكن عائلة أفضال تعرف أن نزهتها المسائية ستنتهي بالموت. استهدف شاب عائلة أفضال بسيارته بسبب معاداته للمسلمين، وقتل أربعة أفراد من العائلة: سلمان (46 عاماً)، وزوجته مديحة (44 عاماً)، وابنتهما يمنى (15 عاماً)، والجدة طلعت (74 عاماً). الناجي الوحيد من هذه الجريمة كان فايز، الطفل الأصغر في العائلة الذي سيُتم هذه السنة عامه العاشر. منذ ذاك اليوم تكون قد مرت سنة كاملة على فايز بدون والديه وأخته وجدته.
وُجهت إلى القاتل (21 عاماً) أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى بالإضافة إلى تهمة محاولة القتل، مما جعله أخطر قاتل جماعي في تاريخ لندن-أونتاريو. من المقرر أن تبدأ محاكمة ناثانيال فيلتمان في 5 أيلول 2022 حيث وجهت له تهم ارتكاب أعمال قتل إرهابية.
رغم أن جريمة اغتيال عائلة أفضال ليست الجريمة الإرهابية الأولى التي كان ضحاياها من المسلمين في كندا، إلا أن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها توصيف جريمة معادية للإسلام على أنها جريمة إرهابية بشكل رسمي. أصبحت كلمة إرهاب مرادفة لكلمة مسلم في مخيلة الكثيرين بسبب الصورة النمطية التي يُقدم بها المسلم والمسلمة في الإعلام الغربي، وصار من السهل تجييش مشاعر الكراهية ضد الإسلام ضمن المجموعات المتطرفة والعنصرية التي لها تاريخ في كندا. علاوة على ذلك، يتضح هذا الضخ الإعلامي المعادي للمسلمين في نشرات الأخبار وعروض الكوميديا والأفلام والمسلسلات التي تحظى بانتشار عالمي، وقد ساهم في وضع قالب واحد لجميع المسلمات والمسلمين وإنكار وجود التنوع الفكري والثقافي في البلاد ذات الغالبية المسلمة.
الإيمان والمعتقد والهوية هي أمور مركبة بتعقيد لا يخلو من المفارقات، لكن بالنسبة للقاتل يصبح معنى الهوية أمراً بمنتهى البساطة والسطحية عندما يحاول أن يختار ضحاياه. أمام القاتل تصبح كل تعقيداتنا مبسطة في الصورة التي رسمها لنا. لكن الجدير بالانتباه هو أن سطحية هذه التصنيفات لا تقتصر على مخيلة القاتل، فهذه التصنيفات تعد قوالب جاهزة ستحدد هوية الأفراد وتُدخلهم في تصنيفات الأقليات بناء على معايير مثل اللون والأثنية والمعتقد. هذه التصنيفات هي أمر مألوف عند تعبئة أية طلبات واستمارات للحكومة أو الجامعات، أو حتى عند التقدم بطلب توظيف في بعض المؤسسات.
المفارقة في هذه التصنيفات هي أنها لا تهتم لفردانية الأشخاص المحسوبين على هذه المجموعات، في بلاد يغلب فيها النمط الفرداني على النظام الاجتماعي والاقتصادي. فإذا أردنا أن نتأمل في مثال المعتقد والدين، فإن علاقة الفرد مع الدين قد تختلف خلال مراحل الحياة المتنوعة. وعلى صعيد الجماعات، نستطيع ملاحظة مذاهب ومدارس متنوعة ضمن كل جماعة تتبع لدين معين. الأمر ينطبق على التصنيفات الأخرى التي تؤطر هوية الأفراد ضمن هوايات تحصر انتماءاتهم الدينية أوالإثنية. التصنيفات التي تحدد مواصفات الجماعات تختزل خصوصية الأفراد بأنماط لا تخلو من التعميم والتسطيح.
بالرغم من أن هذه التصنيفات باتت عالمية ولا تقتصر على كندا، إلا أنها تقول الكثير عن الواقع الكندي. هذه التصنيفات هي انعكاس لماضٍ استعماري و عنصري ما زالت آثاره ظاهرة في الحاضر، فهي تحيل دوماً إلى واقع كندا كبلد استعماري يحاول تقديم نفسه على أنه أمة من المهاجرين الذين يحتفلون بتعدد ألوانهم وثقافتهم ومعتقداتهم؛ بلد المهاجرين هذا ما زال يرى انتماءات وهوايات أفراده بحسب تصنيفات لا تخلو من العنصرية والفكر الاستشراقي.
تعتمد كندا مصطلح “الأقليات المرئية” الذي يشير إلى الأشخاص الذين يُميَّزون على أساس العرق. يشير توصيف “الأقليات المرئية” إلى كل الأفراد والجماعات التي لا تُنسب إلى البيض أو إلى الشعوب الأصلية. ورغم أن هذا المصطلح لا يشمل الديانات، لكنه ساعد في خلق وترسيخ صور نمطية تربط ما بين إثنية ولون الفرد و معتقداته الدينية و عاداته الاجتماعية. فقاتل عائلة أفضال، قام باستهداف العائلة بناء على صورة نمطية جعلته يربط ما بين لون بشرتهم ولباسهم وبين معتقدات يراها تشكل خطراً. قاتل عائلة أفضال لم يتعرف على هذه العائلة عن قرب، قام بتحديدهم كضحايا له من خلال ما كان مرئياً له.
تعود أصول مصطلح “الأقليات المرئية” إلى الناشطة الحقوقية كاي ليفنجستون التي صكّت مصطلح “أقلية مرئية” في ثمانينيات القرن الماضي لوصف الفروقات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها الأقليات غير البيضاء. كان المغزى من توصيف الأقليات هو تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الأقليات في ذاك الوقت، لكن هذا التوصيف الذي ما زال معتمداً حتى اليوم من قبل هيئة الإحصاء الكندية بات شكلاً من أشكال ترسيخ هذه التحديات. فكلمة أقلية باتت تفتقر الدقة من الناحية الإحصائية في بعض المدن والبلدات الكندية، و هي تفتقر لملاحظة تقاطعية الهويات العرقية والإثنية والدينية والجندرية، التي لا يمكن لها أن تكون مرئية دون الاستناد إلى صور نمطية تقولب هويات الأفراد والجماعات.
بالنسبة لأمثالي من اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، نحن ما زلنا نحاول إعادة تعريف هويتنا واكتشاف أشكال انتماءاتنا في هذا المكان الجديد. لكن الواقع الذي قابَلنا هو أنه حتى قبل الوصول إلى هذه البقعة من العالم كانت لنا خانة مصممة بين خانات الأقليات المرئية وعلينا أن نطوّع هويتنا لتتناسب مع هذه الخانة. وحين نحاول اكتشاف انتماءاتنا وفهم معانيها، نجد أننا في مواجهة دائمة مع تاريخ من الصراعات والاستعمار والصور النمطية التي تؤطر انتماءاتنا وهويّاتنا.
الاعتداءات على أفراد قد تجمعهم هوية عرقية أو دينية معينة باتت تشكل انتماءً جديداً لهؤلاء الأفراد. أصبح الانتماء مبنياً على خوف من خطر مشترك. الاستهداف لجماعة بناء على تصنيف ديني أو عرقي يقلل من شأن التنوع الموجود ضمن تلك الجماعات، وحتى هذا الإيمان الذي قد يكون نسبياً ومتفاوتاً من شخص إلى آخر يصبح متساوياً أمام مواجهة خطر واحد. المرعب في هذه الحالة هو أن الخوف بات القاسم المشترك الأساسي في تشكيل هويات الأقليات.
اليوم أستذكر ذلك المساء. وصلتني رسائل من العمل والجامعة كان فحواها التأسف على كل مشاعر الذعر التي أشعر بها أنا وعائلتي. رسائل تشرح لي أن هذه الجريمة لا تعكس قيم المجتمع في لندن-أونتاريو. بدت الرسائل المليئة بالتعازي والاعتذارات غريبة ومخيفة قبل أن أطّلع على الأخبار لأعرف بمأساة قتل عائلة أفضال. أما بعدها، فلم أحتج أكثر من بضع دقائق لأستوعب كل تلك التعازي والاعتذارات. مقتل عائلة مثل عائلة أفضال يعني أنه علي أن أخاف على عائلتي. في ذاك المساء أدركت أن هذه الجريمة التي حدثت على بعد أقل من خمس كيلومترات من مكان إقامتي مع أمي المحجبة ستعيد فتح أبواب الخوف الذي ما زلت أحاول نسيانه. عاد إلي الشعور المألوف بالخوف، الخوف الذي قطعت أراضٍ ومحيطات للتخلص منه، والقلق من أن هناك من سيأتي ليؤذيني وعائلتي بلا أي سبب يمكن للمنطق أن يدركه.
ربما خوفي الذي قد يجتاز حد المنطق أحياناً هو خوفٌ مبرر لأن الكره والعنف اللذَين يهددان حياتنا ليس لهما أي تفسير منطقي. حجج المنطق تبدو هزيلة أمام مشاعرنا في بعض الأحيان. وربما كان خوفي مبرراً أمام واقع أن القتلة أنفسهم لا يعرفون المنطق. لكن سرعان ما يبدو خوفي الشخصي خوفاً جماعياً. وسرعان ما يتم التعامل مع هذا الخوف على أنه عنصر أساسي لتشكيل هوية جماعية لأشخاص يوصفون بأنهم “أقليات المرئية”.