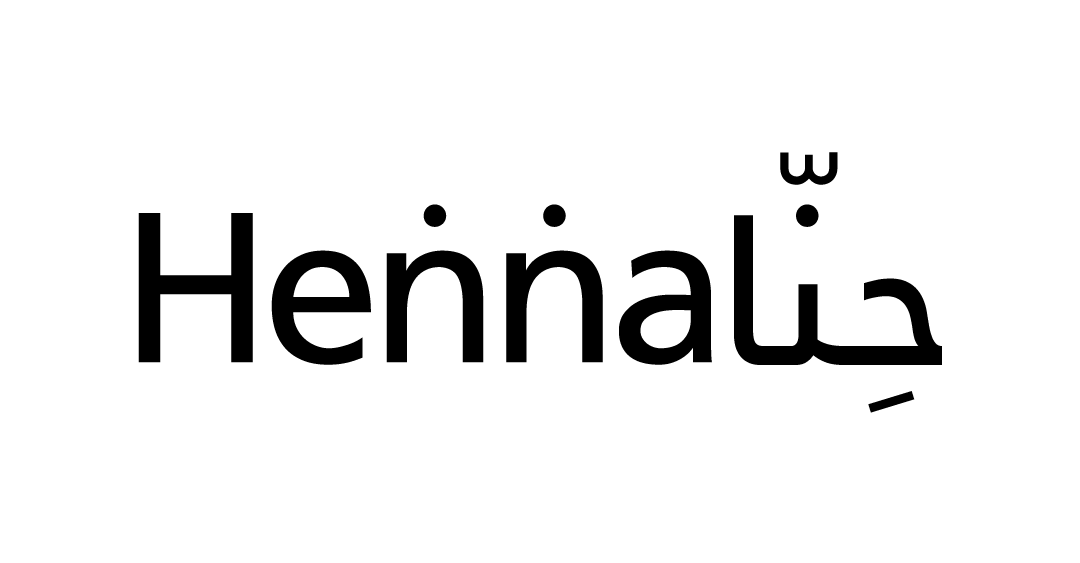خطوات حائرة في سوق العمل الكندي
حكمت الحبّال
صحفية ومصوّرة سورية مقيمة في كندا.
حين كنت أنتظر في اسطنبول -المدينة المحطة لكل الحالمين بالهجرة- معالجة طلبي للقدوم إلى كندا، علمت أن صديقتي المتخرجة من كلية الصيدلة تعمل محاسبة في محل بقالة متواضع في تورنتو. استغربت حينها، وبتسرعٍ ساذج اعتبرت أنها لم تسع لنيل فرصةٍ مناسبة. كنت على يقين بأن العمل الصحفي ينتظرني، إذ سبق لي أن عملت كصحفية لسنوات بين دمشق وبيروت واسطنبول، وكان مجيئي إلى كندا بدعم من منظمة «صحفيون كنديون لحرية التعبير» التي كانت واحدة من كفلائي.
بعد مرور شهر على استقراري في تورنتو تواصلت مع المنظمة، والتقيت مديرها التنفيذي في إحدى بارات يورك ديل الفخمة، الذي وصل المكان على دراجته الهوائية. كان شاباً أنيقاً في مقتبل العمر. تخيلتُه رجلاً هرماً لا لشيء إلا لكونه مديراً، وفقاً للصورة النمطية المستوحاة ممن قابلتهم وعملت معهم سابقاً من المدراء الذين كانوا على النقيض من عمر هذا الشاب ومرحه. أثناء حديثنا عن الحياة في كندا، كنت أقحم رغبتي في العمل معهم في كل جملة أقولها. إلا أن اللقاء انتهى بفرصة عمل تطوعية كمصورة فوتوغرافية، نظراً لضعف التمويل كما أشار. عرض علي بيع العصير الصحي مع زوجته التي تسوق إحدى ماركات هذا العصير. اخترت التطوع، وكانت تلك أولى خطواتي في سوق العمل الكندي.
خمس ساعات في المطبخ
قلت لها إنني أريد الاختلاط بالحياة اليومية لجمع القصص، وتوثيقها كتابة أو تصويراً؛ فبدأتْ ماري صاحبة المطعم بسرد قصة أمها التي سرق الأطباء بمساعدة الممرضة طفلها الوليد قبل 60 عاماً في إحدى مشافي تورنتو، مدعين موته دون منحها شهادة وفاة أو تسليمها جثته.
بدت الكثير من حكايات ماري ساحرة وخيالية بالنسبة لي، لكن المهم كان اكتشاف حبي للطهي. هناك تعلمت طريقة إعداد صلصة الطماطم الإيطالية مع الريحان والثوم، وصلصة الكريمة، وكيفية سلق الباستا دون أن تلتصق مع بعضها. نرميها في ماء مغلي جداً، ونتركها لمدة 8 دقائق ومن ثم نبردها بمياه مثلجة ونصفيها. وأخيراً نرش القليل من الملح وبعض من الزيت عليها.
في غمرة كل حديثٍ صغير، أردت التأكيد لصاحبة المطعم ماري أنني صحفية ومصورة ولدي ست سنوات من الخبرة في هذا المجال. أردت أن تفهم أن سبب قبولي بهذا العمل -الذي قُدّم لي عن طريق مؤسسة خدمات شبابية- هو رغبتي في فهم الحياة في كندا، والاختلاط مع التورنتيين، لا أكثر. فيما كانت تهم برفع وعاء المياه الساخنة لسلق الباستا، قالت لي: «لا تقلقي سوف تعتادين على الحرارة». رددت في قلبي: «لن أعتاد الحرارة الساخنة، لأنني لن أكمل أكثر من يوم واحد كمساعدة شيف في هذا المكان».
كنت أحاول أن أظهر لها مدى أهميتي وخبرات عملي السابق كي لا تعاملني معاملة المعلم للعامل، كما يحصل في بلادنا. رب العمل هناك يُعامل كالإله. لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك. كنتُ أتحدث لها عن نفسي وأنا أضع حصص الزبائن في أكياس شفافة، أو عندما أمسح يدي في المريول.
تذكّرتُ حديث صديقة لي عاشت تجربة مشابهة في براغ أثناء دراستها للسينما. قدّمت لي هذه الصديقة نصيحة ذهبية: «عليك بالدعك أحلى شي». كانت هذه الصديقة قد عملت كعاملة استقبال في فندق، وبائعة للساعات في المطار، ومربية أطفال. كانت تقول لي: «إياك أن تنظري لهذا النوع من الأعمال بمنظور شرقي. في الغرب الجميع يمر بهذه المرحلة قبل أن يصل إلى عمله الذي يحب. الحياة هناك أكثر نضجاً ومرونة بسبب التجربة». حين أخبرتُها في الليلة السابقة عن تجربتي دعتني لفتح ذراعي لكل محطة مؤقتة في حياتي لأنها ستعلمني الكثير وسأتذكرها بحب بعد أشهر قليلة.
في نهاية يومي الأول، أي بعد خمس ساعات من مجيئي، سألتني ماري صاحبة المطعم: «هل هذا العمل مناسب لك؟». لم أتردد للحظة وأجبت بثقة: «نعم لقد أحببت ذلك». لكن في طريق عودتي للمنزل شعرت بوخزٍ في قلبي بسبب عدم اقتناعي بهذا العمل. بدأت أفكاري تحارب بعضها لدرجة مخيفة، حتى تمنيت أن أرمي برأسي الثقيل خارج القطار، وما أن فتحت عيني صباحاً حتى اتصلت بماري لأقول لها: «آسفة، لا تنتظريني، إنه ليس العمل الأفضل بالنسبة لي».
مبيعات محارب ساموراي
إن كنتَ في كندا، فلابد أنك سمعت أو استخدمت تطبيق Indeed للبحث عن العمل. دأبت عبر هذا التطبيق على إرسال سيرتي الذاتية لآلاف الشركات والمناصب، ولشدة يأسي وتململي وإدراكي لا جدوى ما أقوم به، رحت أقدم طلبات توظيف على مناصب لا أفقه فيها شيئاً. مرة معلمة لتدريس القرآن والتجويد، ومرة مدرسة للغة اليابانية، وأخرى معلمة شاورما في مطعم عربي. معظم الردود التي جاءت كانت تبدو ردوداً من محتالين، كأن يتم توظيفك كمدير عمليات لوظيفة براتب مثير، دون طلب مقابلة شخصية حتى. ومن تجربتي غير المتواضعة فإن الرد يأتي على وظائف مندوبين المبيعات، الذين يقبضون عمولة في حال قبل الزبون بالشراء، مع ملاحظة أن ذلك لن يُكتب في إعلان التوظيف، بل سيشار إليه بجملة تقول إن أرباحك قد تصل إلى ألفين دولار أسبوعياً، وهذا ما حدث معي.
ذهبت إلى وودبردج، وهي مدينة تبعد عن تورنتو حوالي 25 كيلو متراً لإجراء مقابلة عمل. المدينة التي لم تجلب لي مثل ‘تورنتو الكبرى’ سوى الحزن، حيث المساحات الواسعة الموحشة، الخاوية من دفء الجدران القديمة والمهترئة. «لا شيء يجذبني»، كنت أردد في نفسي وأنا أشاهد الشوارع العملاقة، المتعجرفة، ذات المستقيمات المملة اللامتناهية والفارغة من العاطفة.
بعد سنة ونصف ما زلت أشعر بالوحشة عندما أبتعد عشرات الكيلومترات عن مركز المدينة، حيث يقع بيتي ومجتمعي الصغير الذي ألفته بعد محاولات امتدت شهوراً. كلما ابتعدت أشعر باغترابٍ أشد قسوة. روحي تتقلص مع كل كيلو متر أبتعد فيه عن بيتي. مخاوفي التي أهرب منها تتجسد أمامي كمحارب ساموراي يشحذ سيفه فوق رقبتي، يرتاب من كل شيء، لا سيما من الطقس بهوائه الجاف، ووجوه البشر التي تتغير مع ابتعادي عن مركز المدينة.
التقيت مديرة الشركة وكانت سيدة أردنية ذات ملامح بريئة. بدل مناقشة عرض العمل، غرقنا في حديثٍ عن سوريا وكندا والأردن، وحدثتني عن وصولها إلى كندا في ثمانينيات القرن الماضي. انفصلت السيدة عن زوجها بعد 3 أطفال و26 سنة من الزواج، ثم انتقلت إلى دبي وعملت لأكثر من عقد من الزمن، وتزوجت شاباً أصغر منها وصفته بال «حليوة» وعادت معه إلى كندا، وكأنها تنتقم من زمنها الأول الضائع. بعدما امتدحت السيدة جمالي، اعتذرَت عن عدم قدرتها منحي فرصة العمل، لأنني لن أنجح -حسب تقديرها- بإقناع الزبائن بشراء أجهزة الإنذار التي تبيعها شركتها لأنني «لا أمتلك موهبة ترويض عقل الزبون». تبادلنا الأرقام، وأعطتني كرتها، الذي رميته فور خروجي من مكتبها وكأني أرمي حجراً ثقيلاً عن ظهر سيزيف الأسطورة.
من المفروشات إلى الحشيش
في إحدى الليالي، كنا نتحدث أنا وصديقتي عن الغربة والتشرد. أخبرتني أن أعز أصدقائها يعيش في تورونتو، وأنها سترتب لقاء يجمعنا، عسى أن يكون مفيداَ في رحلة البحث عن عمل. هذا ما حدث. التقيتُه في فسحة جامعة تورنتو ظهيرة يومٍ حار من أيام حزيران. تبادلنا السجائر، وتجاذبنا أطراف الحديث لساعتين من الوقت، وما أن افترقنا حتى اتصل بي وأنا أنتظر القطار الذي سيأخذني إلى البيت ليخبرني عن فرصة عمل في متجر الأثاث الخاص بوالديه. كان العمل في مجال التسويق الالكتروني، وما كدت أصل إلى البيت حتى وجدت عقد العمل في إيميلي.
بدأتُ العمل كمسؤولة عن وسائل التواصل الاجتماعي وموقع التسوق الإلكتروني، إضافة لتصوير إعلانات والترويج لها. الصمت في متجر المفروشات، الذي لا يقطعه سوى صوت عقارب الساعة القديمة، أعادني طفلة صغيرة، عندما كنت أحاول النوم في بيت جدتي في دمشق، مع فارق 20 سنة فقط. كان روستي كلب أصحاب المتجر يغفو بجانب مكتبي، وصوت أنفاسه الدافئة يكمل مشهدي الحزين.
كانت إيفون المديرة وأم صديق صديقتي أشبه بصديقة كبيرة دأبت على الاهتمام بي، وإحضار البقدونس وزهر اللافندر من حديقة منزلها مع مخبوزات أعدّتها لي قبل ليلة. لم تتوان عن إعطائي وصفات مثل مخلل الليمون بالأعشاب من كتيب طبخها السري، الذي كان حصيلة سنوات من التجربة.
واحدة من تجاربي المثيرة معها كانت تصوير إعلان حول خطوات صناعة سرير من خشب الجوز المتين، منذ التصميم على الورق، وحتى التنفيذ. رافقتُ فرانك زوج إيفون (73 عاماً)، والمنحدر من جنوب إفريقيا، إلى المعمل في منطقة الميرا في أونتاريو، والتي تبعد حوالي 113 كم عن تورنتو. كان العمال من طائفة الأميش. لا كهرباء ولا سيارات ولا هواتف حديثة. بيئة عضوية خلابة، بعيدة عن الضوضاء والتلوث. سلام رصينٌ طاغٍ على كل شيء يتسلل إلى مساماتك برضى وسكينة.
كنتُ سعيدة للغاية. صورت أيادي العمال وهي تنحت وتزخرف منحنيات الأثاث بدقة وبراعة، وقبل عودتي اشتريت البيض وسلال توت وفراولة عضوية، دون أن أعرف وجه البائع، إذ وجدت لافتة في المتجر المتواضع كتب عليها خذ ما شئت وضع المال في الصندوق. كان ذلك اليوم يومي الأجمل في كندا منذ وصولي. ورغم الأجر الزهيد الذي كنت أتقاضاه، إلا أن الدفء المسيطر على المكان، وعملي في مجال أحبه كان سبباً لشعوري بالرضا. قالت لي إيفون: «تزوجي رجلاً ثرياً. تطوعي في إحدى المشافي لتصطادي طبيباً. يجني الطبيب المبتدئ حوالي 45 دولاراً في الساعة، وإلا ستكونين امتداداً لي، ويضيع عمرك وأنت تحاولين إقناع الزبائن بالشراء».
كان العمل في مشروع تجاري عائلي مع أسرة لطيفة، لا يخلو من المناكفات اليومية. عملت معهم بامتنان إلى لحظة انتشار فايروس كورونا، واضطرارهم إلى الإغلاق. ودّعوني بقبلات حميمة ودموعٍ صادقة، مع بطاقة تهنئة ذيلوها بأسمائهم، دون نسيان توقيع روستي وليو كلبيهما المدللين، وظرف تركوا فيه بضع دولارات كتعويض ريثما أجد عملاً آخر. كان ذلك آخر يوم لي في متجر المفروشات الواقع في شارع كوين العريق وسط تورنتو.
المتجر تحول بعد بضعة أشهر إلى متجر لبيع الحشيش ومستلزماته، بعد أن باعته العائلة بسبب الوباء المنتشر في عالمٍ يتغير فيه سوق العمل واختيارات البشر.