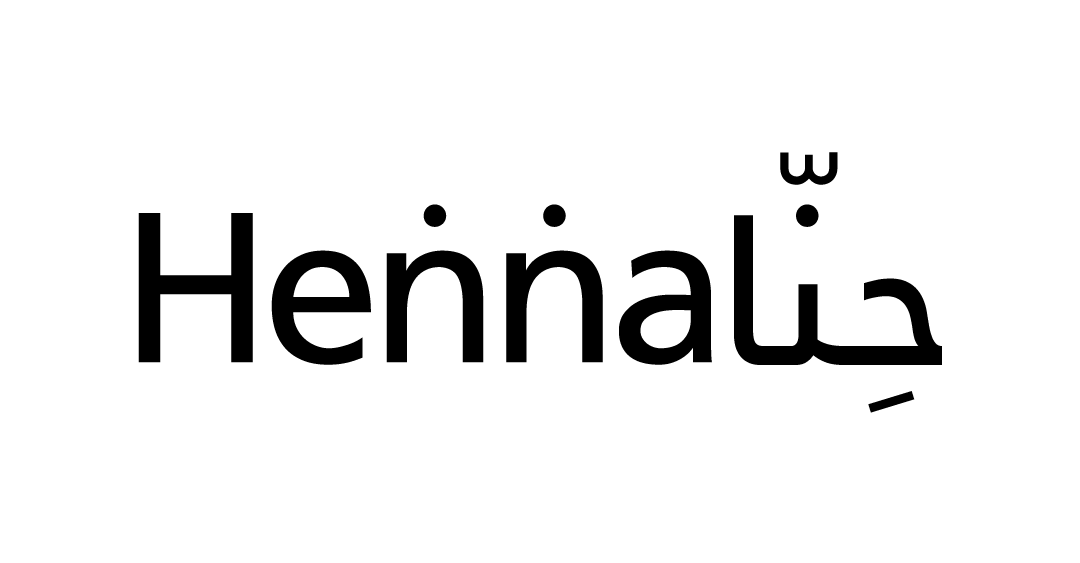بورتريه للبعبع
محاولة لفهم ملامح الوصمة في الصحة النفسية
كنانة عيسى
كاتبة وفنانة وباحثة مجتمعية سورية لاجئة في كندا، عملت مع المجتمعات السورية والملونة في مجال التنمية والفن، بالإضافة لعملها في البحث المجتمعي في سوريا ولبنان وكندا. تركز حالياً على البحث في مجال الصحة النفسية/العصبية. زميلة فخرية في برنامج الكتابة الدولي بجامعة أيوا.
تحدث الصديق حسين الشهابي في مقاله كيف سنتخلص من البعبع؟ عن الوصمة الاجتماعية المتعلقة بالصحة النفسية في المجتمعات الناطقة بالعربية. طرح مسألة لغوية هامة، وهي أننا نستعير مصطلح الصحة النفسية الذي كان يتخمر في الثقافة الغربية لأعوام حتى تطور ليتم استخدامه بالشكل الذي نراه اليوم. بالتالي عندما نتحدث عن الصحة النفسية باللغة العربية فنحن نتحدث عن أمر من خارج المنظومة الثقافية لمتحدثيها وفور سماعنا للمصطلح نفترض وجود ثنائية الصحة والمرض.
أتفق مع حسين بأن هناك ضرورة لقيام ثورات لغوية ضمن السياق الثقافي للمتحدثين بالعربية لنتمكن من التعامل مع بعض المصطلحات. وأريد الإضافة إلى ما تطرق إليه حسين عن تطور الطب النفسي بعد الحرب العالمية الثانية بالقول إن ثقافة المنطقة قبل الحربين العالميتين لم تخلُ من مقاربات للتعامل مع الصحة النفسية بشكل طبي، لكن كان هناك بعض العوائق التي وقفت أمام تطوير تلك المقاربات مما أوقف التطور اللغوي المرتبط بها أيضاً.
ربما أزيد على ذلك أن “الثورة اللغوية” ستحتاج إلى إعادة تعريف مصطلحات الصحة النفسية ضمن سياق علمي مُعاصِر ليرتبط المصطلح اللغوي بمفهوم كامل عوضاً عن بقائه مجرد مُصطلح بلا دلالة راسخة. سيُفيد هنا إعادة البحث في التراث العلمي للمنطقة العربية كي نتمكن من إعادة إحيائه بمنطق الزمن الحالي. يقول ابن سينا، أبو الطب الحديث، في كتابه النجاة في المنطق والإلهيات: “الكلمة لفظ مفردة تدل على المعنى وعلى الزمان الذي كان ذلك المعنى موجوداً فيه”.
المسّ والتنوير والاستعمار والتردّي
مع محاولاتي الأولى لفهم العوائق الثقافية أمام العمل على الدفع بعجلة الثورة اللغوية إلى الأمام، أرغب البدء بسرد صغير للسياق التاريخي الاجتماعي لما يُسمى بالوصمة الاجتماعية حسب فهمي له (هو أمر مُتغير بتغير القوى السياسية والدينية والاجتماعية المسيطرة على كل ثقافة) ثم التوقف قليلاً عند السياق الحالي المُعاصر له.
تاريخياً، في الشرق والغرب على حد سواء، كانت هناك مبادرات للتعامل مع الاضطرابات النفسية بطريقة علمية، لكن كثيراً من رجال الدين النافذين نبذوا العلم ووصموه بأنه شكل من أشكال الكفر. حصل رجال الدين بذلك على سلطة شبه حصرية للتعامل مع هذه الأمور، فكان المُصاب بالاضطراب الذهني يُعامل على أنه ممسوس بأرواح شريرة وكان لزاماً عليه الذهاب إلى الشيخ المسلم أو إلى رجل الدين المسيحي ليقوم بطرد هذه الأرواح من داخله. لم يكن حال الدين كذلك على الدوام، وأحد أمثلة ذلك ازدهار العلم في العصر العباسي تحت سلطة خلافة دينية، على عكس ما جرى في عصر الدولة العثمانية.
أنجبت ثقافات العالم، ومنها ثقافاتنا، علماء درسوا موضوع الصحة النفسية وحاولوا إيجاد مقاربات طبية لها: إسحاق بن عمران والفارابي وابن سينا والرازي بحثوا في المواضيع النفسية والعقلية والعاطفية والعصبية وحاولوا علاج اضطراباتها بالموسيقى وتغيير نوعية الطعام واستخدام العطور الطبيعية واللجوء إلى السفر والاستجمام. بالإضافة إلى ذلك، أبدى هؤلاء العلماء وغيرهم اهتماماً خاصاً بفهم المشاعر الإنسانية وتأثيرها على عملية الشفاء الفيزيولوجية. من الناحية الدينية وقبل تأسيس مدرسة التحليل النفسي وتطور التقنيات العلمية لفهم آلية عمل الأعصاب، كانت النَّفْس في اللغة العربية من اختصاص الجانب الروحاني في الثقافات الإبراهيمية: النفس والروح تعتلّان، وتحزنان، وتضطربان. تتعامل المدارس الدينية التنويرية مع هذه المسائل عبر محاولة فهم النفس وإيجاد حلول لاضطراباتها بالعلاج الطبيعي والفن والروحانيات، على عكس المدارس التجهيلية التي تعاملت مع الأمرعلى أنه مسٌّ يصم صاحب الاضطراب بالشر أو الكفر.
من الصعب فهم السياق التاريخي للوصمة النفسية وعلاقتها باللغة والثقافة في المنطقة الناطقة بالعربية دون فهم السياق الاستعماري الذي بدأ مع هيمنة الدولة العثمانية ومن ثم سياسات التجهيل التي اتبعتها ديكتاتوريات ما بعد الاستقلال، بالإضافة للقوى الدينية المتشددة التي تمكنت من الحصول على السلطة السياسية. أدى كل هذا إلى خلق ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة تشغل المواطن بالبحث عن لقمة العيش، لا بما يزيد من تطوره ورخائه. فسحت هذه الظروف المجال لقوى منغلقة بفرض فهمها الضيق للعالم على الدين والسياسة والاقتصاد والإعلام والمجتمع، عدا عن الظروف المتردية التي مرت بها المنطقة عموماً، والتي جعلت أبناءها في حالة صراع على البقاء، ما يفرض على كثيرين الادعاء بالقوة طوال الوقت، حتى عند الضعف، ليتمكنوا من الحفاظ على شخصيتهم وحضورهم ولقمة عيشهم. أصبح رفض الاعتراف بالضعف في هذه الحالة هو عنوان الكبرياء.
أرى أنه من الحري بهذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة دفعنا للاعتراف بالاضطرابات النفسية/العصبية والتعامل معها بجدية كموضوع وطني وثقافي وصحي. وبإمكاننا القول إنه بعد العواصف الأخيرة في المنطقة ليس هنالك من هو غير مصاب باضطراب ما. وأعتقد أنه من شبه المستحيل تقريباً حل أي من المشاكل الاقتصادية والسياسية دون فهم الاضطرابات النفسية والذهنية والاعتراف بها ووضعها بعين الاعتبار في أي مقاربة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. شعوب شهدت هذه المذابح ومرت بهذه الدوامات من العنف تحتاج لفهم الآثار السلبية التي أخذت من إنسانيتها وقدرتها على التطور كي تتمكن من ترميم نفسها. تعاني مجتمعاتنا اليوم من آثار كل هذا العنف وردات الفعل عليه من عنف مُضاعف، كالراديكالية الدينية والاجتماعية، والعنف الأسري، وما يُسمى بـ”جرائم الشرف”، والاكتئاب، ونزعات تدمير الذات، والانتحار، وصعوبات التعلم والتأقلم، وحالات العزلة المجتمعية وغيرها. الوصمة الاجتماعية، برأيي، قد تكون نوعاً من ردود الفعل على الصدمة، وشكل من أشكال الإنكار.
الإنكار وعتبات الفقد الخمس
تتسبب الصدمات النفسية بزيادة الضغط على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى إرباكه. كثيراً ما يتسبب ذلك بحدوث حالة إنكار مؤقتة أو مُزمنة كي لا يضطر الإنسان للتوقف ومجابهة شعوره بالخسارة، فيُحاول الاستمرار كأن شيئاً لم يكن. ثمة كثير من المقاربات العلمية لفهم الصدمة، لكنني أرغب ضمن هذا السياق بالذات الاستعانة بالنموذج التبسيطي الذي وضعته الأخصائية النفسية إيليزابيث كوبلر روس في بحثها عن الفقد، والذي يشيع استخدامه بالثقافة الشعبية الغربية بين غير المختصين لمحاولة فهم تأثير الصدمة.
تشير روس في هذا البحث إلى خمس عتبات لا واعية تتشكل بعد حدوث الفقد، دون اتباع النفس البشرية لهذا الترتيب بالضرورة: الإنكار، والغضب، والمساومة، والاكتئاب، والقبول. القبول هو دائماً المرحلة الأخيرة، وبوابة إيجاد الحل. ربما هنا عليّ أن أضيف أنه بسبب الجروح المفتوحة لأبناء المنطقة، فالقبول ضمن هذا السياق لا يعني الاستسلام للواقع الظلامي الحالي، بل هو في قبول حقيقة مُخرجات الواقع على المستوى الشخصي على الأقل لنتمكن من تغييره.
تقول دينيشا جينغلز، وهي باحثة أمريكية سوداء، في بحث لها عن الحرية الجمعية أن “القبول هو أمرٌ فاعل، لا سلبي. هو لا يعني الاستسلام، بل يعني الانخراط. عبر القبول، يتمكن الناس من تقوية أنفسهم لاستحضار سلوكيات قادرة على عكس مفعول القمع عند حدوثه”. أرى الوصمة المجتمعية شكلاً من أشكال إنكار المشكلة. يَصِمُ المجتمع من يُشير إلى الاضطراب أو يعترف به بأنه هو المشكلة، مما يُعطي مُبرراً لعزل المُعْترِفين وتعنيفهم ليتمكن الباقون من الاستمرار بالإنكار بسلام. لكن الحقيقة أن الإنكار لا يعني اختفاء المشكلة، وأرى بأن ديكتاتورياتنا المجتمعية والسياسية والعائلية تُكررالنموذج ذاته. منذ وقت ليس ببعيد كنا نرفض الاعتراف بمرض السرطان ونسميه “هداك المرض”. ربما تجاوزنا ذلك اليوم، وبذلك تمكنا من اكتشاف السرطان في مراحله الأولى والشفاء منه ببعض الأحيان. لكننا لم نصل بعد لتقبل الأمراض الخفية التي لا دليل مادياً على وجودها، ونصم حامليها بالسلبية أو الكسل أو الضعف عوضاً عن العمل على فهم وعلاج الاضطراب. عند الاعتراف بهذه الاضطرابات نتمكن من التعامل الإيجابي التفاعلي معها عوضاً عن إطلاق النظريات والأحكام غير المُستندة إلى أساسات علمية.
الوصمة حسب ما أراها هي رفض للمعرفة. هي إطلاق حكم على أمرٍ نخاف منه كي لا نضطر لفهمه أو التعامل معه. وسيلة تساعدنا على الاستمرار بأساليبنا القديمة ذاتها بالتعامل مع المصاعب التي تمر معنا أو مع من نحب حتى ولو بات من الواضح عدم فعالية ما نقوم به، أو أنه صار من الممكن تخفيف هذه المصاعب والتعامل معها بطرق أفضل.
الصحة النفسية ليست اختراعاً غربياً، بل هي نتيجة تمازج وتفاعل الحضارات مع بعضها. إذا استثمرنا وقتاً وجهداً كافياً بالبحث في التراث، سنجد كثيراً من المصادر التي تتحدث عنها. وإذا بحثنا على الانترنت، سنجد مراجع لا تحصى مُستقاة من العلوم الغربية. وإذا رغبنا بالعمل بجدّ أكبر، سنجد طريقة ما لإحياء تراثنا العلمي واستكمال الطريق الذي شقه أطباؤنا وأهلنا المتنورون الأوائل عبر التفاعل والنقد إعادة تفحص التراث الأصيل المنسي بعيون الاكتشافات العلمية المُعاصرة.
لكن هذا كله يحتاج جهداً وقراءة وبحثاً ونقاشاً. وفي كثير من الأوقات، تجربةً. أعلم أن هذا قد يبدو لكثيرين أمراً اختصاصياً تُشرف عليه مؤسسات، حيث نحتاج لتمويل باحثين ودارسين وأكاديميين للقيام بهذا العمل. لكن واقع الحال يقول إن هذا، وإن كان ممكناً، فلن يحصل دون ضغط المبادرات الفردية. هذا عدا أن اليوم في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بات من السهل تحول الحراك الفردي إلى حركة جماعية. المهم في كل هذه المعادلة وجود التقاطع والتبادل والتكامل لأن هذا ليس مجهود فردٍ واحد.
لن يقوم أي أحدٍ بهذا العمل عنّا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا ومجتمعاتنا اليوم. أرى بأن المبادرة الذاتية بالتعامل مع مواضيع الصحة النفسية هي ما سيُساعدنا على التخفيف من أثر الوصمة الاجتماعية ويخرجنا من ثوب المُنْفَعِل لنّصير نحن الفاعلون، مما سيعطينا أفضلية بالتعامل مع الاضطرابات النفسية وتداعياتها الفردية والجمعية على حد سواء.