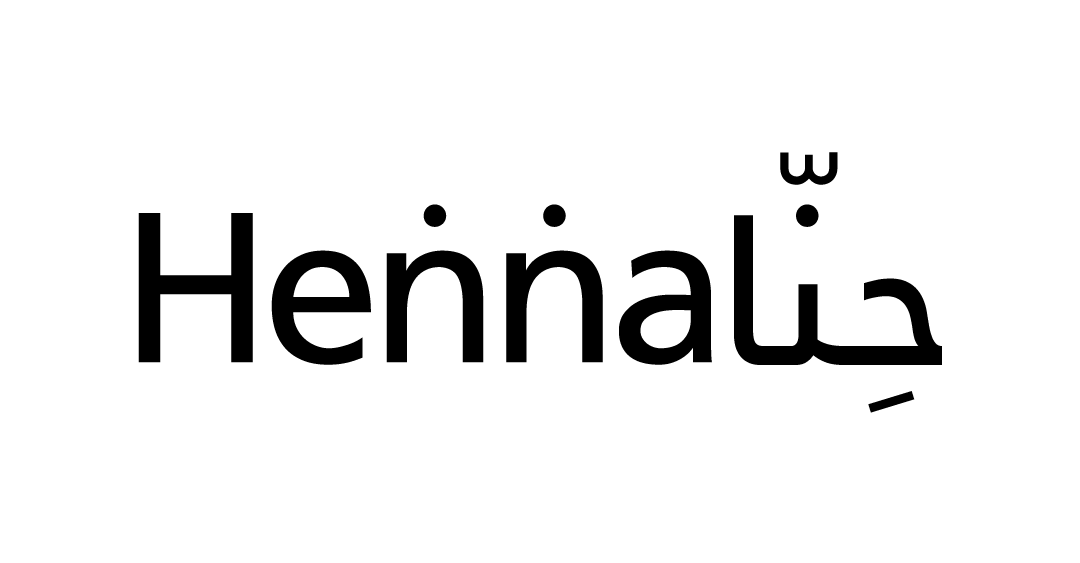الهروب إلى مونتريال
عبد الوهاب الكيالي
باحث وموسيقي فلسطيني-أردني مقيم في مونتريال.
أمضيت قرابة 13 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، أي ثلث عمري، وأكثر من نصفه كبالغ شبه عاقل. تحصيلي العلمي في كل المراحل الجامعية كان حصرياً من جامعات في الولايات المتحدة. تنقلتُ بين مدن ومناطق عدة فيها: بوسطن، شيكاغو، واشنطن دي سي، آن آربر (ميشيغان)، وأخيراً فينكس (أريزونا). أواجه السؤال مراراً: لماذا خرجت إذن؟ أستشهد هنا بمقولة المخرج الصيني المعارض آي وي وي عند خروجه من برلين. “هؤلاء الذين يعرفون وجهتهم لا يبقون لاجئين. أنا لاجئ”.
أنا لاجئ. أبي وأمي لاجئان. وكذلك جدي وجدتي، من كلا الطرفين. لجأنا من ساحل فلسطين الأوسط خلال النكبة. سكنّا عمان، وبيروت، ومدن أخرى. ليس المهم أين تسكن، الأهم ما يسكنك. تابعت دراساتي في الولايات المتحدة بغية مسار مهني معين. ولكن هل يقوى اللاجئ على التخطيط لأي مسار؟ بدأت خططي بالتحطم في أواسط الألفينات، وما زالت تتحطم، كما هو حال بلادي وأرضي ومجتمعي. تعرفت على شريكتي في الولايات المتحدة، وهي بدورها رحالة. اكتسبتُ الكثير من الولايات المتحدة: الشهادات، والعلاقات، والتجارب والأصدقاء. ولكن لحظتين مفصليتين أسستا لقطيعتي معها: الأولى: هي خطاب إعلان الحرب الذي لن تأتي، في أيلول 2013. والثانية هي انتخابات 2016.
أنا لاجئ واسمي عبد الوهاب، لا هروب من ذلك. اختارت أميركا ألا توقف أكبر حمام دم شهدته منطقتنا المتعوسة في الـ 2013 بعد مجزرة الكيماوي في سوريا – الفصل الأفدح في حرب بشار الأسد المستمرة على الشعب السوري. واختارت أيضاً أن تنتخب رئيساً يكن الحقد والكراهية لي ولمن يشبهني في 2016. لم أمتلك امتياز خوض المعركة الداخلية الأمريكية، ولم أسع لذلك. عملتْ شريكتي في 2017 في ظل نظام الكفالة الأمريكي، والتحقتُ بها في 2018. كان أصدقائي الليبراليون يمازحوننا بالقول: “إذا فار ترامب بولاية ثانية، سننتقل إلى كندا!”. لم أملك ترف الانتظار والاختيار. شرعنا، شريكتي وأنا، بمعاملة هجرة إلى كندا فور إنهاء الدكتوراة في 2018. كانت الآفاق في الولايات المتحدة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولكن ترامب كان قد نفذ كل وعوده الانتخابية الكريهة التي بدت مستحيلة للذائقة الأمريكية الليبرالية. أما آفاق منطقتنا، شريكتي وأنا، فهي في انغلاق مستمر منذ عام 2013 المشؤوم. كان الخروج من الولايات المتحدة في ظل استفحال وباء كورونا أصعب مما يجب، ولكننا أبناء بلاد فيها حروب وانقلابات عسكرية وموجات لجوء مهولة، فرأينا ذلك هيّناً.
لا غربة في مونتريال
استقرينا في مونتريال أواسط 2020، بعد الهبوط المؤقت في تورونتو. سبق لي أن زرت مونتريال عدة مرات أثناء مرحلة دراستي الجامعية. أذكرها مدينة ديناميكية فيها ذائقة عالمية وحضور عربي قوي. حين كنا نجتمع هنا، لم نستطع، أصدقائي وأنا، الشتيمة بصوت عالٍ بالعربية (بخلاف مدن أمريكا الشمالية الأخرى) لأن نصف الشارع سيفهمنا.
الحضور العربي اليوم أقوى من أوائل الألفينات، بحكم موجات اللجوء وفشل الدول العربية الواحدة تلو الأخرى. العربية مسموعة بشكل واسع في مونتريال، بلهجاتها المشرقية والمغربية. السبب الرئيسي في اختياري لمونتريال كان الرغبة في الاقتراب الملموس والثقافي من العالم، بعد العزلة التي شعرناها في أقاصي الغرب الجنوبي الأمريكي. شريكتي تتقن اللغة الفرنسية، وأنا أفهمها، فلم تشكل هذه المسألة محط تفكير كبير.
الأهم من ذلك، أن مونتريال فيها مشهد موسيقي دولي غني، سمعتٌ عنه من أصدقاء وتابعته بحكم الاهتمام الكبير. كان هذا العامل الأهم بالنسبة لي، حيث مارستُ الموسيقى هوايةً واحترافاً وعشقاً أبدياً طول حياتي. لم أتصور أن أحظى بالفرص الموسيقية المتتالية التي حظيت بها منذ قدومي، سيما وأن المدينة كانت شبه مغلقة بسبب الوباء. كونت علاقات وصداقات موسيقية جميلة، ويدفعني هذا يوماً بعد يوم إلى التركيز على الموسيقى ونبذ كل شيء آخر: فما نفع العلوم السياسية في عالم إبادي يخلو من السياسة؟ ثم أليست الموسيقى طريقة أفضل لإيصال الرسالة، بأننا، كما يقول محمود درويش، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاً؟
الطعام قاتلاً للغربة
أهم مكون يشكل المناعة القوية ضد الغربة هو الطعام. الطعام أساسي في التذكير بالبيت والمناخ والبيئة التي ينشأ فيها العربي ويحن إليها ويأخذها معه أينما ذهب. الطعام هو أحد أهم أركان الهوية والثقافة (إن لم يكن أهمها). لذلك تُحمّلنا أمهاتُنا ما يمكن حمله في كل سفرة من طيبات الدار: معجنات، وبهارات، وقهوة، وأعشاب.. إلخ. ولذلك يرسل الأصدقاء وعاءات المكدوس الجيد حين يعثرون عليه، عبر البلاد والحدود. ولذلك أيضاً يمضي المشارقة والمغاربة ساعات وهم يتناقشون وصفات الطعام ومكونات الوجبات وأفضل الأسواق للعثور عليها.
مونتريال منجم ذهب للطعام العربي: فيها أفران للمناقيش الصباحية، ومشاوي “شرقية” من حدود إيران إلى المغرب، ومطاعم تشتهر بالمازة الشرقية والعرق المصاحب، وما لذ وطاب من مأكولات المشرق والمغرب. تجمع مونتريال، وبحكم انتشار اللغة الفرنسية، ما بين المشرق العربي والمغرب العربي بصورة فريدة، وربما أكثر من معظم مدن العالم باستثناء باريس وبروكسل، ومؤخراً برلين وأمستردام. فبإمكان الهاوي أن يجمع ما بين الكبة النية اللبنانية والهريسة التونسية والخليع المغربي متى ما شاء.
ولكن المكون الأهم للفلسطيني، هو الزعتر. في مونتريال زعتر فلسطيني. ليس خلطة فلسطينية تصنيع لبنان أو تركيا، لا، فلسطيني فلسطيني، من عنبتا. يحتاج هذا الزعتر بعض العناء للوصول إليه، ولكنه موجود. “يوجد لبناني وسوري”: يقول لي البائع في أحد أكبر المتاجر العربية حينما أسأله إن وجد الفلسطيني أو الأردني. يُلحقها بـ”كلهم مثل بعض”. وهنا أحتار: هل أوبخه؟ أشرح له الفرق؟ أتعاطف مع نزعته التوحيدية (في الزعتر، على الأقل)؟. أقول له: “لا يا سيدي. ليسوا مثل بعض، ولا أريد زعتراً لبنانياً”. وأمضي متمتماً، “ليدين من حجرٍ وزعتر.. هذا النشيد“.
غربة البلاد عن أهلها
الغربة هي في البلاد التي أُحرقت فوق رؤوسنا. في الحطام الذي يعصف بنا. في الاستعصاء على المضي قدماً والرجوع إلى الوراء. الغربة في سؤال “من أين أنت؟” في بلاد يسكنها أهلك لأكثر من سبعين عاماً، وفي عدم القدرة على الإجابة السهلة. الغربة هي في عدم تقبل الإجابة وإن وجدت. في الامتعاض أو الاستياء من رؤية خريطة فلسطين على صدري وصدر غيري، وفي التجارة الرخيصة بقضيتنا في آن. الغربة في الحديث عن الثورة السورية والإبادة السورية اللاحقة بتحفظ وحيطة، وفي التردد بشتم الآلهة الأصنام، والحذر من إهانة باقي “الرموز” و”الثوابت”. الغربة في المفاضلة بين سجنٍ وآخر. بين محتلٍ وآخر. بين الجنرالات والمشايخ. وفي حروب الطوائف وملوكها الجدد. الغربة في ضياع العدالة، والنسبية المطلقة، وفي العشائرية بكل أشكالها، وضبابية الخطوط الحمر. الغربة في اللعثمة عند قول الحق، والصخب والضجيج في مجتمع أسير، وصوت المعركة الذي لا يعلو عليه صوت.
لا غربة في مونتريال. ولكن هل هي وجهتي؟ لا أدري، فأنا لاجئ.